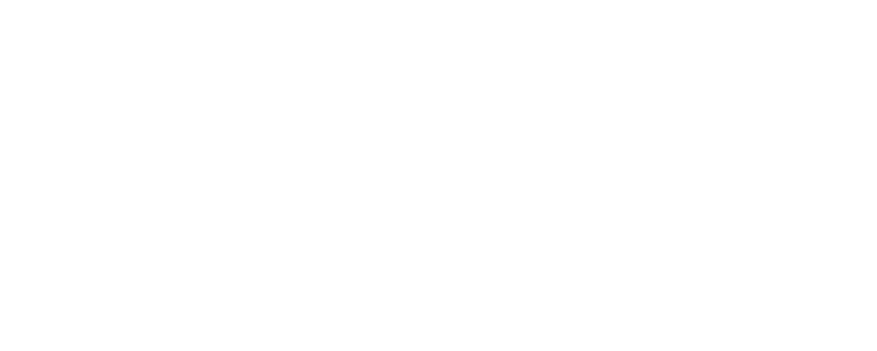تأملات شون ويليامز في العلاقة بين المشي والكتابة
: على خُطى جان جاك روسو من بحيرة بيل الوادعة إلى القمم الوعرة
على خُطى جان جاك روسو من بحيرة بيل الوادعة إلى القمم الوعرة: تأملات شون ويليامز في العلاقة بين المشي والكتابة.

في نهايات صيف وبدايات خريف عام 1765، كان روسو يفر هاربًا كما هي عادته حينما تجتاحه رغبة عارمة للهرب من اضطهادات الحياة، الاضطهاد الحقيقي والقانوني في أوقات، والاضطهاد الشخصي في أوقاتٍ أخرى. وبالرغم من إدراك روسو بأنهُ وجودٌ مُثقَل، إلا أن آخر أعماله يجسِّد حياةً مليئة بالكثير من التنزُّه التأملي، وليس الهروب والفرار. يضم كتابه “هواجس المتنزّه المنفرد بنفسه” حوالي تسع مجموعات من التأملات مكتوبة على شكل نُزهات وُجِدت بين الآثار الشخصية التي تركها الكاتب بعد وفاته في عام 1778م. تتمحور المقالة الأساسية حول ملاذه الخاص لحوالي شهر ونصف على ضفاف بحيرة بيل بجزيرة سانت بيتر في عام 1765 بمدينة بيرن السويسرية، حيث كان المشي نشاطه الأساسي آنذاك. قضى روسو وقته متنزِّهًا على ضفاف البحيرة، متعثرًا بجداول مياه النهر الصغيرة هنا وهناك، متجوِّلًا في أرجاء الجزيرة الجميلة، ما لم يكن يجدِّف بقاربه الصغير في مياه البحيرة. وكما جاء في سيرته الذاتية “الاعترافات” التي نشرها أصدقاؤه في عام 1782م، يقول روسو بأنه اكتشف ملاذه هذا حينما كان يحجُّ مشيًا على الأقدام في السنة السابقة. أصبحت جزيرة سانت بيتر مكانًا سعيدًا لروسو، ويقول روسو بأن السعادة ما هي إلا حالة من السكون والرضى التي تتولَّد عن وعي دائم بوجودنا المؤقت على هذه البسيطة.
يتوقَّف روسو أثناء تجواله ليتأمل النباتات، وكان ينزعج عندما يرى صيدليًّا أو مساعدَ حلاقٍ جراحٍ يبحث عن أعشاب لعلاج الحساسية والتورمات. في نظرِ روسو، فإن علم النبات بحد ذاته مدعاة للتأمل والتدبُّر وفهم العالم المحيط برموزه العاطفية والفكرية والجمالية. كان روسو يرى بأن علم الصيدلة لا يجب أن يطمس الأدب الرعوي المنبثق من إلهام الطبيعة، فمنذ فجر التاريخ والكُتَّاب يحومون حول الطبيعة مُستلهمين فلسفاتهم منها، وفي بدايات القرن الثامن عشر بدأ الناس بعادة التجوال بين الحدائق والبساتين لتمضية الوقت. المدرسة الرومانسية وحدها من تجاوزت الحدائق والبساتين لتطال الحقول والقمم والجُزر. بدءًا من روسو إلى شوبرت عازف البيانو المنفرد المعروف بمعزوفة “خيال المتجوِّل”- منحت المدرسة الرومانسية للتجوال والمشي بُعدًا آخر مرتبطا بالكتابة والنشاط الفكري والفني، وأصبح هذا الفعل يرمز للتفكُّر في الطبيعة وحياة النبات ما يفتح آفاق التدبُّر في الثقافة البشرية بنفس الطريقة. إن كلمة “الثقافة” بحد ذاتها ترمز للنمو، فهي ترتبط ارتباطًا ذهنيًا بالعقل- موضع التطوُّر الفكري والفني للمُجتمعات. وهكذا، فإن فعل المشي وتأمُّل الطبيعة المُحيطة هو فعل من أفعال بناء الثقافة.

بعد مُضيِّ مئتين وخمسين عامًا منذ ذلك الوقت، وتحديدًا في عام 2015، انتابتني مشاعر روسو وهو يتمشَّى على ضفاف بحيرة بيل. بالطبع لم أكن أول من يمشي على أثره، إذ لطالما سار الكُتَّاب الصاعدون على خُطاه مثل دبليو جي سيبالد كما كتب في عام 1998. حينما كنتُ محاضرًا أكاديميًا في جامعة بيرن، كنتُ أتمشَّى برفقة عدد من الزملاء المُقربين في عطلة نهاية الأسبوع على ضفاف البحيرة، وذلك قبل أن نقرر الذهاب في مغامرات المشي الجبلي، في سعيٍ من كل واحدٍ منَّا أن يجد نفسه في تجربةٍ كتلك (وكان اكتشاف مهرجان تذوُّق البيرة في أعلى التل أحد محاسن تلك المغامرات). وبنظري، كانت فكرة روسو عن السعادة في هيلفيتيا بمثابة ترحيب هادئ بعد دراسة دكتورية هائجة في المنزل، ولكنها كانت أيضًا في جوهرها كليشيهًا سويسريًّا مُستفِزًا، وهي فكرة جميلة دون شك ولو أنها في كثير من الأحيان تتعمَّد تغافل المشهد الثقافي. لقد كنتُ مرتاحًا وراضيًا وسعيدًا في بيرن، ولكن في الوقت نفسه كان الرضى المجتمعي لهذا الهدوء والرتابة في سويسرا الحديثة أمرٌ مخيف، حاله من حال نظرة روسو الغريبة للسلام الذي كان ينعم به في الجزيرة. إن نشاط المشي رائع وليس لدي اعتراضٌ على ذلك- بالرغم من أنني أفضِّل المسير الجبلي- ولكنه بدا لي كما لو أنَّ هذا النشاط قد أثَّر على طريقة رؤية السويسريين للعالم. وهكذا عدتُ للتجوال مُجددًا، ويا لسخرية القدر- لم أكن أعلم بأنني سأقتفي خُطى روسو الذي فررتُ هربًا منه.
في يناير من عام 1776، استقر روسو لفترة من الزمن في الجنوب بمدينة ستافوردشاير التي تقع في نطاق حديقة بيك الوطنية. بعد حوالي نصف قرن من ذلك، جئت إلى شيفيلد لأشغل وظيفة في الجامعة هنا. وكالمعتاد، كانت عطلات نهاية الأسبوع للتنزُّه والتجوال. كوني مُحاضرًا في أدب القرن الثامن عشر وخصوصًا في الأراضي الألمانية، كنت دائمًا ما أتساءل من من البشر قد عَبَر طرقات جنوب يوركشاير وديربيشاير وستافوردشاير قبلي. يبدو جليًّا بأن الألمان كان لهم نصيبٌ كبير من التنزُّه هنا، ففي عام 1782 قضى الكاتب الألماني كارل فيليب موريتس حوالي شهرا ونصف الشهر مسافرًا على قدميه عبر إنجلترا، ما جعله مشهورًا في الأوساط الأدبية. كان الناس يظنون بأنه متشرد جوَّال حينما يشاهدونه على الطريق فقط لأنه كان يُفضِّل المشي بدلًا من ركوب عربة حصان. وبخلاف أدب الرحلات السائد في تلك الفترة الذي كان يصف لنا المشاهد من خلف نافذة عربة الحصان، كان موريتس يصف لنا المشاهد الحيّة كما اختبرها وعاشها أثناء تجواله. وصف لنا موريتس ردود أفعال الناس المحليين إثر لقائه، واختلاف اللهجات بين المناطق المختلفة، وكان يصف لأقرانه الألمان الصور المعلَّقة على جدران الفنادق التي نزل بها من العائلة المالكة وملك بروسيا. تنزَّه موريتس إلى أقاصي منطقة حديقة بيك الوطنية وصولًا إلى كاسلتون حيث يتوجَّب عليك دفع رسوم مقابل رؤية الكهوف (حتى في ذلك الزمن!). في العام التالي (1783)، نشر موريتس كتابه “رحلات ألماني في إنجلترا في عام 1782” وتُرجم الكتاب إلى الإنجليزية بعد 12 سنة بعنوان “رحلات على الأقدام في مناطق إنجلترا عام 1782″، ولاقت كِلا النسختين رواجًا كبيرًا.

في رحلاته، وصل موريتس إلى قرية أشفورد وما يجاورها، ويبدو بأنه وصل إلى وادي مونسال برفقة اثنين من الحرفيين المحليين، أطلق موريتس على أحدهما “صانع السروج الفيلسوف” و”الشاعري” الذي يبدو مطلعًا على هومر وموراس وفرجيل. ولم يكن موريتس ساخرًا حينما قال بأن في تلك الفترة كانت هناك صيحة لاكتشاف ما يُسمَّى بـ”الشُعراء الرُعاة” أو كل ما له صلة بالريف الأصيل، كطريقة لجعل أدب الطبقة الكادحة أكثر قَبولًا في الأوساط الثقافية. وبالرغم من أنني لم أعثر على مصدرٍ في مصادر التاريخ والأدب حول لقاء موريتس بصانع السروج هذا، إلا أن منطقة مونسال ديل أصبحت معروفة فيما بعد بوجود شاعر بين سُكَّانها. ما توصَّلت إليه من خلال بحثي هو وجود شاعر اسمه ويليام نيوتن، وهو صانع آلات لمطاحن القطن في ديربيشاير ونجَّار في بوكستون أيضًا، ومن المحتمل أن يكون هو الشاعر الذي رافق موريتس. يصف موريتس المنظر الذي وقفت قبالته وتأملته مراتٍ عديدة – الذي أصبح محجوبًا الآن بوجود جسر ڤيكتوري من العصر التاسع عشر لخط سكك حديدية والذي يتوافد إليه السُيَّاح إلى اليوم بفضل موريتس وكُتَّاب أدب الرحلات. وكما جاء بلسان الترجمة الإنگليزية لموريتس:
“وصلنا إلى منطقة مرتفعة، حيث طلب مني رفيقي صانع السروج الفيلسوف أن أقف متأملًا المنظر المهيب أمامي، الذي لم أرَ مثيلًا له في إنگلترا بأكملها. في الأسفل رأينا بحيرات مجوَّفة بامتداد الأرض الواقعة عليها، وأسفلها وادٍ صغير. يتخلل وسط المرج الأخضر بالوادي غدير صغير في مسارات متعرجة، بضفة غاية في الجمال تبدو مغرية للتمشِّي والتنزُّه على أطرافها. وخلف أحد مسارات الغدير الصغيرة، يقع بيت أحد أسعد السُكَّان في الوادي، الفيلسوف المتقاعد العظيم، الذي يقضي جُل أوقاته بين دراساته التي يُحبها. زرع الفيلسوف نباتات أجنبية في أرضه، وراح مُرشدي الشاعري يتغنَّى بكل شاعرية بجمال الوادي، بينما كان رفيقنا الثالث متململًا ضجرًا.

أجهدتُ عيناي مُحاولًا اقتناص المنزل الذي ذكره موريتس في كتابه آملًا أن يكون قائمًا إلى اليوم، وبدأت أشعر بفضول وهوس “المؤرخ الصغير” بداخلي لمعرفة من هذا “الفيلسوف العظيم”. ولكن هنالك مجال للمغالطة في الترجمة من الألمانية، فكلمة “عظيم” بالألمانية يمكن أن تعني أيضًا “ممتازًا” أو “مجتهدًا”، وبالتالي فإن استخدام هذه الكلمة في الإنگليزية قد تكون ضربًا من ضروب زخرفة الكلام. وبالرغم من ذلك فهي بلا شك تدل على مكانة هذا الشخص الرفيعة، ولكن من غير المحتمل أن يكون بمكانة إراسموس داروين (جد تشارلز داروين) الذي أنشأ جمعية ديربي الفلسفية، والذي كان يقطن أميالًا بعيدة عن منطقة بيك ديستركت. في القرن الثامن عشر، عُنيت نشرة ناتورفورشر الألمانية بفكرة فيلسوف الطبيعة، والتي يُمكن أن تعني كذلك عالم النبات الفضولي والمتأمّل في صنعة الله، الذي يأسره عالم النبات ويفتح له أبوابًا للتفكُّر والتدبر. واقترحت النسخة الألمانية المُخصصة لنقد كتاب رحلات موريتس بأن هذا الفيلسوف ما هو إلا جون بيكر الذي قطن طاحونة كريس بروك، والذي بالرغم من مطابقته لمواصفات عالم النبات المبتدئ، بدا لي هذا التأويل مُحبطًا وغير مميَّز البتة. في ذلك الوقت، كانت البستنة من الهوايات الشائعة جدًا، وبعد اطلاعي على قائمة اشتراكات الكتب والمجلات المعنيَّة بالبستنة والأملاح والزراعة، تبيَّن أن أغلب المنازل في تلك المنطقة كانت تبتاع هذه المطبوعات.
منغمسًا في بحثي بين كتب گوگل، صادفتُ اسمًا لا بد أن يعرفه كل عُلماء النبات ذوي الفكر الفلسفي في عالمنا اليوم، إنه توماس نولتون الذي كان متخصصًا في البيوت الزراعية الخضراء وله منشورات حول النباتات والزراعة، وكان معروفًا بحصاد الأناناس في إنگلترا بالقرن الثامن عشر. هل من الممكن أن يكون نبات الأناناس هو ما أشار إليه موريتس بـ”النباتات الأجنبية” في الفقرة السابقة؟ تخيلت فجأة المشهد الطريف: فاكهة الأناناس المتناثرة في الريف الإنگليزي كأنها حِلل تُزيِّن المكان، وشبهتها بقريناتها من الأناناس البلاستيكي الرخيص التي أعادت جدتي وضعها على طاولة المطبخ. وقد أبلغني المسؤول عن أرشيف مدينة تشاتسوورث والذي يدرس الدكتوراة في موضوع خدم تشاتسوورث بأنه بعد تقاعد نولتون، أصبح ناصحًا لدوق ديفونشاير الخامس، وهنالك منزل تعود ملكيته إلى مدينة تشاتسوورث بالقرب من مونسال ديل الذي من الممكن أن يكون منزلًا لنولتون. ما يحيدني عن هذه الفكرة هو حقيقة أن نولتون قد توفي قبل سنة من حادثة تجوال موريتس في المنطقة، وهو سبب كافٍ لإخماد حماسي الجارف للفكرة. ومع ذلك، فإن معلومات موريتس ما هي إلا كلامٌ متداول، حصل عليها من مُرشدٍ حرفته صناعة السروج، والترخيص الذي يملكه لمزاولة الإرشاد السياحي هو شاعريته المفرطة. كم يود المؤرخ الصغير بداخلي أن يكتشف هذا الفيلسوف العظيم، ولكنني لن أتمكَّن من فعل ذلك بدون الخيال الأدبي، وكلاهما معًا سيمنحانني الإجابة.

جاءت كتابات موريتس في توقيت مهم لتاريخ المشي، فمرافقاه من الطبقة الكادحة أثبتا لنا بأن إنگلترا شأنها شأن أي مكانٍ آخر، تنظر للتنزُّه الأدبي بأنه عادة سياسية متطرفة بدأت في عام 1800. وهنالك نظرة عامة (ولكن ليس كونية) على أن وردزورث كان شابًّا راديكاليًّا قبل أن يصبح مناصرًا لحزب المحافظين في سنٍ كبير، وبأن كتاباته حول المشي كانت مناهضة للرأسمالية. (ومما لا شك فيه بأن ووردزوورث كان كثير المشي، وبشهادة دي كوينسي بأنه مشى حوالي 175000 ميل). وأصبح المشي في إنگلترا فعلًا سياسيًا بسهولة، لأن القوانين جعلت من التجوال في الريف أكثر صعوبة. وفي عصر الرومانسية، احتكرت طبقة أصحاب العقار الاجتماعية السهول والغابات والتلال لاستخدامها الخاص، ومثال لذلك، كانت منطقة كيندر سكاوت ببيك دستركت للملك مفتوحة للعامة إلى أن سُوِّرَت في عام 1836، وفي عام 1932 أصبحت المنطقة رمزًا للتسلُّل المُخطط عاكسةً جوهر الصراع الحقيقي بين الطبقات الاجتماعية في إنگلترا. ومنذ ذلك الوقت، أصبح ذهاب الأثرياء إلى سويسرا للتنزُّه والتمشِّي صيحةً رائجة طوال القرن التاسع عشر، حيث بإمكانهم التجوُّل في طرقات الألب بدون إثارة الجدل.
وبالرغم من أن التنزُّه الأدبي اقترن بالحزب اليساري ليس في إنگلترا فقط، إلا أن ذلك لم يكن صحيحًا بالضرورة. وبغض النظر عن التفسيرات المختلفة حول شعر ووردزوورث، فقد غيَّرت الكتابات الألمانية حول المشي منذ عصر المدرسة الرومانسية المنظور السياسي بالكامل، فمثلًا، جاء هايدگر بمفهوم جديد للتفكير المقترن بالمشي وأطلق عليه اسم “ديكين”، ويقصد به المشي في الطرق الريفية للتأمُّل والتحرُّر من الأفكار والهواجس والنوايا. وبالرغم من أن هايدگر يقول بأن مفهومه عن الفكرة لا ينبثق من غاية الرضا عن النفس، إلا أنه من المُنصف أن نقول بأن فلسفته وجودية راديكالية. يُمكننا القول بأن فلسفة هايدگر تتمحوَر حول أن نكون حاضرين في هذا العالم، وأن نأبه لفهم دورنا فيه أكثر من محاولاتنا لتغييره، ففكرة هايدگر عن التغيير تنبثق من علاقتنا الأصيلة المجرَّدة بوجودنا فيه، وليس بتشكيلاتنا الاجتماعية. وبهذه الطريقة، من الممكن عدُّ فكر هايدگر على أنه ينتمي لحزب المحافظين، فقد كان متواطئًا مع النازية ومعادٍ للسامية. لا يُمكننا أن نتقفَّى أثر تحركات هايدگر وآراءه السياسية اليومية، كما لا يُمكننا أن نربطها بفلسفته بطريقة واضحة ومباشرة ولا بجوالته التنزهيَّة في الغابة الألمانية، ولكن يُمكننا القول بأن التنزُّه الأدبي ليس محكورًا للأحزاب اليسارية. وبالتالي، وصف التنزُّه الأدبي بالنشاطية كما وصفه زملائي الحذقين – الذين راح بعضهم إلى إقرانه بالنظريات الفرنسية حول ما يُسمَّى flâneur أي التجوال بلا هدف- ، ليس وصفًا صحيحًا بالضرورة.
وبترك السياسة جانبًا، يتشارك أغلب الكُتَّاب المُحبين للمشي في صفة معيَّنة وهي بأنهم كانوا اجتماعيين، وهي صفة تُتَجاهل وتُنكَر في أغلب الأحيان، لأنها دائمًا ما تكون مخفية. لم يعِش روسو بمفرده في جزيرة سانت بيتر- وأنت معذور إن أوحينا لك بعكس ذلك- بل كان في ضيافة جامع ضرائب من بيرن (ويذكر سيبالد بأن المنزل لم يخلُ من الضيوف ومن العاملين في المزارع). لربما كتب ووردزوورث “أهيم وحيدًا كغيمة” إلا أنه في الواقع كان برفقة أخته دوروثي، وأوصل هايدگر مفهومه حول التفكير بطريقة محادثة أرستقراطية بين عالم ومُعلِّم وباحث. حتى نزهاتي في منطقة بيك ديستريكت أو في سويسرا كانت برفقة أقرب الناس إلي: أختي وأصدقائي ووالديّ أو شريك سابق. كانت تلك نزهات للحديث الشيِّق أو للصمت المُشترك، ولربما كانت تلك الأحاديث المبتذلة والمألوفة في حرم الجمال المحيط بنا طريقًا للسعادة الروتينية التي استقاها روسو بمعزل- بنفسه وفي داخله.
ولكن روسو غادر منطقة بيك ديستريكت ليذهب إلى فرنسا، بينما أنوي أنا أن أبقى هنا لعدة أصيافٍ أخرى، فهنالك الكثير من الطرق لاكتشافها، والمحادثات التي تنتظرنا، والتفكير والتأمل في كنف الطبيعة الآسرة. ومن يعلم، قد تقودني لحظاتي الأكاديمية التأملية إلى احتراف البستنة أو تهوي بي إلى شراء الأناناس البلاستيكي.
بقلم: شون ويليامز| ترجمة: منال الندابية| تدقيق: عهود المخينية| المصدر