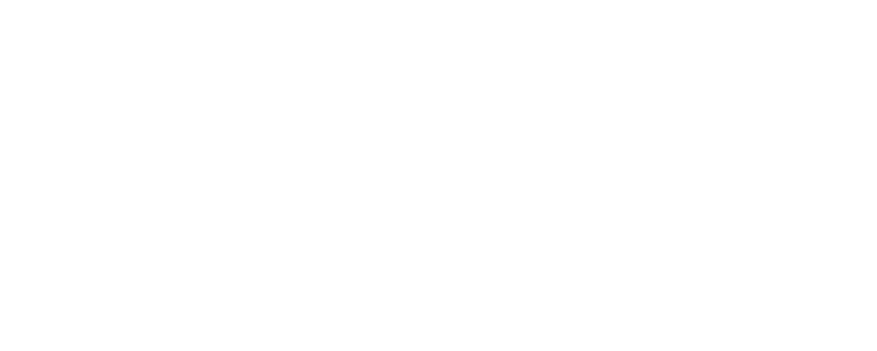أطفالنا بحاجة إلى البحث عن الجمال في كوكبنا المحترق
كيف سيعثر أطفالُنا على الجمال في عالمٍ سرعان ما تحوّل إلى مشهدٍ من الخسارات اللامتناهية كما وصفه المراقبون؟
شَهِدَ أشباهُ أوائل البشر الذين عاشوا في العصور الجليديّة، وتمكّنوا من رؤية مشاهدَ تحرّك الجليد وتوقّفه آنذاك فتراتِ مجيء العوالم وانتهائها بأكملها. إذ شاهدوا قبل 2.5 مليون سنة تقريبًا وحتى حوالي 9700 قبل الميلاد انخفاض مستويات البحار الذي سمح بانكشاف السواحل والجُزر، بالإضافة إلى ارتفاعها الذي أفضى إلى غَمر الجسور البريّة بالمياه وتحويل كلٍّ من تسمانيا وبريطانيا إلى جُزر. إن سريان الأنهار الجليدية أيضًا أدّى إلى فيضان الأودية وتغطية سلاسل الجبال بالجليد. كما تشكّلت صفائح من الجليد على سطح المحيطات ساهمت في تحويل أمريكا الشماليّة وأوراسيا إلى أنتاركتيكا، ثم ذابت باتّجاه الأراضي العشبيّة والغابات؛ الأمر الذي أدّى إلى انقراض ملايين الكائنات وأصبحت ملايين أخرى غيرها -بما فيها المخلوق البشري- لاجئة بسبب التأثير الذي أحدثته تلك الظواهر على المناخ. ونظرًا لدورات ذوبان الجليد وفترات الصقيع التي شهدتها العصور الجليديّة آنذاك، ظهر أول أفراد السلالات الآدميّ، هومو، وهو المخلوق الذي كان التغيير بالنسبة له أمرًا ثابتًا. وتعدّ قصة أسلافنا القدامى إحدى القصص التي تنحدر ضمن العوالم الجديدة التي لاقت قبولاً وترحيبًا كبيرين، مما جعلها عوالمَ صالحةً للعيش فيها.
وعلى الرغم من ذلك، يبدو حال العالم الآن مختلفًا. إذ يشهد كوكب الأرض مرحلةً يُعادُ فيها تشكيله بطرق وسرعة لم يشهدهما من قبل؛ وستعمل هذه العمليّة الكوكبيّة والحضاريّة على إحداث حالة من الانقلاب في عوالم الأرض كلّها واحدًا تلو الآخر ما لم تظهر عواملٌ تمنع حدوث ذلك. كما لا تَعِدُ تلك العمليّة بإعادة تشكيل الأرض والماء والهواء فقط، بل ستساهم أيضًا في صياغة علومٍ متعدّدة كالاقتصاد، والعلوم، والسياسة، والأخلاق.
تُنعتُ هذه الأحداث بأنها مجهولات معروفة. ولعلّ الأقلّ تقديرًا هو ذلك التحدّي الذي يُلقيه طورُ إعادة التشكيل الذي يشهدها كوكبنا على مفاهيم الجماليّات لدينا. فكيف بمقدورنا أن نعثرَ على الجمال ونقدّره في عالم سرعان ما تحوّل إلى مشهد من الانقسامات والخسارات اللامتناهيّة كما وصفه المراقبون؟
أرى العالم من خلال منظور آخر له صلة بممارسات الإحراق. ففي مرحلة إعادة تشكيل كوكب الأرض، أعزو سببَ الانقلاب الحاصل في كوكبنا إلى الحرائق، خاصّة تلك التي تتسبّب في حرق الوقود الأحفوري. ونتيجةٍ لذلك، أشاهد الحرائق تندلع بشكلٍ مروّع في كلّ بقعةٍ. ومن منظوري الخاص، الأنثروبوسين هو البروسين؛ نظرًا لأن الممارسات البشريّة الممثّلة في إحداثهم للحرائق تخلق ما يكافئ سبب اندلاعها في العصر الجليديّ. إن الحرائق وحتى المناظر الطبيعيّة التي تحوّلت إلى أراضٍ متفحّمة نتيجةً لذلك تعدّ مسألةً ذات صلة بالمفاهيم الجماليّة أيضًا، أكثر من كونها مسألة مرتبطة بصحّة الإنسان وممارساته السيّئة، والنظم البيئيّة المعطّلة، والمؤسّسات التي عفا عليها الزمن.
حضرتني هذه الفكرة خلال رحلة ميدانيّة إلى جبال الجيمز التي تقع في شمال المكسيك في عام 2014. وقبل ذلك بثلاث سنواتٍ، اندلع حريق لاس كونتشاس في شتّى أنحاء هضبة باجاريتو وحتى مختبر ألاموس الوطنيّ، وكان ذلك الاندلاع جزءًا من سلسلة أمواج من الحرائق المهيبةِ. وعندما انهار عمود دخان تلك الحرائق، أطلقت هواءً ساخنًا نحو الغابات والأودية مثل تدفّق الحمم البركانيّة من فوّهة البركان. وتسبّبت تلك الحرائق في القضاء على الغابات التي اندمجت مساحاتها مع انفجارات الحرائق المندلعة. كما تحوّلت مساحاتٌ أخرى منها في بعض المناطق إلى صخور جرداء دون أن تبقَ لها حتى آثارٌ سوداء. وكان كريج ألن، وهو باحث في مجال الحرائق في الهيئة الأمريكيّة للمسح الجيولوجي، أستاذنا. وبينما كنا نعمل على مسح المنطقة الريفيّة التي لا تزال تتفحّم بالحرائق، لم يصف لنا مشهد الاحتراق الذي كان يجري أمامنا بقدر ما وصف لنا مشهد المناظر التي سلبتها النار منه. وكانت تلك رؤية الأرض التي تمّت إعادتها إلى حالتها السابقة.
ويبدو كلّ ما وُجِد على الأرض وقتذاك طبيعيّا، بينما كل ما أعقب ذلك مجيئًا بما فيه الكائنات، والعادات، والآلات الجديدة يبدو دخيلاً على عالمنا، ومثيرا للقلق، وغريبًا.
كان ألن حزينًا بشأن خسارة مشهدٍ طبيعيّ. حيث أدّى الاستيطان في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين إلى تدهور الأراضي والغابات الأصليّة التي كانت ذات أهميّة في تلك المنطقة القاحلة. وقد أمضى فترة مهنيّة من حياته لدراسة تاريخ تلك الغابات، وكانت تجول في مخيلته فكرة إعادة تلك الغابات إلى حالتها الطبيعيّة التي عُرِفَت بها. والآن، لم تتدهور تلك الغابات فقط، بل أصبحت مغطّاة بالأراضي الصغيرة المُدَمَّرة كليّا. وقد قضى حريق لاس كونتشاس على المشاهد الطبيعيّة بشكل مروّع لم يُسبق له مثيل، وأكثر عمقًا من السجل التاريخي لحالات الحرائق التي سبقته، والتي قضت على رماد الأتربة وأشجار الغابات. وكان ذلك -على ما يبدو- نذيرا بميلاد عصر حرائق جديد لم يكن هدفه تجديد النظام القديم، بل إحداث شيء ما لم يشهده الكوكب من قبل على الإطلاق. ولم تكن تلك الحرائق ظاهرة إصلاحيّة أبدًا؛ نظرًا لأنها تسبّبت في إحداث حالة انقلاب للعالم. وتمثّلت ردة الفعل البشريّة الوحيدة الممكنة حيال ذلك في حزنهم فُرادى وجماعاتٍ أسفًا على حالة الانقلاب تلك.
مع ذلك، أتساءل ما الذي من الممكن أن يراه أحفادي من حالة التغيّر تلك لو كانوا حاضرين. واستعدتُ لحظةً ذَكَرَ فيها برتراند روسَل إلى أن أكثر ما يشير إليه البشر عندما يتحدثون عن عودتهم إلى الطبيعة هو في حقيقة الأمر انعكاسٌ لرغبتهم في الرجوع إلى العالم الذي عرفوه في طفولتهم (أو -سأضيف- العالم الذي عرفوه عندما بلغوا سنّ الرشد). ويبدو كلّ ما وُجِد على الأرض وقتذاك طبيعيّا، بينما كل ما أعقب ذلك مجيئًا بما فيه الكائنات، والعادات، والآلات الجديدة يبدو دخيلاً على عالمنا، ومثيرا للقلق، وغريبًا.
يمكن أن نصف عالم الطفولة الذي بإمكاننا أن نطلق عليه “البيئة المرجعيّة” بالمؤشّر الذي من خلاله يمكننا أن نقيس العالم الحاضر والقادم؛ إذ سيكون بمقدورنا أن نقيّم ما إذا كان هذا العالم مرحَّبًا به أو ناقمًا، أو رائعًا أو مدمَّرًا. ويمكن للبيئة المرجعيّة أن تكون ذات طابعٍ شخصيّ، كما من الممكن أن تكون مشتركة من قبل مجتمعٍ أو أمّة ما. وعندما يشهد العالم نفسه حالة التحوّل، يمكن أن يشتدّ أسفُ الفرد على ذلك الوضع الانقلابيّ ليمتد عبر الأجيال.
سيصادف أحفادي جبال الجيمز كما هي عليه الآن. وبالنسبة لهم، سيستمر وجودها كموقع النشأة وليس آخر ما تبقى منها. كما سيكتشف أحفادي ملامح الموقع البيئيّة ومستجدّاته، وسيستمتعون بكلّ ركنٍ من أركانه التي تبعث السلوى في نفوسهم. ومن المحتمل أن يتشوقوا للإيماء المؤلم إلى جذوع الشجر المحترقة تحت سماءٍ أهلكتها حرارة الشمس. فقد يبكون حسرةً على هلاك المناطق ذات القيمة العظيمة بالنسبة إلى كبار السنّ، ويتأسّفون على اختفاء حيوانات الماموث الغامضة وكُسالى الأرض العملاقة. وعلى الرغم من ذلك، سينتمي أحفادي إلى العالم الذين يعيشون فيه وليس العالم الذي سبقه؛ لأنهم يستحقون الحصول على فرصة تجربة العيش في الجيمز حسب شروطها وشروطهم، وليس وفقًا لتجربة الخسارة التي يشعر بها الآخرون.
تشهد أسوار حديقة القدس الوطنيّة الأستراليّة الواقعة في هضبة تسمانيا الوسطى حالة تحوّل مشابهة. ففي السنوات الأخيرة، اندلعت فيها حرائقُ يبدو أنها لم تشهد مثلها من قبل، وأدّت إلى تحويل الطحالب وأشجار الصنوبر إلى فحم ورماد.
قام الصحفيّ الأسترالي جو تشاندر بزيارة الهضبة في عام 2020 من أجل التعرّف إلى أعمال دافيد بومان الذي يعمل في مجال دراسة الحرائق الطبيعيّة وتأثيرها على النظام البيئي. وأخبرها بومان بأن مشكلة العصر الجليدي تكمن في إمكانية وصفه بفترة سينتهي فيها الزمانُ، بينما هو حقيقةً ليس إلا عَتَبةً له. العالم ليس في وضع الانتهاء، وإنما يشهدُ حالةً أخرى جديدة يُعادُ فيها جميعُ كلِّ شيءٍ. وبالنسبة لي، ليس رأيه إلا انعكاس للمقولة الساخِرة لويليام فولكنر القائل بأن “الماضي لا يموتُ أبدا ولا يُنعت بأنه ماضيًا حتى. إذا كان الماضي ماضيًا، فالمستقبل ليس آتٍ أيضًا وإنما هو موجودٌ هنا.”
إذا أصبحنا نرى مستقبل العالم فقط من خلال تصوّرات الماضي، علينا أن نعتبرَ ذلك بأنه خسارة. ولهذا، سنكون بحاجة إلى أن نقدّر الفنّ حقّ تقدير بما يتلاءم مع عالمنا الجديد.
ذكر تشاندر أن بومان اعتقد بأننا لسنا بحاجة إلى أن نرى كل شيء من منطلق ما نفقده وما فقدناه. وتعقيبًا على مشهد الأشجار المسوّدة والأرض المحروقة المحيطة بها في أعالي الهضبة، كان بومان صريحًا وكثير الأمل بأن ثمّة نَواحٍ جماليّة اشتملت عليها تلك المشاهد الطبيعيّة:
باستطاعتي أن أنظر إلى هذا الأمر وأمضي قائلاً “حسنًا، أنت تعلم بأن العالم في حالة تغيّر، وأنه احترق. هذا أمر مؤسِفٌ. إلا أنه يتجدّد بحيث ستوجد حياة هنا. كما لا تزال المناظر الطبيعيّة تتمتّع بجمالها.” وتحافظ أشجار الصنوبر على جمالها أيضًا حتى وإن تمّ إهلاكها… كما أن الفنّ باقٍ بطريقةٍ ما، ولا يزال البشر يمنحون الأشياء قيمتَها.
في واقع الأمر، ثمّة صلة وثيقة بين القيمة والفنّ: نعطي قيمةً لما نجده قيّما وجميلاً. فمثلاً، تظلّ البيانات مجرد بيانات إن لم نضف إليها إطارًا، أو إذا افتقرت إلى ملامح جماليّة. إن صياغتنا للمفاهيم الجماليّة وتجديدها بشكل دائم يساعد في فهمنا لكيفية إعادة تشكيل الطبيعة. وإن أصبحنا نرى مستقبل العالم فقط من خلال مرآة الماضي وتصوّراته، علينا أن نعتبرَ ذلك بأنه خسارة. ولهذا، سنكون بحاجة إلى أن نقدّر الفنّ حقّ تقدير بما يتلاءم مع عالمنا الجديد.
إذا كانت فكرة إعادة إحياء جماليّة الأرض تبدو مروّعةً آنيّا، فثمّة فكرة مماثلة سبقتها. إذ شهِد تاريخ الفنّ والطبيعة العديد من التحوّلات المتعلّقة بالأحاسيس والمواضيع والآليّات. على سبيل المثال، تسبّبت المناطق الصحراويّة الداخليّة لأستراليا والتي تبدو مسطّحة وقاحلة في إحداث صدمة لعادات المناظر الطبيعيّة البريطانيّة. ونظرًا لأن الثورة الصناعيّة أبعدتنا عن العيش في الطبيعة وأدخلت أشكال عَيش جديدة إلى حياتنا، ارتفعت الحداثة وما بعد الحداثة استجابةً لذلك. ولهذا، سيثير العصر الجليدي الإلهام لحدوث شيءٍ مشابه. ولقد بدأت تلك العمليّة فعلاً لهؤلاء الذين وُلدوا للتو أو بلغوا سنّ الرشد.
يرجع المشهد الطبيعي الخاص بي إلى اللحظة التي وجدتُ فيها نفسي عندما كنت في الثامنة عشر من عمري ضمن طاقم إطفاء في غابات منتزه كانيون جراند الوطني. ويعدّ هذا المنتزه إحدى المشاهد الأسطوريّة في العالم، والتي يسهل تمييزها على الفور عند رؤيتها. وكانت الحافّة الشماليّة له تبعد عن ضواحي الفونيكس في الأريزونا؛ إذ بدت كما لو أنها كانت من خارج الأرض.
لقد تم إيواؤنا على مقربة من حافته، وكان بالنسبة لنا المكان الذي عشنا وعملنا فيه. وخلال مواسم الحرائق الخمسةَ عشرَ التي قضيتها في الوادي، بدا تقديرنا وانتماؤنا لذلك المشهد أكثر غرابةً، خصوصًا كلما أصبح الأمر مألوفًا. ولهذا، بدا مشهد الوادي وكأنه مثل أي شيء اخر في التقاليد الجمالية للحضارة الغربية، فكيف ولمَ حَظِيَ هذا المكان بتلك الشهرة الكبيرة؟
في نهاية الأمر، أصبحتُ منجذبًا بشدّة إلى دراسة تاريخ منطقة جراند كانيون خلال عام 1882. كان المؤلف هو الكابتن كلارنس دَتون الذي تخرّج من كليّة ييل، كان أحد المحاربين القُدامى في الحرب الأهليّة التي وقعت آنذاك. ظلّ يعمل في الجيش، وتعلّم الجيولوجيا، وأجرى العديد من عمليّات المسح المدنيّة للغرب الأمريكي لأكثر من خمس عشرة سنة مع فيلق المدفعيّة.
يكمن هدف الكتاب في تقديم شرحٍ لمراحل التطوّر الجيولوجيّ التي شهدها الوادي، وصياغة جماليّاته بما يُسهم في إضافة قيمة له. وتمثّلت رؤية دَتون العظيمة في تقبّل غرابة المشهد المستمرة؛ إذ اتّصف ذلك الوادي بكونه إحدى أقدم عجائب العالم الجديد التي واجهها المستكشفون الأوربّيون. إحدى الرحلات الاستكشافيّة كانت تلك التي أجراها المستكشف الأسباني فرانسيسكو فاسكيز التي اتّجهت إلى الحافة الجنوبيّة من المنطقة عام 1540. وعودة المبشّرون الفرنسيسكان في السبعينيّات من القرن الثامن عشر. ومعرفة صيادو الفرو الأمريكيّون بوجود “الوادي الكبير” في ثلاثينيّات القرن التاسع عشر. إلا أن الحملة الأولى للرحلة الاستكشافيّة التي نُظّمت لغرض البحث عن الجماليّات والتي كانت ضمن رحلة بحريّة أجراها جيشُ المهندسين الطوبوغرافيّين خلال الفترة 1857-1858 إلى نهر الكولورادو رفضت قبول المشهد، مؤكّدةً بأنه غير صالحٍ للسير فيه، بالإضافة إلى أنه لا يمكن استيعابه البتّه. كما أكّد الملازم جوزيف إيفز قائلا: “كانت رحلتنا الأولى وستكون بلا شك الرحلة الأخيرة التي ستجريها مجموعة من السكّان البيض لزيارة هذا المكان غير الربحيّ على الإطلاق.” ولكنّه صدق القولَ عندما يتم النظر إلى المشهد من الناحية الجماليّة التقليدية.
حاز حكم الملازم إيفز حول هذا المشهد على القبول من دَتون، بيدَ أن الآخر عكس ذلك الحكم قائلاً: “كان ذلك المشهد ذا قيمةٍ وخاصةً بسبب كونه غريبًا للغاية.” وأضاف أيضًا: “يمكن وصف الوادي بأنه ابتكارٌ بالغ الأهميّة في الأفكار الحديثة للمشهد الطبيعي،” بالإضافة إلى أنه أشار إلى أن المُدخلات المبتكرة من أيّ نوعٍ تتطلّب التنمية والتطوير قبل أن تحظى على تقديرنا لها واعترافنا بقيمتها. واستطاع دَتون أن يضعَ شروطًا لاعتبار المشاهد الطبيعيّة ذات الخواصٍ الجماليّةٍ، بمساعدة الفنانين الأمريكيّين المختصّين في عالم الطبيعة ومشاهدها كويليان هنري هولمز وتوماس موران. وبعد مضيّ أربعين عامًا تقريبًا، إنّ المشهد الطبيعي الذي رفض الملازم إيفز تقديره وصرّح بأن لا قيمة له أمسى ذات أهميّة جماليّة كبيرة بالنسبة إلى الحاكم الأمريكي ثيودور روزفلت الذي وصفه بأنه “المشهد الطبيعي العظيم الذي يتعيّن على كلّ أمريكيّ مشاهدته.” ولهذا السبب، أصبح الوادي “عظيمًا.”
ليست طبيعة المشهد هي من يحدد قيمته، وإنما طابعه الجماليّ وقيمته المعنويّة تنبعان من مشاهدتنا لهذا المشهد.
واجهت تحديّا مشابها للتحدّي الذي واجهه داتون عندما قضيت الموسم الميداني في انتاركتيكا خلال الفترة من 1981 إلى 1982. وخلال أول أسبوعين، أُرغمت فيهما على الاعتراف بأن المفاهيم المسبقة لدي عن المكان وكيف لي أن أفهمه كانت خاطئة. لذا، لم تكن محاولة وضع انتاركتيكا في السياقات السرديّة والمعايير الجماليّة التقليدية منطقيّة على الإطلاق: كان الجليدُ فريدًا من نوعه، أو الأسوأ من ذلك كان نفيًا أزال كلّ شيء يمكن إزالته إلا نفسه.
على ما يبدو، أتت انتاركتيكا باقتراحٍ ابتكار جديدٍ وعظيمٍ في أفكارنا الحديثة عن المشاهد الطبيعيّة. وتجسّد ذلك الابتكار في المطالبة بسرد مختلف للاكتشاف، واستحقّ وجود خاصيّة جماليّة تعكس الطبيعة المميّزة له بدلا من أن تُلغيها وتحوّلها إلى صيغٍ موروثةٍ. وخلال وجودي في انتاركتيكا، واجهت الصدمة نفسها التي مررت بها عند حافة الأخدود. وعندما كتبت دراسة عن الجليد (1986) من أجل إجراء بعض المسوحات لذلك المشهد المتجمّد، استعنت بدتون ليكون دليلاً لي.
إنّ التحدّي الجماليّ الذي أحدثه البايروسين يتجاوز ضبط القيم الفنيّة التي تمّ توظيفها على مشهدٍ مبتدَع من الطبيعة أو إيجاد طرق من أجل “إضافة الخاصيّة الطبيعيّة” لمشهد مركّب، وذلك من خلال مواءمة المعايير الجماليّة للجبال مع ناطحات السحاب. ونحن لسنا-أشباه البشر- نعمل على إضفاء أيّ تعديل على مفاهيم القيم للاضطرابات التي تختلف حدّتها باختلاف حجم القارات والتي تفرضها التغييرات التي تطرأ على الإشعاعات الشمسيّة، بل نحن الوكلاء المعنيّون بإحداث انقلاب على النظام الطبيعيّ الحالي. كما أننا رواة لا يمكن الاعتماد عليهم لتقييم أعمال غير مدروسة من صنعنا، وتم إعدادها بإضفاء الخاصيات الجمالية بعضها، وإنما لتقييم التبعات غير المقصودة لاضطراباتنا المستمرة. ومن الصعب أن نحجب النظر عن الغابات المدمَّرة، والشعاب المرجانيّة المبيَّضة، والمشاهد الطبيعيّة المغطاة بالإسفلت والبلاستيك وألا نردد قول إيفز بأنها أصبحت مشاهدَ “عديمة المنفعة” ولا تستحقّ أن يُلقى عليها نظرة ثانية من وجهة النظر الجماليّة.
وعلى الرغم من ذلك، سيكون داتون على حق. إذ ليست طبيعة المشهد هي من يحدد قيمته، وإنما طابعه الجماليّ وقيمته المعنويّة تنبعان من مشاهدتنا لهذا المشهد. وتزخر المناظر الطبيعية الحديثة بوفرةٍ من “الابتكارات” التي تنتظر مجيء المفسرين الأكفّاء الذين سينحدرون من جيل أحفادي.
خلال رحلة مطاردة الدخان المنبعث من الحرائق المندلعة على حافة الوادي خلال الموسم الثاني، ثمّة إصلاحٍ تمّ إجراؤه على سياسية الحرائق دعا إلى ضرورة حرق الأماكن التي لم تندلع فيها حرائق. فشرعنا عمدًا في حرق مناطق لإعادة تجديد أشجار الصنوبر والحور وتحفيز إنبات أعشاب الموهلي والعكرش. وتلك التجربة مع الوقت علّمتني أن أنظر إلى المشاهد الطبيعيّة بطرق مختلفة. فبدأت أرى أن الأسود ينتمي إلى الأخضر وساعدت المساحات المفتوحة والغابات المدمّرة على تعزيز الزراعة الأحاديّة للأخشاب. ويجدر بالذكر أن المشاهد الطبيعيّة التي أهلكتها الحرائق لم تكن في غاية الأهميّة من الناحيّة الأيكولوجيّة فقط. إذ أدركت بأن تلك المشاهد المدمّرة بالاحتراق قد تكون ذات طابعٍ جذابٍ وجماليّ وعلى الرغم من ذلك، أجد صعوبةٍ في رؤية كوكبنا يحترق بطرق مشابهة.
وبينما كنتُ سأقدم على منح التقدير للجليد الذي قد يبتهج ببساطته المروّعة، اتّضح لي بأنه عدوانيّ وغير إنسانيّ وهنا تكمن خاصيّته في قدرته على محو عنصر الجمال من المشاهد. ولهذا، لا أتوقّع أن ثمّة حماسٍ سيغمرني لمساعي البايروسين ومحاولاته لإضفاء الجمال إلى تلك المشاهد، في حين أنني أتوقع -بدلا من ذلك- أنني سأحاول التمسّك بما يمكن التمسّك به من مشاهد، وأتأسف على ما تمّ فقدانه، وأن أتذمر على ما يستحق في الحقيقة أن يوصف بمعاني الروعة والجمال.
لعلّ واحدة من الجماليات الراسخة المرتبطة بعصرنا -البايروسين والأنثروبوسين- تتمثّل في الكيفيّة التي سيضيف بها العصر قيمةً لأطفالي وأحفادي. إنهم يستحقوا العيش في عالمٍ أفضل من العالم الذي سيكونون جزءًا منه، إلا أنهم يمتلكون أيضا حقّ رؤية هذا العالم من أجل أنفسهم وليس ككوكبٍ هالك ومدمّر تمّ فصله عن السمو والمجد الذي عُرف بهما سابقا. وسأخبرهم بأن هذا العالم لن يكون سهلاً، بيد أن تجربتي ستؤكد بأنه يمكن استعادة مجد كوكبنا.
بقلم: ستيفن جي باين | ترجمة: أصيلة العدوية| تدقيق: لمياء العريمية| المصدر