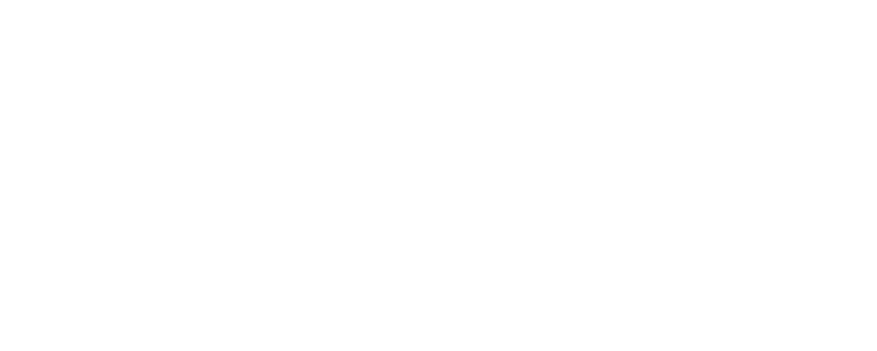ما دور العلوم الإنسانية وقت الأزمات؟
ليست الأزمات دروس حكمة، خاصة وقت حدوثها، ولكنها تظل مواقف ولحظات نتعلم منها.

ما الجامعات إلا حدائق غنَّاء مغلقة والفصول الدراسية في قعرها، فيها تُحجب المطالب الدنيوية عن مجموعة من الناس بما يكفي، بعض هؤلاء من لا يجد في نفسه الحاجة إلى مشاركة قصيدة لهوراس أو قضية لأرسطو للعامة. ولكن في ظل الأوضاع الحالية، اضطرت العديد من الجامعات في الأسابيع الماضية إلى إرجاع طلابها إلى مواطنهم وانتُهك ذاك الحرم المقدس. نقل الفصول الدراسية لتصبح فصولًا إلكترونية معناه استبدال تلك المساحة الآمنة والمشتركة إلى مجموعة من الغرف الشخصية الفوضوية. حتى وإن لم يظهر للعيان أكوام الملابس والصحون أو ليس بالإمكان سماع صراخ الأطفال، تظل تحوم هناك وتفرق بيننا وتشتتنا. أولم تغيِّر العديد من الجامعات سياسات النجاح والرسوب فيها، فما هذا إلا اعتراف واضح بمدى صعوبة عزل ڤيروس كورونا في الخارج والحفاظ على هوراس وأرسطو داخلًا.
قد تبدو هذه الأمور تافهة للبعض، أوليس هنالك مشاكل أكبر من الشعراء والفلاسفة القدماء، أو مخاوف أكبر من الحصول على درجة جيد أو جيد جدًا! حتى في الأيام العادية يُسخَرُ من الأكاديمية الإنسانية كونها عجلة لا تحرك شيئًا. ففي الأوقات الحرجة، عندما يهرع الأطباء والموظفون للحفاظ على سلامة المجتمع، لا يعبأ أحد باستمرار تطور العجلة. إذن، ما دور أرسطو أو الشخص الذي يدرس أرسطو في الأزمات؟
وقد تكون إجابة جان أميري أكثر إجابة متشائمة لهذا السؤال؛ ففي مقالات الكاتب اليهودي النمساوي والذي سمي هانس مير عند ولادته، كتب بإسهاب كيف خذلته دراسته في المجال الإنساني في الحرب العالمية الثانية. عايش أميري وحشية معسكرات الاعتقال ووصل إلى قناعة أن الحياة الفكرية ما هي إلا لعبة والمفكرون ليسوا أكثر من لاعبين بتلك النار. قارن نفسه بالسجناء أصحاب القضايا السياسية و الدينية؛ كالماركسيين و شهود يهوه (جماعة دينية بين اليهودية والمسيحية) والكاثوليك واليهود المؤمنين. ووصفهم أنهم “راسخون، هادئون وأقوياء” كونهم جزءًا من نضال أكبر، كانت قضيتهم هي الأساس الثابت الذي جعل من الحياة في معسكرات الاعتقال متصلة بما قبلها ومستمرة لما بعدها. في حين أمثال أميري؛ الإنسانيون والفلاسفة والمشككون، وقعوا في بئر اليأس، وفي وجه كل الفظاعات التي عايشوها “فقدنا إيماننا بحقيقة وجود عوالم عقلية”.
وكان أميري على وشك أن يمنح المثقفين أصحاب الأهداف السامية والمدافعين عن القضايا الأخلاقية وسام البطولة. ويمكننا عد فريدريك دوغلاس ومارتن لوثر كنج و كارل ماركس وغاندي والمسيح و النبي محمد وماري وولستونكرافت وسوزان أنتوني ضمنهم، هؤلاء المثقفون دافعوا عن مبادئ المساواة وقدسية الحياة الإنسانية وكرامتها. ولكن لم يصنف أميري نفسه ضمنهم.
تعرض أميري للتعذيب على يد الغِستابو ( أو البوليس السري الألماني) واعترف بصراحة أنه كان سيشي بأصحابه إن كانت لديه أي معلومات لإفصاحها. بالتالي فهو يفصل نفسه عن نوع آخر من الأبطال المثقفين، أولئك الذين لديهم القوة على عدم التحدث عند تعذيبهم أو من يصرون على الكلام عندما يُسكَتون، غاليليو هو مثال أثير على الأخير. كما يمكن عدّ سقراط و جيوردانو برونو وتوماس مور وسبينوزا ضمن هؤلاء الأبطال.
لا شيء يمنع هاتين الفئتين من التقاطع؛ فهنالك أشخاص أصحاب قضايا قد أُسكِتُوا. ولكن العديد من المثقفين الإنسانيين لا ينتمون لأي فئة؛ ليست لديهم قضايا يقاتلون من أجلها ولا أعداء يقتلونهم. هؤلاء المثقفون بلا قضايا ولا مبادىء هم من يجدهم أميري ناقصين. لم يقتصر الأمر على وصف ضعفهم الجسدي فقط بل يجدون صعوبة في الدفاع عن أنفسهم ضد النشالين أو تحمل اللكمات أو حتى ترتيب أسرتهم، ولم يكتفِ بذلك، فوصف ضعف مهاراتهم الاجتماعية وعدم قدرتهم على التواصل مع الناس “غير المثقفين”. كان أمل أميري أن يثبت هؤلاء شجاعتهم في كل أزمة، حتى تلك الأزمات ذات الحرمان الجسدي العظيم. ولكن السؤال الذي يجب علينا طرحه هو ما إذا كان ذلك ممكنا في أي أزمة، قد يتغير منظورنا للأمور. في الواقع، إن كانت هناك أي أزمة قادرة على تأكيد أهمية المثقفين الإنسانيين فهي هذه الأزمة العجيبة التي نعيشها اليوم.
يعد ڤيروس كورونا للكثير منا دعوة إلى عدم التحرك. فهو يوقف الحياة لوهلة، ويقلص وجودنا في هذا العالم ويدفعنا للنظر إلى دواخلنا. وكانت ردة فعلنا أننا اتفقنا على مجموعة من التكتيكات المشتركة. فأولئك الذين ليست لهم يد مباشرة في تحسين الأوضاع والذين هم دون أطفال ولديهم القدرة على جني المال من البيت سيدفنون أنفسهم في العمل. الإنتاجية هي الترياق وآلية التأقلم في مثل هذه الأوضاع. وقد يلجأ البعض إلى التشتيت؛ من خلال ألعاب الڤيديو التي تحاكي ما لا نستطيع عمله، والأفلام الخيالية التي تحل محل العالم الواقعي المتداعي أمامنا، والكحول لتسكين الألم والخوف. تخدرنا الإنتاجية من جانب والتشتيت من جانب آخر، وعندما يفشل كلاهما، يقودنا الأمر إلى القلق أو بمعنى آخر متابعة الأخبار بشراهة.
التخدير أو القلق: هل هذه هي الخيارات الوحيدة المتاحة لنا؟ توجهنا الإنسانية لخيار إضافي. يفرق أرسطو بين الاسترخاء (anapausis)؛ وهو عندما نأخذ قسطًا من الراحة من نشاط ما على أن نرجع إليه، وبين التأمل الحقيقي (scholē)؛ وهو عدم فعل شيء لهدف أسمى. وُجدت الأكاديمية في حد ذاتها للتأمل والتفكر (فالكلمة الإنگليزية “school” جاءت من “scholē” ). لا يُصنف التأمل على أنه مبدأ يؤمن به الشخص أو يدافع عنه بسهولة، وكل محاولات إدخال هذا المبدأ في حديث العدالة والكرامة وحقوق الإنسان الأساسية ستذهب مهب الرياح. ولكن يُنظر إليه بصفته غرضًا للحُب والتبجيل ومنبعًا للقناعة. أما الإنسانيون، لا يرون التأمل مصدرًا لشيء وإنما نداء لشيء أعظم.
في وقتنا الحالي، إن كان بمقدور المرء تكريس ساعات وساعات لنداء في داخله، فبين يديه كنز من ذهب. وعلى نفس المنوال، فإن الإنسانيين مؤهلون بما فيه الكفاية للازدهار، في ظل الظروف الحالية.
الآن هو الوقت المناسب للتفكر مليًا في أن الوضع البشري يتطلب العيش في ظل الموت. وهو الوقت المثالي للنظر في الحاضر وموقفه في التاريخ الإنساني. وبما أننا محرومون من حقيقة التواصل الإنساني، فيجب علينا اليوم تقدير هذه الفكرة أكثر عن ذي قبل. وبما أن معظمنا أساتذة ومعلمون فيجب علينا إيصال هذه الفكرة للناس وتقديم خيار لهم غير التخدير و القلق. لأنه ولأول مرة في التاريخ، أجبرت أزمة عالمية نسبة كبيرة من السكان المتعلمين وخبراء الإنترنت للمكوث في بيوتهم. إن كان هذا هو الاختبار الذي تنتظره البشرية، فأنا أجد نفسي غير قادرة على اجتيازه.
خلال الأسابيع الماضية، ترددت نفس الأخْيِلَة عندي مرارًا وتكرارًا، فيها أخلد للنوم وأستيقظ عند انتهاء الجائحة، ولتخفيف شعوري بالذنب على عدم مساعدة الآخرين، يمد عقلي غطاء النوم ليغطي البلاد كلها، كما في القصص الخيالية. جميع الناس فيها أصحاء، غير عابئين بعدد المرضى، نائمون بسلام لأشهر ولسنوات حتى. يستيقظون بعدها وترجع الأمور إلى مجراها الطبيعي.
ولكن في الحقيقة، أنا لست نائمًا بل مستيقظًا أتابع الأخبار بشراهة وأنزعج من أتفه العقبات والمصاعب. لقد عذب الغِستابو أميري في حين أنني أواجه نوبة قلق لأنني لا أستطيع الولوج إلى مكتبي في الحرم الجامعي. يكافح الناس في الخارج ويموتون في حين أنني لا أستطيع عمل شيء بسبب الفوضى في غرفتي. ما يزعجني ويحزنني حقًا هو تساهلي مع الأمور؛ فجأة أصبح أن يلعب أطفالي بألعاب الفيديو أو أن يكرروا ملابس الأمس اليوم أمرًا عاديًا، أن أبذلَ أقل جهد ممكن في إعداد العشاء، ليلة تلو الأخرى، وأن أكتب أقل وأقرأ وأفكر دون المعتاد. يبدو لي أن هذا التسامح والتساهل مع النفس هو شكل من أشكال اليأس، على نقيض النهوض لتحقيق هدف ما والذي يتطلب التزام المرء بمجموعة رفيعة من المبادئ. لم أشعر ببُعدي عن البطولة والشجاعة كشعوري اليوم.
قد يكون هنالك إنسانيون آخرون أفضل أداءً، ولكنني أعترف أن تعليمي الإنساني فشل في إثبات نفسه في هذه الأزمة، التي تبدو وكأنها صُممت لبيان قوة الإنسانية. لم ينتج عنها الوصول لمعنى سامٍ أو هدف أسمى أو حتى ثبات نفسي، لا لي ولا للآخرين.
هل هذا هجوم ضد العلوم الإنسانية؟ في رأيي لا، بل هجوم ضد الأزمات. فقد اعتقد أميري أن الهولوكُست قد كشفت عن ذاته الحقيقية “لم يكن للواقع هذا التأثير القوي في أي مكان آخر أكثر من المعتقلات، كانت أكثر شيء حقيقي”. كانت الوحشية التي عاشها أميري والرعب الذي رافقها أكبر قوة مقنعة. أقنعته أن حياته السابقة عندما كان طالبًا للأدب والفلسفة في ڤيينا، الأيام التي كان يكتب فيها روايات تلقى استحسانا عند الجمهور، تلك التي كان يؤمن فيها بروح الحياة ما كانت إلا وهمًا وادعاء ولعبة كلمات. ولكنها لم تكن كذلك، ليست الوحشية حجة وإنه لأمر مأساوي أن يعتقد المرء الذي يمر بها أنها سبب قسوة أحاسيسه، كالتجلي لحقيقة الواقع بالضبط.
ولأنني أعيش في مأساة ألطف بكثير، فإن رؤيتي أقل تشويهًا عن رؤية أميري. لم أؤمن قط بمبدأ التأمل الحقيقي كاليوم؛ تلك القوة المستمدة من قدرتك على تكريس وقت لهدف أسمى، ولم أستطع تحقيقه رغم رغبتي في ذلك.
أفضل الأشياء أرقُّها، ففكرة أنها قابلة للتحطم لا يتنافى مع قيمتها بل يفرض علينا حماية هشاشتها. نعم، من الممكن أن تقلب هذه الأيام ذهبًا ولكن هذا الهدف يستلزم مددًا. أستطيع أن أعلمك شيئًا من قضية الذرية العميقة في كتاب أرسطو “الكون والفساد”، أن تتحمس لها وتخوض في الفيزياء القديمة، ولكن يجب أن تكون الأوضاع صحيحة. أحتاج لفصل دراسي حقيقي، سبورة سوداء، ومجموعة من الطلاب المألوفين، وأحتاج أن يكون العالم الخارجي هادئًا. وليس كون الأوضاع اليوم تعيق هذه البيئة دحضًا للفلسفة، بل دليلًا على حجم الجهد الذي نحتاجه لإرجاع الأمور إلى مجراها الطبيعي، حتى يتسنى لنا مرة أخرى مساعدة بعضنا البعض في تبيان كم أن عالم العقل عالم رائع وخلاب.
قد يكون ضرر الأزمة الحقيقي في أنها تتيح لك الكثير من الوقت للتفكير في أن بإمكانك تعلم الكثير. الأزمات، خاصة في وقت حدوثها، ليست فرصًا للتعلم، بل هي أحداث تقع علينا، تؤذينا، وتستهدف كل شيء فينا، بما في ذلك قدرتنا على التعلم.
هل يجب علينا أن نؤمن بشجاعة المثقفين- خاصة تلك التي دون قضية ودون تعذيب؟ بالطبع! ولكن عوضًا عن البحث عنها في أوقات الأزمات، يجب علينا توجيهها إلى العالم الداخلي، تلك الحديقة الغناء. وتذكر تلك المرة التي قرر فيها الطالب المليء بالأفكار العظيمة رفع يديه أخيرًا. تصور معي ما حدث؛ كيف تدفقت الكلمات من فمه، كيف انسلخ من شكوكه وخوفه، وكيف أنصت الفصل ثملًا بكلماته. كل معلم يقر بوجود هذه الشجاعة، كما نعرف كيف تبدو؛ فهي واضحة، تلقينية، وغالبًا غير مرئية للشخص المنخرط فيها. وهذا ما يرجعُنا إلى جان أميري.
كتب أميري كتابًا عن الانتحار، وبعد بضع سنوات من كتابته انتحر أميري. أفترض أن التجارب التي عاشها في الحرب هي اختبار لكل ما هو عليه؛ مفكر، باحث عن الجمال، قارىء، وإنسان، وحكم على نفسه بالفشل. كتب عن تعذيب الغِتسابو له: “لم يتوقف الأمر، 22 عامًا وما أزال متدليًا على الأرض بذراعي المخلوعة، ألهث وألقي اللوم على نفسي”. ما لم يتنبأ به أميري هو تأثير كتاباته ذات الوعي العميق بالألم والكرامة و الحرمان والفقد.
فهو يتحدث عن المعاناة من منظور شخص لم يستطع النجاة منها، فهو يسوق هذه المشاعر الهشة للقارئ بتحليل دقيق محايد. وأسلوبه أسلوب محسوب ومثقف و عميق. هو كل إنسان فينا.
تصرخ مقالات أميري بالحقيقة، ولكنها ليست الحقيقة الكاملة. هي تحكي قصة فشل تعليمه الإنساني في نجاته من معسكرات الاعتقال ولكنها لا تحكي قصة المقالات نفسها. كيف استطاع رجل أن ينقل تجربة لا حدود لها. الإجابة هي: التعليم الإنساني. غارقًا في العار، يدعونا أميري إلى النظر في نفسه المدمرة، حتى ندرك الحقيقة التي نخشاها: “كل من تعرض للتعذيب سيبقى معذبًا للأبد” وفي يديه مجموعة من الكلمات: “معسكرات الاعتقال اليهودية” و”الوحشية” و”المنفى” تبدو في أفواه متحديثها مساحات لفهمٍ نأمل ألا ندركه. أقول هذا الكلام وأنا ابنة أربعة أجيال ناجية من معسكرات الاعتقال. لم يستطع أجدادي نقل ما فعل أميري ولا أظنهم رغبوا بذلك! إن تحدثت عن العذاب قبل أميري فإنه كان محض لعبٍ بالكلمات.
لا يتوقع المرء الذي يكتب عن تدمير الروح البشرية تقبُلًا من الجمهور. ولكن أميري فهم متلقيه؛ عرف من يواجهه. تبحر كلماته فوق الزمان والمكان والثقافة، وأعمق المياه تلك التي تقع في المسافة بين المعذَب والناجي، لكي يخاطب القارئ بلغة عقله الأصلية. في النهاية ما للقارئ سوى الاستسلام وهذا انتصار مدهش للتواصل بين الاثنين؛ لم يخطر في بال أحد الاختبار الذي يقع على العلوم الإنسانية. ولكن أميري أثبت ذلك، كان بطلًا وكان معلمًا.
بقلم: آغنس كالارد | ترجمة: روان البداعية | تدقيق: عهود المخينية | المصدر