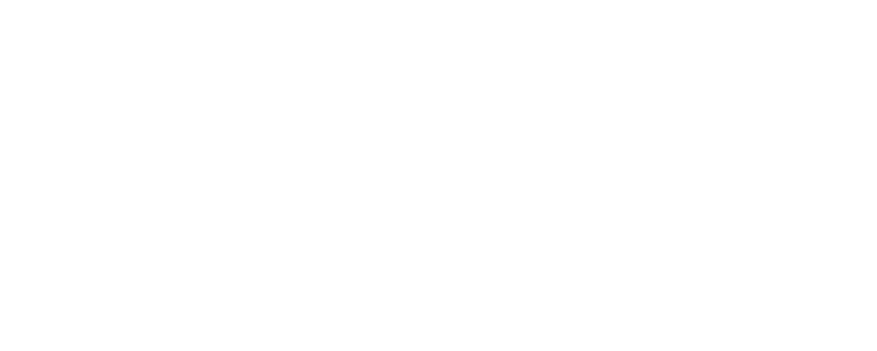قُرَّاء جيّدون و كُتَّاب جيّدون

إن مساري الذي انتهجه ، من بين عدّة أشياءَ أخرى ، هو نوع من التحري البوليسي لغموض البناء الأدبي.
“كيف تُصبح قارئًا جيدًا” أو قارئًا ” لطيفًا تجاه المؤلفين” – شيءٌ من هذا القبيل قد يساعدنا على إطلاق عنوان لهذه المناقشات المتباينة من مختلف المؤلفين ، ضمن إطار خطتي للتعامل برفق مع المحبة الغارقة بالتفاصيل في العديد من روائع الأدب الأوروبي. منذ مائة عام ، كتب “فلوبير” في رسالةٍ له إلى محبوبتِه ما نصه – كتبها بالفرنسية – :
” يا له من أديبٍ إذا كان يعرفُ جيّدًا ما في أقل من نصفِ دزينةٍ من الكتب!”
في القراءة ، ينبغي على المرءِ أن يُلاحظ وأن يداعب التفاصيل، إذ ليس من الخطأ أن تحتسي خمرة الفكرة العامة بعد أن تتناول بلطف قطع الترفل – التفاصيل الصغيرة – في الكتاب ، فإذا بدأ المرء بتصور مسبق، فإنه سيبتعد عن الكتاب حتما قبل أن يبدأ بفهمه.
ليس هنالك ما هو أكثرُ مللًا أو أكثرُ ظلمًا للمؤلف من البدء في القراءة – ولنقل مثلا رواية “مدام بوفاري”- بفكرة مسبقة إن العمل ضد البرجوازية. يجب أن نتذكر دائمًا أن العمل الفني هو خلقٌ لعالمٍ جديدٍ ، لذا فإن أوّل شيءٍ يتعيّن علينا القيام به هو دراسة هذا العالم الجديد عن قُرب بأكبر قدرٍ ممكن ، والتعامل معه على أنه شيءٌ جديد لا وجود لاتصالٍ واضحٍ بينه وبين العوالم التي نعرفها بالفعل مُسبقًا، فإذا ما تمّت دراسة هذا العالم الجديد عن كثب ، فعندئذٍ فقط دعونا ندرس صِلاته بالعوالم الأخرى ، و الفروع الأخرى للمعرفة.
سؤالٌ آخر : هل بإمكاننا أن نكتشف معلوماتٍ حول الأمكنة والأزمنة من خلال رواية؟ هل يُمكن لأيّ شخصٍ أن يكون ساذجًا إلى الحد الذي يجعله يتخيّل أنه يستطيع أن يتعلم أيّ شيء عن الماضي من تلك الكتب الأكثر مبيعًا والتي تدرجها أندية الكتب تحت مسمى روايات تاريخية؟ ماذا عن الأعمال الأدبية الرائعة ؟ هل يُمكن أن نعتمد على رؤية “جين أوستن” للإقطاعيين في إنجلترا والبارونات من مالكي المساحات الشاسعة في حين إن كل ما كانت تعرفه هي ردهة القديس؟ ورواية “بليك هاوس” ، ذلك العمل الرومانسي الرائع الذي تدور أحداثه في مدينة لندن الساحرة ، هل يمكننا أن نعتبرها دراسة شافية عن لندن قبل ما يقرب من مائة عام؟ بالتأكيد لا ، وينطبقُ ذلك على رواياتٍ أخرى مماثلة في نفس السلسلة. الحقيقةُ أن الروايات العظيمة هي حكاياتٌ خرافية ، والروايات في هذه السلسلة هي حكايات خرافية بامتياز.
الزمان و المكان ، ألوان الفصول ، حركات العضلات و العقول ، كل هذه الأشياء بالنسبة للكتّاب الذين يملكون حسا عبقريا ( بقدر ما نستطيع أن نخمّن ذلك وأنا واثقٌ بأننا نستطيع حقًّا) ليست مجرد مفاهيم تقليدية يمكن استعارتها من خزنة عامة في مكتبة صغيرة ، ولكنها سلسلةٌ من الدهشة التي أتقنها الأدباء الكبار وذلك حتى يقوموا بالتعبير بطريقتهم الفريدة.
بالنسبة للكتاب الصغار فإن الزخارف الكتابية تُركت لهم ، و هذه – الزخارف الكتابية – لا تُربك أيّة محاولة لإعادة اختراع للعالم ، فَهُم – أي الكُتاب الصغار – بكل بساطةٍ يحاولون إخراج أفضل ما لديهم بعيدا عن الرتابة أو الأنماط التقليدية للأدب القصصي. و قد تكون التراكيب المختلفة التي يُمكن أن يبدعها هؤلاء المؤلفون الصغار ضمن هذه الحدود الموضوعة، مسليّة تمامًا بطريقة عابرة ، لأن القرّاء البسطاء يحبّون أن يتعرّفوا على أفكارهم الخاصة خلف أقنعة ظريفة.
ولكنّ الكاتب الحقيقي، هو ذاك الرجل الذي يُرسل كواكبَ دوارة ، وهو الذي يخلق رجلاً نائمًا يعبث بأضلاعه بشغف ، ذلك النوع من المؤلفين لا يملك قيمًا مسبقة تحت تصرفه : لذا يجب عليه أن ينشأها بنفسه. إنّ فن الكتابة عملٌ غير مُجدٍ جدًّا إذا لم يفترض أولا وقبل كل شئ إن العالم هو مشروع تخيل.
قد تكون أشياء هذا العالم حقيقية بما فيه الكفاية (بقدرٍ ما يذهب إليه الواقع) ، ولكنها غير موجودة على أنها وحدة كلية : إنها فوضى ، ولهذا النوع من الفوضى يقول الكاتب “انطلقي” لكي يشتعل العالم و ينصهر. إنها -الأشياء- الآن تعيد تشكيل أشلائها الصغيرة ، وليس فقط أجزاءها المرئية والسطحية. و الكاتب هو أوّلُ رجلٍ يقوم بمسحها وتشكيل المفردات الطبيعية التي تحتوي عليها.
ستسمّى تلك البحيرة بين تلك الأشجار بحيرة “أوبال” ، ومن ناحية أكثر فنيّة بحيرة “ديشواتر” ، ذلك الضباب هو جبل ، وذلك الجبل يجب أن يُغزى ، و في أعلى طريقٍ منحدرٍ غير سالك ، يقفز الفنان الكبير ، وفي القمّة عند أوج الارتفاع العاصف ، بمن يلتقي برأيكم ؟ بالقارئ الرسّام السعيد ، وهناك يتحاضنان بعفوية ويرتبطان للأبد إذا استمر الكتاب للأبد.
في إحدى الليالي في كليّةٍ ريفيةٍ نائيةٍ كنتُ موجودًا خلالها ألقي محاضرةٍ طويلة ، اقترحتُ خلالها اختبارًا قصيرًا للطلبة مضمونهُ أن يجدوا عشرةَ تعريفاتٍ للقارئ ، ومن هؤلاء العشرة كان على الطلاب أن يختاروا أربعة تعريفاتٍ من شأنها أن تتحد لتكون التعريف الأمثل للقارئ. لقد أضعت القائمة ، ولكن التعريفات كانت شبية إلى حد ما بهذه ، اختر أربعة إجابات لسؤال تبين للقارئ ما يجب عليه فعله ليكون قارئا جيدا :
1- على القارئ أن ينتمي إلى نادٍ للكتاب.
2- على القارئ أن يجد ذاته في إحدى الشخصيات.
3- على القارئ أن يضع تركيزه على الزاوية الاجتماعية و الاقتصادية.
4- على القارئ أن يفضّل قصة مليئة بالأحداث والحوارات.
5- على القارئ أن يشاهد الكتاب في شكل فيلم.
6- على القارئ أن يكون كاتبا ناشئًا.
7- على القارئ أن يملك خيالاً.
8- على القارئ أن يملك ذاكرةً.
9- على القارئ أن يملك قاموسًا.
10- على القارئ أن يملك بعض الحسّ الفني.
الطلبة مالوا بحدّةٍ إلى التعريف العاطفي و الفعلي و الزاوية الاجتماعية والاقتصادية أو التاريخية، و بالطّبع كما توقعتَ أنت ، القارئ الجيّد هو ذلك الشخص الذي يملك خيالاً وذاكرةً وقاموسًا وبعض الحسّ الفني، وهو الحس الذي أنوي أن أطوّره في نفسي و في الآخرين كلما سنحت لي الفرصة لذلك.
بالمُناسبة ، استخدامي لكلمة قارئ فضفاضٌ جدًّا ، الغريب بما فيه الكفاية أن الشخص لا يستطيع أن يقرأ كتابًا وإنما يستطيع فقط بأن يُعيد قراءته. إن القارئ الجيّد و الكبير و النشيط والمبدع هو القارئ الذي يُعيد القراءة، و يتعيّن عليّ الآن أن أخبرك لم أعتقد بذلك ؟ عندما نقرأ كتابًا للمرة الأولى فإن المشقّة الكبرى هي عملية انتقال أعيننا من اليسار إلى اليمين ، من سطرٍ إلى آخر ، و من صفحةٍ إلى أخرى ، هذا الجهد الحركي المعقّد ،والذي يجعلنا نعرف ما يدور حوله الكتاب من حيث المكان والزمان ، و هذا – أي الجهد الحركي – يقف بيننا وبين التقدير الفني.
عندما ننظر في لوحةٍ لن نضطرّ إلى تحريكِ أعيننا بطريقةٍ خاصة ، حتى لو كانت الرسمة تحتوي على عناصر عميقة ومتطورة كما في الكتاب، إن عنصر الوقت لا يدخل حقًّا في أولِ اتصالٍ مع اللوحة ، إلا أننا عند قراءة كتابٍ ما، يجب أن نملك الوقت الكافي لإطلاعِ أنفسنا عليه. إننا لا نملك عضوًا ماديًّا (كما نملك العين بالنسبة للّوحة) يمكنه أن يُطلعنا على كافة الصورة ، ثم نستطيع أن نستمتع بتفاصيلها.
لكن في القراءةِ الثانية أو الثالثة أو حتى الرابعة فإننا نتصرف مع الكتاب كما نفعل تجاه اللوحة، ومع ذلك دعونا لا نخلط بين العين المجرّدة ، تلك التحفة الفضيعة بالعقل ، التحفةِ الأكثر فضاعة. الكتاب بغض النظر عن ماهيته، سواء عملٌ قصصي كان أم علميّ (الحد الفاصل بين الاثنين ليس بذاك الوضوح كما هو متعارف عليه بين العامة) الكتاب يُغري العقل أولاً ، فالعقل أي الدماغ أي الجزء العلوي من العمود الفقري هو الذي ينبغي أن يكون الأداةُ الوحيدة التي نتعامل بها مع الكتاب.
الآن ، إذا كان الأمر كذلك ، يجب أن نفكّر في السؤال : كيف يعمل العقل عندما يُواجه القارئ المتجهّم كتابا رائعا ؟ أولاً ، المزاج المتجهم سيذهب بعيدًا ،وبشكل أفضل أو أسوأ سيدخل القارئ في روح اللعبة. إن الجهد المبذول لبدء كتاب خاصةً إذا ما أشادَ به أشخاصٌ يعتبرهم القارئ الشاب متابعين جادين من الطراز القديم ، فإن هذا الجهد غالبًا ما يكون القيام به صعبًا ؛ ولكن بمجرد أن تقوم به ، تكون المكافآت متنوعة و وفيرة، وبما أن الفنان الكبير استخدم خياله في إنشاء كتابِه ، فمن الطبيعي والعادل أن يستخدم قارئ كتابه خياله أيضًا .
ومع ذلك ، هناك نوعان على الأقل من القراء المتخيلين، لذا دعنا نرى أيّهما الأصح عند قراءة كتابٍ ما. أولاً ، هناك النوع المتواضع نسبيًا الذي ينحو باتجاه المشاعر البسيطة والتي هي – أي المشاعر – ذات طبيعةٍ شخصيةٍ بالتأكيد (هناك العديد من التصنيفات التي تدرج تحت هذا النوع من القراءة العاطفية). قد يكون موضعًا ما في الكتاب شعوريًّا بشكلٍ حاد لأنه يذكّرنا بشيءٍ حدث لنا أو حدث لشخصٍ نعرفه. أو مرةً أخرى ، فإن القارئ يقدّر الكتاب بشكلٍ رئيسي لأنه يستحضر دولةً أو منظرًا طبيعيًّا أو نمط حياةٍ يتذكره بحنين باعتبارهِ جزءًا من ماضيه الشخصي . أو يرى القارئ ذاته في شخصيةٍ في الكتاب، و هذا هو أسوأ شيء يمكن أن يفعله القارئ، إن هذا النوع من الخيال البسيط المتدني ، ليس هو نوع الخيال الذي أودّ أن يستخدمه القرّاء.
إذن ، ما هي الأداة الأصلية التي سيستخدمها القارئ؟ الخيالُ غير الشخصي والمتعة الفنيّة ، والذي يمكن تأكيده في اعتقادي هو التوازن الفني المنسجم بين عقل القارئ وعقل المؤلف، إذ يجب أن نبقى بمعزلٍ قليلاً وأن نستمتع بهذه العزلة عند القراءة ، بينما نستمتع في نفس الوقت بشدةٍ و بشغفٍ و بدموع ٍ وقشعريرةٍ بالنسج الفني الداخلي للروائع ، فأن تكون قارئًا موضوعيًّا تمامًا في مثل هذه المواضيع ، أمر مستحيل بالطبع.
إن كل ما هو جديرٌ بالاهتمام هو ذاتيّ إلى حدٍ ما ، على سبيل المثال ، قد تكون أنت حُلمي وقد أكون أنا كابوسك، لكن ما أعنيهِ هو أن القارئ يجب أن يعرف متى وأين يكبح جماح خياله، ويستطيع أن يفعل هذا من خلال محاولة توضيح العالم المحدّد الذي يضعهُ المؤلف تحت تصرّفه. يجب أن نرى الأشياء ويجب أن نسمعها ، يجب علينا أن نتخيل ونتصوّر شكل الغرفِ والملابسِ وأخلاقيات شخصيات الكاتب ، مثلاً تعتبر ألوان عيون “فاني برايس” في “حديقة مانسفيلد” ، وتأثيث غرفتها الصغيرة الباردة تفاصيل مهمّة.
نحنُ جميعًا لدينا مزاجاتٍ مختلفة ، ويمكنني أن أخبرك الآن أن أفضل مزاجٍ يمكن أن يمتلكه القارئ أو أن يطوّره ، هو مزيجٌ من المزاج الفنيّ والعلميّ. فالفنان المتحمّس وحدهُ قادر على أن يكون شخصيًّا أكثر من اللازم في موقفِه تجاه الكتاب ، وبالتالي فإن البرود العلميّ الناتج عن الحكم سيعمل على تخفيف التوّهج البديهيّ لديه، ومع ذلك ، إذا كان القارئ المحتمَل مُجرّدا من الشغف والصبر – شغف الفنان وصبر العلماء – فإنه بالكاد يتمتع بالأدب العظيم.
الأدب لم يولد حينما صرخ الصبي مذعورًا “ذئبٌ ذئب !” وهو يعدو خائفًا من ذئبٍ رمادي في وادي نياندرال ، إنما وُلد الأدب في اليوم الذي كان فيه الصبي يصرخُ مذعورًا “ذئبٌ ذئب !” ولم يكن هنالك ذئب يجري خلفه بالفعل . أن يُصبح ذلك الصبي بين فكيّ وحش بسبب كذبِه المستمر لهو أمرٌ ليس ذو أهميةٍ البتّة، إنما الجانب المهم يكمن بين الذئب وهو بين الأعشاب الكثيفة في الواقع وبين الذئب وهو في القصة ذاتها ، بينهما ذلك الشيء المتلألئ كالمنشور وهو “الفن الأدبي”. (اسم القصة المذكورة : الفتى الذي ادّعى وجود ذئب ، لـ إيسوب).
الأدب هو اختراع ، والقصة تأتي من الخيال ، أن تُسمّي قصةً ما قصةٌ حقيقية يُعتبر إهانة لكل من الفن والحقيقة. و كل كاتب عظيم هو مخادع عظيم ، لكن هكذا هي طبيعة التضليل ، الطبيعة دائمًا مُضلِلة ، من التضليلِ بسيطِ الانتشار إلى الوهم أو الانخداع المتطوّر بشكلٍ خرافيّ بالألوان التي تحمي الفراشات أو الطيور مثلاً، و يوجد في الطبيعة نظامٌ رائعٌ من الحيل والفتن، لذا فإن كاتب الخيال يتّبع فقط إشارة الطبيعة.
وبالعودةِ للحظةٍ إلى صبي الغابة الذي ادّعى وجود ذئب ، ربما نسردها بهذه الطريقة : كان سحر الفن يكمن في ظل الذئب الذي اخترع عن قصد ، وأما حلم الصبي بالذئب ثم الحيل التي قصّها حوله صنعَا قصةً جيّدة، وعندما هلك الفتى في النهاية ، أعطت القصة حينها درسًا جيدًا في خلفيات النص ، و يبقى – أي الصبي – هو الساحر الصغير وهو المخترع للقصة.
هناك ثلاثُة أشكال نستطيع من خلال أن نرى الكاتب : يمكن أن نعتبرهُ راويًا أو معلّمًا أو ساحرًا، و الكاتب الكبير يجمع بين هؤلاء الثلاثة ، الراوي والمعلم والساحر ، لكنّ الساحر الذي بداخله هو السّمة السائدة و هو الذي يجعل منه كاتبًا كبيرًا.
نحن نبحث لدى القاصين عن الإثارة العقلية في أبسطِ صورها ، والمشاركة العاطفية و متعةِ السفر في بعض المناطق النائية في الزمان والمكان. إننا ليس بالضرورةِ أن نتّجه للمعلم فقط للتعليم الأخلاقي إنما أيضًا للمعرفة المباشرة ، وللحقائق البسيطة، وللأسف إنني أعرفُ أناسًا غايتهم من قراءة الرواياتِ الفرنسيةِ والروسيةِ هي معرفة بعض الأشياء عن الحياة في باريس و روسيا الحزينة. و أخيرًا وقبل كل شيء، الكاتب العظيم هو دائمًا ساحرٌ عظيم ، وهنا نأتي إلى الجزءِ المثيرِ حقًّا ، عندما نُحاول أن نستوعب السحرَ الذاتي لعبقريته ، و أن ندرس أسلوبه وتصويره الفني و نمط كتابته للروايات أو القصائد.
إن الجوانب الثلاثة للكاتب العظيم : ” السحر ، القصة ، الدرس” ، تميلُ إلى الاندماج في طابعٍ واحدٍ من التألق الموّحد والفريد ، حيث قد يكون سحر الفن موجودًا في هيكل القصة ذاتها ، و في لُب الفكر ذاته. وهناك روائعٌ للفكر الموضوعي والشفّاف والمنظّم الذي يُثير فينا الإحساس الفني بنفس قوّة روايةٍ مثل “حديقة مانسفيلد” أو أي إنتاجٍ غني بالصور الحسيّة لـ “تشارلز ديكنز” . يبدو لي أن الوصفة الجيّدة لاختبار جودة روايةٍ ما على المدى البعيد هي دمجُ الدّقة الشعرية و البديهة العلمية، ومن أجل أن يتمتع القارئ الحكيم بذلك السحر ، فعليه أن لا يقرأ كتاب الكاتب العبقري بقلبِه ولا بعقلِه و إنما بنخاعِه ، وعلى الرغم مما يحدث لنا من شعور، إلا أننا يجب أن نُبقي أنفسنا بمعزلٍ قليلاً ، بمعنى انفصالٍ قليل عند القراءة ، ثم بالمتعة الحسيّة والفكرية على حدٍّ سواء سنقوم بمشاهدة الفنان و هو يبني برجه من الورق ، ثم نرى أن البرج الورقي أصبح برجًا جميلاً من الفولاذ والزجاج.
بقلم: فلاديمير نابوكوڤ | المصدر