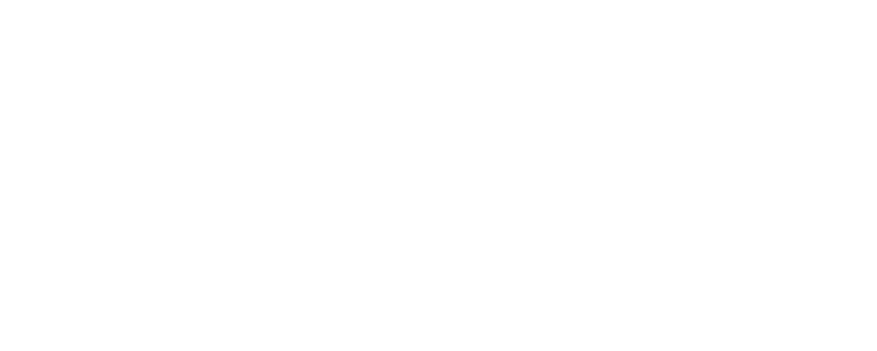المتنبئون بما بعد الحقيقة
تنبأتْ مرحلة ما بعد الحداثة بجحيمنا الذي يعقبُ إدراك الحقيقة. وما زال الجميع يمقتون ذلك.

كنتُ أتابع برنامج (مصادر موثوقة) على CNN منذ أسبوعين حينَ صُعقت بحوار بين المذيع برايان ستيلتر وأندرو مارانتز مؤلف كتاب الانطوائي – كتاب جديد عن التطرف الإلكتروني.
كانا يناقشان الروايات المفبركة عن الرئيس ترامب ولِما يصعب عليهم تجاوزها. وسيطول الجِدال طالما تنضوي وسائل الإعلام اليمينية تحت لوائه؛ تتحايل لصالحه وتحميه بل وتكذب لأجله. لم يعد واضحًا ما إذا كانت الحقائق مهمة بالفعل. “يركز الناس على ما وراء الحقائق، لكن ليس لها صلة بالقصص الملفقة على قناة Fox News، والكونغرس، والإنترنت.” قال مارانتز لستيلتير.
ليس بالجديد ألا تغدو تلك الحقائق مهمة. لكن الحاجة تستدعي ذلك في الوقت الحالي بما أننا نوجه إصبع اتهام سيؤدي بشكل حتميّ إلى نتيجة غير مرضية، إذ ليس من المرجّح أن تظهر إحدى الحقائق للعامة ويتقبلونها. يمكن “للحقائق البديلة”- وفقًا للصياغة الشهيرة لكيليان كونواي- أن تسود على الحقيقة في بيئة التواصل في القرن الواحد والعشرين أو أن تلغيها على أقل تقدير.

إن ما أذهلني حقًا فيما يتعلق بنقاش ستيلتر ومارانتز هو أن وجهتيْ نظرهما حول تبدد الحقائق وتعدد الروايات استُلهمتا من حركة فلسفية ظهرت منذ حوالي أربعة عقود ولكنها ما زالت تشعل فتيل العدمية في عصر ترامب إلى الآن.
تسمى هذه الحركة “ما بعد الحداثة” و بما أن ما خلّفته اختلط ببعضه فمن الجدير أن يسلّط عليها الضوء مجددا. ليس لـ”ـما بعد الحداثة” بُعدٌ واحد بل هي حشد من الأفكار والحركات الأدبية وحتى الطرز المعمارية. لكن ما يركز عليه منتقدو هذه الحركة هو هجومها المزعوم على فكرة الحقيقة المطلقة. أثار بعض مفكري ما بعد الحداثة البارزين صخبا لاحتفائهم بفكرة زعزعة الاستقرار؛ إذْ شرَّعوا بابًا للتشكيك بفكرة المعرفة الموضوعية ذاتها. ابتدع ما بعد الحداثيين مستقبل ما بعد الحقيقة حتى يُقِّر النقّاد بها.
ثمة حقائق معرضة للنقد. كانت نسخة ما بعد الحداثة التي شككت في الحقيقة الموضوعية وعززت النسبية رائجة بل ومحتَفى بها على النطاق الأكاديمي إبان الثمانينيات والتسعينيات، ولكن هل حقا ستدفعنا خربشات فلاسفة فرنسيين غير معروفين لتبني مثل تلك الأفكار في عصر ترامب؟
كانت التغييرات التي شكّلت لنا هذا العالم على الأرجح قائمة بالفعل عندما صدر كتاب جان فرانسوا ليوتارد (حالة ما بعد الحداثة) عام 1979 وهو الكتاب الذي صاغ هذا المصطلح. إنه لمن الأجدى والأفضل أن تُعرض أعمال ما بعد الحداثة لليوتارد وزملائه بعد أربعين عامًا كتفسير لعالم مُزّق بوسائل الإعلام والتكنولوجيا.
لم تمهد لنا ما بعد الحداثة طريق المعرفة نحو الواقع المرير\ ديستوبيا، لكنها كشفت في جوهرها عن أزمة كانت تتحضّر في ذلك الوقت حتى بلغت ذروتها في حاضرنا البائس.
ما بعد الحداثة وعدم استقرارها
لقد كانت ما بعد الحداثة كبش الفداء الذي نتعلل به على مدى عقود حتى الآن. إن النقد التقليدي لما بعد الحداثة نقد عدميّ ولاذع يتناهى إلى مسمعك من النقّاد من كل حدب وصوب.
تعمّق النقد في عصر ترامب، ليس العدميّ منه فحسب بل حتى مصدر ويلات عصرنا كما يقول النقّاد. يزعم الليبراليون أمثال ميتشيكو كاكوتاني – المسؤولة السابقة لقسم نقّاد الكتب في صحيفة نيويورك تايمز – بأن ما بعد الحداثة انبثقت من نطاق أكاديمي وامتدت نحو ثقافة ذات نطاق أوسع وهو ما قلل من قيمة الموضوعية. وهي تلقي اللوم فيما يخص كراهية الحقائق كلها على حد سواء في عصر ترامب على عاتق ما بعد الحداثة؛ لاعتقادها بأنها وطّدت فكرة أن لا “وجهة نظر” تعلو على أخرى.
يعتقد عالِم النفس والفيلسوف الشعبيّ جوردن بيترسون أن هوس ما بعد الحداثة بالتهميش والاستيلاء الثقافي تسببت بـ”أزمتنا” الحالية للصواب السياسي. كانت ما بعد الحداثة من بنات أفكار بعض من الأكاديميين اليساريين في السبعينات والثمانينات الذين زعموا أنه “نظرًا لوجود العديد من الطرق التي يمكن من خلالها تفسير العالم وتصوّره … لا يمكن الاعتداد بأي طريقة تفسير قانونيّة” كما وصفها بيترسون في مدونة.
وفقًا لبيترسون، فإن تشكيك ما بعد الحداثة في مسألة الحقيقة الحتمية أطلق العنان لتهديد الهويات السياسية، وجعل العرق والهوية جوهر الصراع على السلطة. ثمة ثغرات عدة لهذا المنطق لكن إذا سلّمت بنظرية بيترسون فإن خلاصته هذه واردة.
صرّح ستيفن بينكر -عالم نفس بجامعة هارفارد ومؤلف كتاب (التنوير الآن)- عن الشكوى الأكثر شيوعًا المتعلقة بما بعد الحداثة. فهو ينظر لها باعتبارها وهمًا متشعّبًا دمّر العلوم التقدمية. “يقول بينكر “لم تفق الإنسانية من نكبة ما بعد الحداثة بظلاميّتها التعجيزيّة ونسبيتها الداحضة لذاتها وصوابها السياسي الخانق.”
تهدد ما بعد الحداثة من منظور بينكر تقدم العلم (من خلال التشكيك في إمكانية الحقيقة الموضوعية) كما أنها حركة سامة للديموقراطيات الليبرالية حيث إنها تحل محل السعي وراء الحقيقة المشتركة بحرب الثقافة اليسارية على السلطة والهوية.
إن هذه الأنواع من المشاهد والتي هناك منها ما يكفي لملء مكتبة بأتمها، كلها مجتمعة تكنُّ حقدًا على مدرسة فلسفية يرونها تتباهى بكونها ضدَّ الحقيقة.
ماهيّة ما بعد الحداثة
لربما من الصعب الرد على منتقدي ما بعد الحداثة لأن المقصد من المصطلح غير واضح، أو على الأغلب لأنهم يهاجمون النسخة الهزلية منها.
وفقًا لما أوضحه آرون هانلون -أستاذ اللغة الإنجليزية في كلية كولبي- العام الفائت في عمود رائع على صحيفة واشنطن بوست فإن ما بعد الحداثة هي “سلسلة من الادعاءات المعترض عليها من قبل أشخاص مختلفين من تخصصات مختلفة، لا يمكن عدها فلسفة متجانسة حتى”. كما رفض العديد من الفلاسفة إلى حد كبير التسمية “ما بعد الحداثة” مفضلين تسمية مثل “ما بعد البنيوية” عوضا عنها.
لكن ما بعد الحداثة التي يعرفها أغلب الناس تمتد جذورها إلى مدرسة الفلسفة الفرنسية التي ظهرت في السبعينيات. كانت الفكرة الأساسية التي روج لها كتاب ليوتارد عام 1979 بعنوان (حالة ما بعد الحداثة )هي وصولنا في نهاية المطاف لما أسماه ليوتارد “السرديات الكبرى” وهو ما يشير إلى أنه ما من سرد مهيمن على العالم مثل الماركسية التاريخية أو بلا شك أي نظرية حاولت تفسير الحياة البشرية من حيث القيم الشاملة المطلقة.
لا يبدو أن هذه السرديات قد فسّرت الحياة من قبل ثم توقفت عن ذلك فجأة، حيث كانت وجهة نظره أن العالم أصبح متشعّبًا للغاية ومتعددًا لدعم شيئا مثل توافق الآراء الأخلاقية أو الاجتماعية. لا يمكن لأي من قصصنا التاريخية عن العدالة – بالنسبة لليوتارد كانت جميع العقائد قصصًا- أن تدّعي الرفعة على الآخرين.
إن كتاب ليوتارد هو أول عمل نزيه عن ما بعد الحداثة وربما لا يزال أوضح الأعمال وأوثقها صلة بهذا الموضوع. لم يقل ليوتارد –وليس بوسعي التأكيد على هذه المعلومة بشدة- أن الحقيقة الموضوعية كانت مستحيلة، بل زعم عوض ذلك أن ما يحدث للحقيقة في مجتمع ما بعد الصناعة هو على الأرجح انعكاسٌ لمن يمتلك السلطة، ونسيان ذلك يعد مخاطرة لأنْ يُتلاعَب به.
كان يدّعي هذا في ظل مجتمع يفتقر إلى الأساس لمشروع مشترك، وبدلًا من ذلك كنا “مجتمعًا مستهلكًا” مفككًا تكاد تحدده المصالح التجارية فحسب. كانت المؤسسات المكلفة باكتشاف الحقيقة – الحكومة ووسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية – رهينة لرأس المال بشكل مستمر.
اعتقد ليوتارد أن الرأسمالية والتغيرات التكنولوجية أدت إلى “تسويق” المعرفة، وهي طريقة ملطّفة لقول إن المعرفة أصبحت سلعة يمكن شراؤها وبيعها مثل أي شيء آخر. وأصر على أن كل هذا ستفاقمه الثورة الرقمية (على الرغم من أنه يفضل عبارة “الحوسبة”)، حتى أنه أشار إلى أن المعركة الكبرى في المستقبل ستكون حول من يسيطر على المعلومات.
كان ليوتارد متشائمًا جدًا فيما يتعلق بمصداقية العلم في ظل الرأسمالية، لكن كتابه ليس رفضًا للحقيقة إطلاقًا. جاء كتابه بمثابةِ تحذير وليس احتفاءً، حيث لم يكن دعوةً للعدمية ولا دفاعًا عن النسبية. بل كشف عن أزمة قائمة بالفعل، ولم تكن حجته تدور حول إمكانية الحقيقة إنما حول كيفية اعتبار ما نعدُّه صحيحًا غالبًا إنما هو انعكاسٌ لقوى ثقافية واقتصادية غير مرئية.
إن أحد الأسباب التي جعلت مرحلة ما بعد الحداثة تكتسب سمعة سيئة هو أن المنظرين الآخرين -أمثال جاك دريدا وميشيل فوكو وجاك لاكان وجميع الفلاسفة الفرنسيين الذين كتبوا قبل ليوتارد وبعده- دفعوا بالحركة إلى اتجاه مختلف يميل إلى النسبية، وأصبحت الكتابة ذاتها أكثر سوءًا وتعقيدًا.
وكما أخبرني هانلون، بمرور الزمن ظهر مفكرون مثل دريدا وفوكو وجوديث بتلر -الفيلسوف الأمريكي الشهير- ليمثلوا ما بعد الحداثة و “سرقوا الأضواء من تفسير ليوتارد وشوّهوا إرث هذا الكتاب.”
نحن ننغمس في المحتوى
أخذ جان بودريار – كاتب ما بعد الحداثي وأكاديمي فرنسي أيضًا – عمل ليوتارد على محمل الجد وأقحمه على العصر الرقمي. بدأ بودريارد مسيرته المهنية بدراسة تأثير الاستهلاك على الحياة اليومية، حيث اعتقد مثل ما اعتقده ليوتارد وهو أن ما بعد الحداثة عُرِفت على الأرجح من خلال “المجتمع الاستهلاكي”، كما شاطَر ليوتارد في وجهة نظره بأن وسائل الإعلام الجديدة ستصبح قوة مدمرة إلى حد كبير من شأنها أن “تسحق” سردياتنا الكبرى.
لكن بودرياد يركز بشكل استثنائي على وسائل الإعلام. نشر كتابه الأكثر شهرة “سيميولاكرا* والمحاكاة” عام 1981 حيث درس عواقب العيش في عالم يستند على الوساطة بشكل كبير. ذكر أن الفرد أصبح غارقًا في المحتوى والرموز والإعلانات – كما يسعنا أن نضيف إلى تلك القائمة المعلومات المضللة والنوافذ المنبثقة.
*سيميولاكرا: كلمة فرنسية تعني التظاهر.
كان بودريارد من أوائل فلاسفة ما بعد الحداثة الذين دقوا ناقوس الخطر بشأن الآثار السياسية لهذه التحولات. انشقّ عن نواميس الماركسيين مثله مثل الكثير من الحداثيين، لكنه سرعان ما أدرك بأن المقاومة السياسية في أواخر الحرب الباردة أخذت تزداد صعوبة. ظل المواطنون يتحولون إلى مستهلكين ويشاركون بفعاليّة في تهميشهم.
لابد أن نتذكر أن بودريارد كان يفكر في كل هذا مستحضرًا حجة ليوتارد حول نهاية السرديات الكبرى. إن انتصار الديمقراطية الليبرالية وانهيار النموذج السوفييتي في رأي بودريارد قد مهّد الطريق لسياسة استهلاكية عقيمة وحذّر من أن المستقبل سيتشكل من خلال الأسواق والعلامات التجارية والمشهد الإعلامي المتخم.
ينغمس التلفاز والإنترنت في الوقت الحالي بالنسبة لما بعد الحداثيين أمثال بودريارد في حياة الناس الشخصية. تعني المعركة المستمرة لجذب اهتمامنا أن بمقدورنا تجربة الواقع الذي نفضله كلما أردنا ذلك. الأسوأ هو أن المنصات الإعلامية تتنافس على كسب الجماهير وهو ما يشير إلى أن الدوافع ستجعلهم يزودون بأسوأ حوافزنا. بعد فترة سنصبح غارقين في محتوى من صُنعنا.
قام بودريارد بتعميم “سيميولاكرا” على العالم لوصف عدم الواقعية الذي يضعنا فيه. أشار جوناثان تشيت مؤخرًا أن تويتر نوع من التشابه أو simulacrum. اقضِ وقتًا طويلًا في استخدامه وستصبح صورة واقعك مشوهة على نحو متوقع. إنه لمن السهل الخلط بين المحتوى الذي تشاركه والعالم الحقيقي.
حذّر بودريارد منذ حوالي ثلاثة عقود من أن الادعاءات أصبحت واقعا وهي أكثر واقعية من الواقع الفعلي. وكان ذلك قبل أن يصبح من الممكن تصوّر وجود تويتر أو فيسبوك حتى.

قدم ما بعد الحداثي الأمريكي فريدريك جيمسون حججًا متشابهة جدًا في كتابه عام 1991(ما بعد الحداثة) أو (التناقضات الثقافية للرأسمالية المتأخرة)، حيث اعتقد جيمسون مثل بودريارد بأننا نشهد صعود “ثقافة جماهيرية” حيث تغير وسائل الإعلام والرأسمالية مواجهتنا للواقع. لم يكن جيمسون يفكر في “السرديات” بقدر تفكيره في آلية تدمير فكرة السوق للثقافة وطمسها للفروق التي تميّز الفن الرفيع من الوضيع، لكنّه ردد تحذيرات بودريارد حول فقدان الواقع المشترك.
يحافظ المفكرون من أمثال ليوتارد وبودريلارد وجيمسون على هذه المعرفة على نحو جيد، ولكن لا يمكن إنكار نمو نسبية ما بعد الحداثة. اعتبر العديد من ما بعد الحداثيين أن الحقيقة مبنية اجتماعيًا. على الرغم من أنه لم يزعم الجميع أن كل ادعاءات الحقيقة صحيحة، لكن ثمة من ادعى ذلك.
يصعب دحض هذا الجزء من نقد ما بعد الحداثة، مثلما أخبرني مايكل لينش فيلسوف في جامعة كونيتيكت، بأن لمرحلة ما بعد الحداثة نقاط قوة وضعف. يقول لينش: “إن الرؤية الجوهرية هي أن القوة بجميع صورها السيئة هي التي تحدد غالبًا ما يحدث للحقيقة في ثقافتنا وأن التجاهل هو ما يجعلك عرضة للاستغلال”.
لكن أضاف لينش أن الخطأ الفادح هو “الاستدلال بالحقيقة ذاتها التي حددها أصحاب السلطة، حيث أن هذا يدمر ما يوصلنا للحقيقة بالإضافة إلى الحقيقة نفسها، وهذا مجرد خطأ سياسي ومنطقي على حد سواء.”
إن لينش مُحقٌ بالطبع. أخذ بعض ما بعد الحداثيين هذه النظرة الثاقبة الأولية من ليوتارد – بأن السلطة غالبًا ما تفرض ما نسلّم به على أنه صحيحٌ – وعملوا على توسيع نطاقها لتشير إلى أنه لا توجد حقيقة على هذا النحو.
وبعبارة أخرى فإن ما بعد الحداثة مثلها مثل أي مجموعة فكرية حيث يعبّر عنها بالمفاهيم السيئة والادعاءات الباطلة والمفكرين غير ذي كفاءة. ولكن إذا نظرنا إلى ما هو أبعد من المبالغات وركزنا على الحقائق فإنها في الواقع تفسر كثيرًا مما نعيشه.
علاوة على ذلك فإن أي حجة تقول أن ما بعد الحداثة “الحقيقة المقتولة” تعني أن مجموعةً صغيرة من المنظرين (الفرنسيين في الغالب) الذين يكتبون كتبًا غامضة ومقالات صحفية غيروا العالم بطريقة ما، سيتعين عليهم القيام بتغييرات هيكلية في مجال المعلومات إذا تغير العالم – أي انفجار التكنولوجيا الرقمية – أكثر من أعمال ديريدا أو فوكو أو أي كاتب آخر.
لماذا أصبح يعنينا كل هذا اليوم
ربما لا تفسر ما بعد الحداثة كل شيء في حياتنا الحالية، لكنها تفسر قطعًا بعضًا منها – مثل مشكلة “السرد” التي أعرب كل من ستيلتر ومارانتز عن استيائهما منها على CNN
لم تكن الحقائق المنفصلة المتعلقة بما بعد الحداثة ذات قيمة بالنسبة لمعظم الناس. ما يهم حقًا هو السرديات التي اعتمدنا عليها لفهم كل تلك الحقائق. فكر في السرد على أنه جهاز لتوصيل النقاط وأنه طريقة لرسم مفصّل لإدراكنا للعالم. لم تكن عملية توصيل هذه النقاط في مأمن من التحيز أو التشويه.
لقد أوضح ما بعد الحداثيين فكرة بسيطة: جعل كل من التكنولوجيا والعولمة العالم أكثر تعقيدًا بصورة لا نهائية وهو ما يعني وجود المزيد من المعلومات لكي تتم معالجتها والمزيد من النقاط لتوصل ببعضها. وإحدى طرق إدارة هذه الفوضى هي الاعتماد أكثر على السرديات التي تجرد العالم من تعقيده – وغالبًا ما تعزز في الوقت ذاته تحيزاتنا.
ومن هذا المنطلق، فإنه ليس جديدًا إطلاقًا أن يختلق الناس سرديات لا تمت للحقيقة بصلة عن العالم حولهم، إنما الجديد هو ما حذّر منه ما بعد الحداثيين منذ عقود؛ أيْ حجم السرديات وانتشار تقنيات الإعلام المصممة لإشباع وعينا بأكبر قدر ممكن من المحتوى. لقد غير هذا الأمر الوضع، ومثلما يقول ليوتارد فقد “دمر” إدراكنا للواقع.
باختصار تنبأ أفضل مفكري ما بعد الحداثة بمآلنا كمجتمع. يمكنهم أن يلاحظوا كيف أن الابتكارات في التكنولوجيا والرأسمالية ووسائل الإعلام تشوه إحساسنا المشترك بالحقيقة. ولم يكن أي منهم – ولا حتى الأكثر تشاؤماً – يتخيل الفوضى المعرفية التي تطلقها خوارزميات الفيسبوك أو اليوتيوب.
نحن في الوقت الراهن “صانعو عوالمنا.” مثلما حدّثني الفيلسوف توماس دي زنغوتيتا، لقد جمعنا بين صبيانية الثقافة التليفزيونية وتمحور الثقافة الرقمية على الذات، والنتيجة هي الانتصار التام لذات الوساطة، حيث يمكن للجميع إنشاء وتأدية وتأكيد هويتهم وحقيقتهم، وسيُلزمهم السوق بكل خطوة.
كتب دي زنغوتيتا في عام 2005 “وهذه التكنولوجيا برمتها بدأت للتو.” تغدو تقنيات الإعلام التي تحدد عوالمنا أكثر تعقيدًا وتأثيرًا كل يوم، وكل هذا يعني أن الأزمة التي أشير إليها من قبل ما بعد الحداثة ستتعمق.
لكن على أقل تقدير ثمة أهمية لفهم كيف وصلنا إلى هنا ولمَ لا يمكننا التراجع.
بقلم: مارتن بودري | ترجمة: جُهينة اليعربي | تدقيق: آلاء الراشدي | المصدر