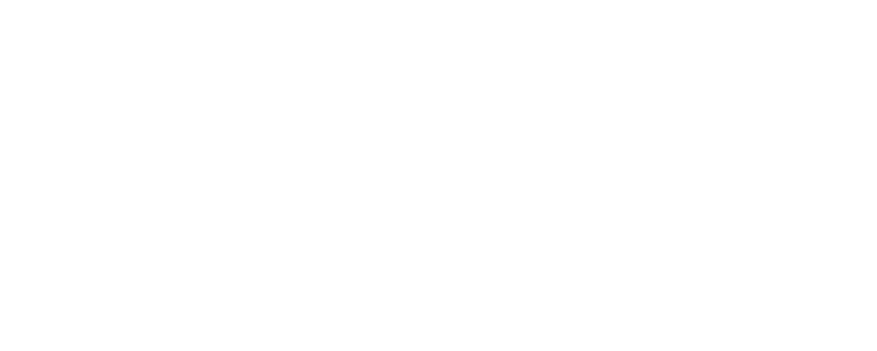ما العُزلة إلا شجاعة

في إحدى نزهاتي اليومية مع ابنتي، وقعت أعيننا على واقع جديد كلياً. أخبرتني الصغيرة أن أنابيل، دميتها المُفضلة، ربما قد تكون مصابة بڤيروس كورونا المستجد. لا تعلم تحديداً هل هو السكري أم ڤيروس كورونا. أعراضها تختلف، لكنها لم تحركها من سريرها الصغير والتي وضعته بجانبها منذ أيام. سمحت لي ابنتي بمجالسة انابيل شريطة أن أمسك يدها بحنان، وألا أقدم لها أي حلوى. أصبح الحديث عن مرض الدمية الشاغل الرئيسي في نزهاتنا اليومية، تتحدث ابنتي عنها وهي تمسك يدي بإحكام وتترقب الوقت الذي يمكن لأنابيل أن تخضع فيه للفحص الطبي.
سألتها إن كانت قلقة بشأن أنابيل، لكنها تجيب بالرفض دائماً. تظن أنها ستتحسن وربما تحصل على حقنة. الأيام بدت تصبح أطول والنزهات كذلك مع بداية فصل الربيع وذوبان الثلج، وحوارنا أصبح أكثر تعقيداً، مثل خرطوم الحديقة ما ينفك أن يلتف حول نفسه و يتكدس..
بالإضافة لحوارنا الأساسي عن وضع أنابيل الصحي، تحدثنا عن أحجار الكريستال والأخوات الافتراضيات لابنتي ( إذ تلعب هي دور الأخت الكبرى بينهن ). كانت تسرد لي القصص عن أختها الحامل والأخرى التي تتجول في أنحاء أوروبا، بينما هي نفسها متزوجة وزوجها رجل جيد لكنه غادر هذا الصباح بالطائرة لفلوريدا. كما يبدو هو صحفي في السانيبل. جمعنا بعض الحجارة ووضعناها في جيوبنا، وأعلم أنه في وقت لاحق من النزهة، سأضطر لأستغني عن قبعتي لتصبح كيسا لتحمل فيه جميع كنوزها، وسيتحول جيبي لحفرة تراب .
وفي وقت لاحق من النزهة، أخبرتها بمرض جدها بالسرطان. وفي محاولة لتهدئة وطء الصدمة عليها، سعيت لأوضح لها أن هذا أفضل نوع من السرطان يمكن تمنيه، شكل من أشكال سرطان الدم غير النشط. تهز رأسها الآن كما هززتُ رأسي لها من قبل.
نمشي في طريق تتناثر حوله نشارة الخشب، وأشجار البلوط المتساقطة جراء الإعصار الذي اجتاح كونتيكت في مايو عام 2018 تحاذينا من الجانبين. ذلك الربيع، أتيت لذات المكان وجلست على أشجار محطمة، العديد من الجذوع اُقتلعت من فوق الأرض بمسافة ثمانية لعشرة أقدام على هيئة نخيل متناثرة، بينما تتكدس كومة أخرى من الأشجار، تاركة فجوات كصورة تُخلد آثار تلك الكارثة، كثقب مفتاح في عالم محطم. المنطقة الآن تبدو خاوية على عروشها وتغمرها الشمس من كل جانب.
بينما كنا نمشي، ذكرت ابنتي بأننا يجب أن نتحرك بسرعة أكبر. بقدر سرعتها في الكلام، تتباطأ في الحركة. حاولت الإنصات لها، لكن جزءًا من عقلي يفكر بأشياء أخرى. إذ بقيت صامتة لفترة طويلة، تسحب يدي لتعيدني للمحادثة. كان من الصعب التركيز على الواقع معها وواقع الطبيعة في آن واحد، حيث كلاهما يتنافسان للفوز بانتباهي.
على حين غرة، تذكرت مقال جيمس ويليام “عمى معين في كيان الإنسان”. حيث كتب عن صعوبة بقاء الإنسان في حياة إنسان آخر. يستخدم جيمس قصة روبرت لويس ستيفنسون عن فتيان صغار يأسسون ناديًا سريًّا أطلقوا عليه اسم “حاملو الفوانيس”. كانوا يخبئون الفوانيس من الصفيح تحت معاطفهم الثقيلة كشعار سري للنادي. من الخارج، يظهر الفتيان كالآخرين يهرولون في الليالي الباردة. لكن عندما يقابلون بعضهم البعض، يرفعون حاشية معاطفهم ليشع الضوء وكأنهم يتوهجون ضياءً. لطالما أحببت صورة الأطفال الذي يخفون نارا، تشع وجوههم لحظياً في ضوء الفانوس، مبتهجين بولائهم للنادي.
كتب جيمس عن صعوبة رؤية النور الداخلي للآخرين _ الشيء الذي يجعلهم يضيئون في أحلك الأوقات وتحديدا حين نركز فقط على حياتنا الخاصة. نمر بجانب بعضنا البعض، منكبين على أنفسنا ومشاكلنا الخاصة، غير قادرين على تخيل نار تشتعل تحت المعاطف المعتمة.
كنت أفكر بشأن جيمس، وتذكرت زياتي لإيطاليا الصيف الماضي. في وادي اسيسي، شاهدت الأضواء تتراقص كنقاط بينما تلوح الشمس للأفق، كانت اشبه بسجادة نجوم تفترش الأرض. حينها حاولت استرجاع مقال كتبه الفيلسوف إيمانويل ليفنس بعد المحرقة، شيء عن صعوبة تعليم الأطفال المولودين بعد الحرب الدروس التي يحتاجون لتعلمها، بالأخص، القوة الضرورية للنجاة في العزلة. أود لو أمسك النص وأقرأه مجددا. كتب بالفرنسية وأطلق عليه “بلا اسم” في الترجمة الإنجليزية.
نصعد فوق تلة صغيرة، فجأة تجلس ابنتي. كانت جائعة، متعبة ولا تريد المشي مجددا. جلست بجانبها، أظل أتساءل حول ما قاله ليفنس. لقد كان عن الشجاعة الضرورية لتكون وحيدا، عن وعي هش وأهمية الحياة الداخلية. نعم، هذا هو.
الفوانيس المضيئة تحت معاطف الفتية الصغار، الحجارة في جيوبنا، الحياة الداخلية التي لا يمكن رؤيتها أو تخمينها أو معرفتها من الخارج، وهكذا لا يمكن تمييزها بسهولة أو أخذها. الحياة الخاصة التي جعلت ليفنس حيا بعد أن تم أسره من قبل النازيين وأُرسل إلى مخيمات السجن في فرنسا عام 1940، وعندما تم سحبه قسراً عن زوجته وابنته وعن العالم. شيء سري يتمسك به، لا يهلك أو يتصدع أو يهوي أرضاً، كان أقرب لأن يكون جوهر الحياة.
بينما كنا نجلس على حافة الطريق، ونحن نرقب الثلج يتلألأ، أفكر بأولئك الناس في الجانب الآخر من الكوكب يموتون بمفردهم في الخارج، أو في غرفة مغلقة، يصارعون ذواتهم ويشعلون نيرانهم الخاصة. يعود الثلج ليتساقط مرة أخرى بغزارة والأرض تلبس الرداء الأبيض بالنرجس البري، الضيف الذي جاء قبل موعده هذا العام. ربما نرى نبتة اللفت الهندي لاحقا، وكم يتوق قلبي لرؤية البراعم الخضراء والبنفسجية تلتف حول الطلع الأبيض الصغير، تختبأ هناك مبشرة بربيع مبهج! كل شيء هادئ في الغابة ما عدا جلبة قادمة من نقار خشب في مكان قريب. كاستجابة للإيقاع تتردد على مسمعي أغنية، تربط معا كل أشلاء روحي المُبعثرة. تستوطن عقلي أغنية شهيرة لنيك دراك “سبتمبر 67 ” مرة قلت أنني فانوس……الشمس غابت…. والجميع ذهبوا لمنازلهم، كُنت بجانب الطريق وحيدا، ألتفت في كل الاتجاهات لأحظى بانتباه أحدهم، هذه المرة بلا جواب.” ثم يتردد مقطع من أغنية لليونارد كوهين: “تشبث، تشبث يا أخي وأختي، ها أنا ذا أستسلم، أمضي بدون هُدى من الصباح وحتى المساء، متجاوزا حدود حياتي السرية.”
حين كنت أهمهم بغير قصد سمعتها تقول ” أمي توقفي.”
نمشي مجددا، والبرد يزاحم وجهينا، لنهرع للمنزل. تبدأ مرة أخرى بحديث آخر عن دميتها زوي، ستقيم حفل ميلاد لاحقاً وأنا مدعوة. أنابيل أضعف من أن تلبي الدعوة. نتحدث عن الزينة والكعكة، ونحن نهرول بسرعة كسباق ضد البرد نناقش أسماء المدعوين والألعاب، نهبط على التل والهواء البارد يوجه صفعات على خدينا. أجيب ببساطة كأنه حدث مهم، هذا ما أستطيع القيام به. إنه عالمها وتلك هي أضواؤها الصغيرة، أطفالها في أسرتهم، الحجارة والكريستال في قبضتها، كلها مهمة وواقعية بشكل مخيف بينما ينهار العالم من حولنا.
يوما ما، حين تجد نفسها والعزلة رفيقتها. حينها، يمكن أن تغرق في خيالاتها وأغانيها، وبعض الشجاعة التي اكتسبتها من هذه النزهات والتخيلات اللانهائية والتي تساوي أي فلسفة. سيصبح إيقاع الكلمات، ووقع خطو الأقدام محفوراً في ذاكرتها لتعيده، بينما يتردد وقع أصداء أصوات الكائنات في أذنيها، ودفء قبضة يدي لن يبارحها. فجأة أفلتت قبضة يدي وانطلقت نحو المنزل. برفقتها، أنا وهي في رحلة تعلّم لا تنتهي في معنى أن نقدس وحدتنا وعالمنا الخاص.
بقلم: ميغان كريغ | ترجمة: حفصة الحسن | تدقيق: مريم الغافري | المصدر