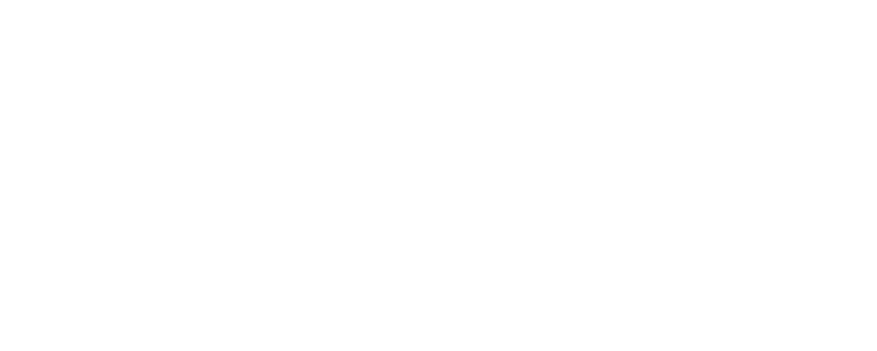اجعل من الكتابة الفلسفية بريدًا شخصيًا

في ذكرى ستانلي كاڤيل (2018-1926)
أتيتُ إلى عالم الفلسفة مليئًا بأشياء لأقولها. وفي مكانٍ ما على طريق رحلتي، تغيّر ذلك. ليس لأنني توقفتُ عن الكلام أو الكتابة مع مرور الوقت، وإنما لأن طابع الفلسفة و أسلوبها قد تغير. شعرت أنني مسؤولٌ، ليس فقط عن نفسي أو عن الذين أعرفهم شخصيًا، وإنما عن محيط أوسع من ذلك، عن بعض الـ “أنت” بشكل غير محدود . و قد تحوّلت عبارة “أجب عنها بنفسك” إلى “تعرّف إلى ذاتك”.
كيف يمكن لشخصٍ ما أن يُدخِل تغييرًا رئيسيًّا على طريقة الكتابة إذا كانت الفلسفة مرتبطة جزئيًّا بحس الشعور بالمسؤولية؟ ألا يجب أن تحمل طابع الرسائل أكثر؟ ” يا عزيزي، ها هو المكان الذي أقف فيه، في الوقت الحالي … مع تحياتي، أنا” . فيُغامر المرء بأفكاره، ويفسّرها ويترقّب الرّد، من أجل أن يبدأ مرة أخرى بالمراسلة: “عزيزي ، أشكرك على ردّك. لقد تغير الكثير (أو القليل جدًّا) منذ أن تلقيت رسالتك … ” .
يبدو لي أن التحرك بطابع وأسلوب كتابة الرسالة مناسب على الأقل للفلسفة. ربما ما تزال الطريقة غير مؤثرة، ولكن الأمر يحتاج إلى الممارسة المستمرة لخلق التأثير، حتى مع ضعف القيام بذلك من قَبل حتى فيما يتعلق بالآخرين. ولكن إلى أي مدى يمكن للفلسفة أن تخلق شعورَ ووقْعَ الرسالة؟ وهل عندما نتحدث بحكمة وتفلسف نكون مدركين بتنوع أولئك الذين نراسلهم وحالاتهم المختلفة عند قراءتهم للرسالة؟ إن وجهة النظر التي لا أصل لها، أي التي لم ترد من مكان ما، قد تم نفيها تقريبًا من نظرية المعرفة. فنحن نعلم أننا نعرف المواضع الملموسة المحددة الثابتة . ولكن هل واكبت الكتابة الفلسفية وطوّرت ما يجب مراعاته عند التأمل في سؤال: كيف أكتب؟
تاريخ الدراسة الفلسفية له طابع معقد. والكتابة الفلسفية لها شأن متنوع. حيث تعطي بعض النصوص الأولوية للتوضيح أو البرهنة، على سبيل المثال أن “الحقيقة” تصنع وصلة بين المعتقدات والعالم. وبعضها الآخر يفضل الإثارة أو التحدي، كما هو الحال عند مناقشة طبيعة الصداقة قبل التوصل إلى تعريف فعلي. فإذا أردنا تعريفًا، نحتاج إلى إنشاء تعريف خاص بنا أو التفكير مليًّا في معنى عدم وجود تعريف . وهناك نصوص أخرى توضح من خلال الأمثلة ، كما فعلت سيمون دي بوفوار في “الجنس الآخر” عام 1949، حيث كانت تحاول إثبات أنها مصدر ذكاء، مع إصرار المجتمع الأبوي على أنها ليست كذلك. من خلال الرجوع إلى تاريخ المرأة وبيان مدى ظلم وفساد هذا الماضي، وتُبين لنا ما حَرَمنا منه النظام الأبوي.
تزيد الاعتبارات الخاصة بالنوع الأدبي التساؤل حول ماهية قالب الكتابة الفلسفية فهي تشمل: الحوار والأطروحة والحكم والمقال المتخصص والمقال الأكاديمي أو المهني والأفرودة والفقرة و السيرة الذاتية. وإذا كانت مكانة إحساس المرء بالمسؤولية أكثر شمولية، فقد تصبح الرسائل والبيانات والمقابلات خيارات ممكنة ومتاحة كذلك. لا يوجد نوع أدبي محبوك بالكامل، لذا من الضروري أيضًا التفكير في العمليات أو الممارسات المنطقية والبلاغية: أساليب الاستنتاج والسخرية والنقاشات الوجودية والمجاز والصور والمقارنات والأمثلة والاقتباسات والترجمة، وحتى النبرة تُعد طريقة مميزة لوصول المعنى للقارئ. يبدو أن هناك الكثير من الأمور التي ينبغي وضعها في الحسبان عندما نجيب عن سؤال كيفية الكتابة.
تنشأ الأسئلة المتعلقة بالكتابة أحيانًا عندما يقلق الفلاسفة حول إمكانية وصولهم للقراء، ومقدرتهم على تكوين قاعدة جماهيرية واسعة منهم. لكن الاحتمالات التي أحصيتُها ترتبط بشكل مباشر على فكر الفيلسوف نفسه. إن الكتابة تولّد الاكتشاف، وأُسلوب الكتابة ليس قالبًا لنقل الأفكار فقط، وإنما يُعد مؤثرًا في تلك الاكتشافات والعمليات المنطقية البلاغية. لقد مال فرانسيس بيكون إلى استخدام أسلوب الحِكم لأنها تُحرر التأمل من العادات المدرسية، في حين أن المقالة الأكاديمية تحيلها إلى اللغة المشتركة والسائدة فيها. إننا نستطيع من خلال الأطروحة أن نتناول كل ما يمكن قوله عن موضوع ما بكافة جوانبه – وهو ما نسمّيه النظرة من كل مكان – في حين يقبل المقال المتخصص بتخصصه ويختبر مدى انتشاره نسبةً إلى موضوعات معينة مثل الصداقة أو الجنس الأنثوي أو حتى الولع بالأفلام. عندما تصبح الكتابة هي السؤال، فإن الكثير من الأمور تدعو لأخذها في الاعتبار غير الانتشار.
إليكَ نقطة انطلاقة، كيف ستتضّح أفكاري من خلال هذا الأسلوب وهذه العمليات المنطقية البلاغية؟ إلى أين ستأخذني الحكمة أو المقالة أو المقال الأكاديمي وحتى تبادل الرسائل؟ والسؤال ينطبق كذلك على النقاشات والاقتباس وأعمال الترجمة أو السخرية في ذلك الأمر. إن السخرية مجازٌ شهيرٌ من المفاجأة والتورية، لكن قدرًا مناسبًا منها يُعين الشخص الساخر على صون النفس على الأقل. القارئ هو الذي سيتفاجأ بمواجهة بعض المعاني الخفية بينما تستقر المعاني الظاهرة والخفيّة للكاتب على حدٍّ سواء. (لذا أتساءل: ما الذي تُبقيه السخرية في أمان؟).
الأسئلة التي تتعلق بإمكانيات التشريع لا يمكن الإجابة عليها من خلال النقد، والذي بحسب إيمانويل كانط، يستجوب طبيعة أحكامنا ومبادئنا بحثًا عن قواعد تمكننا من مراقبة استخدامنا لها. إن الاكتشافات التي تسببها الكتابة هي دليل على أن الفلسفة متصلة بشكلٍ وثيق للغاية باللغة اتصال الحصان بعجلات عربة سائقها. إن الكتابة مقامرة، وعندما تكون صادقة وصريحة، يواجه المرء نتائج غير متوقعة.
في مواجهةٍ لصفحةٍ فارغة، قد يسأل المرء أيضًا: ما العلاقات التي سيكوّنها ما أكتبهُ مع من أخاطبهم؟ فالجداليّ يريد تحويل الوجهة وتغيير الرأي، وذلك يكون على حساب الاكتشاف. وحتى عندما يتم تجنب الجدليّ منهم، يقرأ البعض أعمال مُعارضيهم باختزالٍ تامٍ بدلاً من قراءتهم علنًا وبعناية، وبناءً على ذلك يتحاورون مع من تحوّل عن أفكاره ما لا يرضَون من الحوار، وذلك يبدو تصرفًا مغلوطًا.
قد يُفضّل المرء اللجوء إلى الإثارة مُبتعدًا عن اتباعِ منهج عقائدي في كتاباته، كما يرى البعض أفلاطون مثالاً لذلك . لكن لكل إثارةٍ متطلباتها الخاصة، لعل أولها النهاية التي يحثُّ القارئ إليها. إن سقراط هو مثال على هذا النوع من المحاورين، و جايوس لايلوس مثال آخر، وذلك لأن أفلاطون وسيشرو يطرحان التعليم والروح وحالات كل منهما بشكل مختلف. وبالتالي فإن التمييز الصارم بين الإثارة والمعتقَد الذي يتبعهُ المرء (أو الأسلوب والمحتوى في هذه الحالة) هو أمرٌ لا يمكن تحقيقه.
كما أن للأساليب الأخرى قدرة فعالة على إشراك المخاطبين. حيث تسمح الأمثلة للقراء مراجعة ما هو معروض، وهو أمر أصبح ممكنًا أيضًا عند استعراض خلافات ذات مغزى. (عندما لا يتوقف المؤلفون أبدًا عن تصور إمكانية حدوث اعتراض ما، أشعر بالرهاب وأركض لفتح النافذة). وإذا بدأ المرء في إدراك مدى تنوع المخاطبين، لأصبحت هناك عادات كتابية أخرى بارزة. وبالرجوع إلى كتاباتي السابقة، أرى أنني قد كتبت نصوصًا تشير إلى ” الجنس الأبيض فقط” أو “على النساء أن لا تُشارك”.
ومع ذلك، فإن النصوص والقرّاء لا يجتمعون في فراغ. لذلك أتساءل: كيف يمكن لكاتبٍ ما أن يتعامل مع القوى السياقية السائدة، بدءًا من القوميات العرقية إلى القول بسيادة الجنس الأبيض وتسليع التعليم العالي؟ من المُغري تخيل نص بدون حواشٍ كما لو أنها زينة ، لكن في زمنٍ ينفر من صرامة المعرفة والفهم، ويُعادي تاريخ ما لدينا من حقائق، فلماذا لا نؤكد على مبدأ التنازُع على تاريخ الفِكر، مع الإصرار على أن الفِكر هو مجهودٌ نتائجه هشّة والاختلاف فيه وارد . يَطرح الوضوح على الفلسفة سؤالاً لا تُجيبه التجارب، وإنما تكون الإجابةُ صحيحةً أو خاطئة وفقًا لطَريقة عَرضها. علاوة على ذلك، فإن الاستنتاجات الفلسفية لا تظل فلسفية إذا حادت عن الطريق المؤدي إليها. فقول عبارة أن “الله موجود” معناها في الصلاة مختلف عما تعنيه في الاستدلال المَنطقي. غالبًا ما يُطلب من المتخصصين عرض استنتاجاتهم دون إظهار الطريق المؤدي إليها، لكن في الحقيقة أن ذلك العرض هو عملٌ فلسفي في حد ذاته. فهل يمكن للمرء أن يعرض نتائجه دون الطريق ليتجاوز بذلك ما هو أوسع من نطاق الأكاديمية؟
يعرفُ كل قارئ لأفلاطون أن سقراط -من خلال التمثيل- هو صورة للفلسفة، بدءًا من أساليب استجوابه إلى من يستهدف باستجوابه إلى تذكيره بأن الفلسفة تتطلب شجاعة. وكذلك الحوار نفسه – هو نموذج للفلسفة. لكن كل نص يصرّح: الفلسفة هنا أيضًا. وبالتالي فإن التأمل العام لكتابة المرء يستحق الإمعان فيها. هل تمهلتُ في الكتابة أم تسرعت؟ هل توصّلت كتابتي إلى “نتائجها”؟ أو هل بعد أن قضيتُ على الخصم مُستعينًا بثغراته الدقيقة،تستحق كتابتي إعجاب الناس غير المصطنع؟ هل تعترف بالنطاق المتعدد للمخاطبين المحتملين أم تحصر نفسها داخل الطيات الضيقة من التفكير المماثل؟ هل تتحدى الكتابة نقاط انطلاقها أم تغطي على جوانبها المقتطعة مستعينةً بالمصطلحات والتعميمات الضخمة؟
مستلهمًا من لودفيج فيتجنشتاين، أودّ القول أن الفلسفة قد ضلَّت طريقها مع الكتابة. وما تعرفه – المقال الأكاديمي والأفرودة – فيكتب من أجل التوافق لا من أجل التفكير الفلسفي والإخلاص. لا يشمل ذلك الجميع، وقد سلك الكثير وجهتهم إلى أماكن أخرى وفقًا لذلك. لكن إذا نظرتَ إلى الأمر بأكمله عن قرب وتفكرت في حياة الكاتب في الوقت الحالي، لوجدتها ساكنةً دون تمحيص في السياق الطَموح للفلسفة.
لقد اقترحتُ أربعة أسئلة توجيهية بالنظر إلى مجموعة من أنواعِ الكتابة والمُمارسات المَنطقية البلاغية: كيف ستتشكل فكرتي في هذا النص؟ ما العَلاقات التي ستنشأ من كتاباتي مع المُخاطَبين المُختلفين؟ وكما كان سيسأل “والتر بنيامين، هل تستطيع مخاطبَتي أن تُبحر في الأحوال المُختلفة والمُتنوعة لحياتنا وأن تكون “مواكبًة للحظة” ؟ وأخيرًا، ما الذي يمثلهُ نصّي باسم الفلسفة؟ هل عرضتُ صورة جذابة؟ “عزيزي، هنا حيث أقف في الوقت الحالي… تحياتي، أنا”.
بقلم: جون لايسكر | ترجمة: موزة الريامية | تدقيق: روان البداعية | المصدر