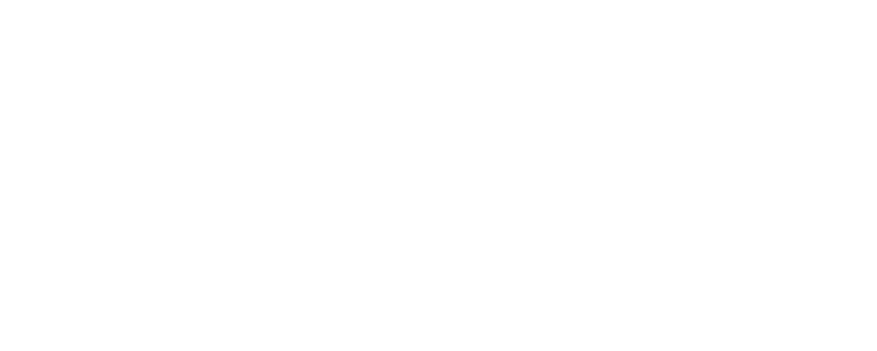كيف تجعلنا شبكات التواصل الاجتماعي نسخا أسوأ من أنفسنا؟

في مساء السابع عشر من فبراير عام 2018، غرَّدت الأستاذة ماري بيرد على تويتر بصورة لها وهي تبكي، الكلاسيكية البارزة في جامعة كامبريدج والتي يتابعها قرابة 200,000 متابع على تويتر، اضطربت بعد تعرضها لموجة تنمر إلكتروني إثر كتابتها تعليقًا عن دولة هايتي. وغردت أيضًا: “إني أحدثكم بما في قرارة نفسي (وقد أكون مخطئة بالطبع)، لكن ردة الفعل التي أتلقاها على ذلك فظيعة، فظيعة جدًّا”.
وعقب أيام من ذلك، تلقت بيرد الدعم من العديد من الأشخاص المعروفين، غرَّد زميلها جريج جينر وهو مؤرخ شهير عن تجربة مماثلة: “دائمًا أتذكر كيف كان الأمر صادمًا أن تصبح محل كُره الغرباء فجأة، وبغضِّ النظر عن النظرة الأخلاقية، وقد أكون مصيبًا أو مخطئًا في رأيي، لكنني ذُهِلت (لاحقًا حين استرجعت نفسي) من التحطيمِ النفسي الذي ألمَّ بي”.
وحتى هؤلاء الذين دعموا بيرد – سواء كانوا متفقين مع تغريدتها الأولى التي عرضتها للردود المتنمرة – استُهدِفوا أيضًا، وحتى زميلتها بريامافادا غوبال – وهي أكاديمية في جامعة كامبريدج من أصول آسيوية – والتي كانت ممن انتقدوا بيرد، تعرضت لسيل عارم من التنمر عندما ردت على تغريدة بيرد.
ثمة أدلة قاطعة على أن النساء والأقليَّات العرقية هم الأكثر تعرضًا للتنمر في تويتر. ويصبح التنمر أكثر قسوة إن تقاطعت علامات الهوية هذه؛ ومثال على ذلك التجربة التي خاضتها النائبة ذات البشرة السوداء ديانا آبوت، والتي تلقت لوحدها قرابة نصف التغريدات المسيئة من بين كل التغريدات المسيئة التي تلقتها النائبات خلال الفترة التي تسبق الانتخابات العامة في المملكة المتحدة. تعرضت النائبات ذوات البشرة السوداء والآسيويات للتنمر الإلكتروني أكثر بنسبة 35٪ من النائبات الأخريات ذوات البشرة البيضاء؛ حتى بعد إخراج أبوت من الحسبة.

يؤدي هذا الوابل المستمر من التنمر، بما في ذلك التهديد بالقتل، أو الوعيد بالعنف الجنسي، إلى إخراس الناس، ودفعهم إلى الابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي؛ وبالتالي تقليل اختلاف الآراء فيها. أشارت دراسة أجريت العام المنصرم إلى أن 40٪ من الأميركيين البالغين قد تعرضوا شخصيًّا للتنمر الإلكتروني، وقرابة النصف منهم تعرَّضوا لأشكال قاسية من المضايقات، بما فيها التهديدات بالاعتداء الجسدي والتهديد بالتعقب. كما وصفت 70٪ من نساء العينة المضايقات الإلكترونية على أنها “معضلة خطيرة”.
تعزز نماذج الأعمال الإعلانية لوسائل التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وفيسبوك نشر محتوى يحض على تفاعل المستخدمين معه؛ فكلما زاد التفاعل، زادت فرص الإعلانات. لكن ثمة عواقب لذلك؛ من بينها تفضيل المحتوى الباعث على الشقاق والمثير للعواطف، أو المتطرف، والذي بدوره يمكن أن يغذي المجموعات “الوهمية” التي تعلق على آراء بعضها البعض وتعززها؛ مما يساعد في الحث على نشر محتوى متطرف ويفسح المجال لتداول الأخبار الكاذبة. في الآونة الأخيرة، أوضح الباحثون أن ثمة سعي للتلاعب بالرأي العام عن طريق بث (فقاعات) في وسائل التواصل الاجتماعي وذلك من أطرافٍ لها مصالح في ذلك ومن بينهم النشطاء الروس.
مكنتنا قدرتنا البشرية من تبادل الأفكار من خلال شبكات بشرية لبناء العالم الحديث. وعلى نحو لا نظير له، يُعدُّ الإنترنت وسيلة تسهِّل التعاون والتواصل بين البشرية جمعاء. لكن يبدو أننا نعود إلى القبلية والخلاف عوض أن نوسع دوائرنا الاجتماعية الافتراضية وأن نتقارب مع الآخرين، وأصبح معتقدنا في أن يلم الإنترنت شمل الإنسانية في شبكة تعاونية مجيدة مجرد سخافة. وعلى الرغم من أننا بشكل عام نتفاعل مع الغرباء في الواقع بتهذيب واحترام، إلا أننا يمكن أن نكون فظين للغاية على الإنترنت. كيف بإمكاننا أن نتعلم مجددًا تقنيات تمكِّننا من العثور على قواسم مشتركة وتحقيق ازدهار الجنس البشري؟
“لا تطل التفكير، اضغط الزر فقط”
ضغطت على عدد منها، بشكل فوري وسريع للانتقال إلى السؤال التالي مدركًا أننا جميعا نلعب في سباق مع الزمن. لا أعرف من معي في الفريق، وهم بعيدون عني، ولا أدري إن كنا نلعب هذه اللعبة جميعا معا، أو أنني ألعب لوحدي كالمعتوه، لكنني كبست على الأزرار لمعرفتي بأن الآخرين يعتمدون علي.
نحن نلعب لعبة تسمى لعبة المنافع العامة في مختبر التعاون الإنساني بجامعة ييل. يستخدم الباحثون هنا هـذه اللعبة بوصفها أداة تساعدهم على فهم الكيفية التي نتعاون به، وأسباب ذلك، وإمكانية تعزيزنا لسلوكياتنا الجيدة.
على مر السنين، قدم العلماء نظريات شتى حول الأسباب التي تدفع الناس إلى التعاون ضمن مجتمعات مترابطة جدا. يعتقد أغلب الباحثين اليوم أن جذور لطفنا العام تعود إلى انتفاع كل فرد من التعاون ضمن جماعات من أجل البقاء. لقد جئت إلى مدينة نيو هيفن بولاية كونيتيكت في شهر فبراير البارد جدا لزيارة مجموعة من المختبرات التي تجرى فيها الأبحاث لمعرفة حوافز أن نكون لطفاء مع الآخرين حتى وإن كان ذلك على حساب أنفسنا.
تعد هذه اللعبة التي ألعبها على تطبيق أمازون ميكانيكال ترك (Amazon Mechanical Turk) ضمن تجارب المختبر التي لا زالت قيد التنفيذ. ألعب في فريق مكون من أربعة أشخاص يقطنون كلٌ في بقعة جعرافية مختلفة، ويدفع كل واحد منا المبلغ نفسه للعب. طُلِب منا أن نحدد المبلغ الذي نساهم به في رصيد الفريق؛ إذ وُضح لنا بأن هذا المبلغ سيتضاعف فيما بعد ويقسم فيما بيننا.
ومثل أي تعاون آخر، يقوم هذا المأزق الاجتماعي على مستوى معين من الثقة بأن أفراد الفريق الآخرين سيكونون لطفاء. إن ساهم كل واحد من الفريق بماله، ستتضاعف الأموال، ومن ثم سيعاد توزيعها على الأربعة، وبالتالي سيتضاعف مال كل فرد من أفراد الفريق.
يقول مدير المختبر دافيد راند: “لكن إن نظرت إلى الأمر من منظور الفرد، فإن كل دولار يصرفه سيتضاعف لدولارين وعند تقسيمه على أربعة، يصبح نصيب كل فرد خمسين سنتا من الدولار الذي ساهم به”.
وعلى الرغم أن من الأفضل التعاون بالمساهمة في مشروع جماعي لا يستطيع إدارته شخص بمفرده – هذا ما يحدث في الحياة الواقعية بالدفع لبناء مستشفى أو حفر خندق للري في المجتمع- لكن ثمة كلفة على مستوى الفرد. في عالم المال، كلما كنت أنانيا أكثر، كبرت ثروتك.
يلعب آلاف اللاعبين هذه اللعبة التي يديرها فريق راند. ويُطلب من نصفهم -وكنت منهم- أن يتخذوا قرار المساهمة بسرعة في غضون ١٠ ثوانٍ فقط، بينما يُطلب من النصف الاخر التأني في اتخاذ قراراتهم وأخذ كفايتهم من الوقت. اتضح بأنه عند اتباع الأشخاص حدسهم يكونون كرماء أكثر بكثير منه حين يمتلكون وقتًا كافيا لوزن الأمور.
يقول راند: “ثمة أدلة كثيرة على أن التعاون سمة أساسية من سمات التطور البشري”. ينجو الفرد ومصالحه أكثر بالتعاون مع الجماعة، ويعتمد السماح بالبقاء ضمن مجموعة والاستفادة منها على صيتِ سلوكنا أثناء تعاوننا مع الآخرين.
يقول راند: “كانت جميع التفاعلات في المجمعات الصغيرة التي عاش فيها أسلافنا تتم مع أناس ستراهم مجددا وتتفاعل معهم في المستقبل القريب”؛ أدى ذلك إلى كبح أي محاولات للتصرف بعدوانية أو استغلال الآخرين والتخلص من مساهماتهم. “في هذا الحال، يصبح التعاون مع الآخرين ذا جدوى على الصعيد الشخصي”.
يتبع كل تعاونٍ تعاونٌ آخر في دائرة مصالح متبادلة. وعوض التفكير في كل مرة ما إن كان يهمنا أنْ نستمر في معاملة الآخرين بالحسنى على المدى الطويل، يمكننا أن نتبع قاعدة أساسية وهي أكثر جدوى وتكلفنا جهدا أقل وهي أن نعاملهم بالحسنى. لهذا السبب تكون ردة الفعل الفورية أكثر كرمًا في التجربة.
خلال حياتنا، نتعلم من مجتمعنا المحيط كيف نكون متعاونين، لكن سلوكياتنا المكتسبة يمكن أن تتغير بسرعة.
أولئك الذين تصرفوا بتلقائية في تجربة راند كانوا أكثر سخاء، وكانت عوائدهم أكثر كذلك تعزيزا لسلوكهم السخي. بينما أولئك الذين اتخذوا قرارات أكثر أنانية، وهو ما نتج عنه تجميع مبلغ ضئيل في وعاء المجموعة، وهذا ما عزز فكرة أنه لم يكن مجديًا الاعتماد على المجموعة. وبالتالي، وفي تجربة لاحقة، أعطى راند بعض المال لبعض الأشخاص الذين لعبوا في جولة سابقة من اللعبة، وسألهم عن المبلغ الذي يودون التبرع به لشخص غريب لا يعرفونه. هذه المرة لم تكن هناك أي حوافز؛ ولهذا فإنهم سيتصرفون بإحسان مطلق.
اتضح أن هناك بونًا شاسعًا. ففي المرحلة الثانية، تبرع الأشخاص الذين كانوا متعاونين في المرحلة الأولى بضعف المبلغ الذي تبرع به من آثروا أنفسهم. يقول راند: “نحن نؤثر في حياة الأشخاص الداخلية وتصرفاتهم إذن، والطريقة التي يتصرفون بها حتى وإن لم يكن في المكان من يراقبهم أو يحاسبهم من أجل الجزاء والعقاب”.
درس فريق راند كيفية لعب أشخاص من دول مختلفة لهذه اللعبة لمعرفة قوة المؤسسات المجتمعية مثل الحكومات والأسر والتعليم والأنظمة القانونية في التأثير في السلوك. في كينيا – حيث ثمة الكثير من الفساد في القطاع العام – يبدأ اللاعبون بإعطاء الغريب المال بسخاء أقل من لاعبي الولايات المتحدة الأميريكة والتي بها فساد أقل. يشير هذا إلى أن الأشخاص الذين بإمكانهم الوثوق بالمؤسسات المجتمعية العادلة نسبيًّا يتحلون بروح عامة أكثر ممن لا يمكنهم الوثوق بتلك المؤسسات والذين عادة ما يكونون أكثر احترازا. لكن، وبعد لعب الجولة الأولى من النسخة التي تعزز التعاون من لعبة المنافع العامة، يتعادل الكينيون مع الأميركان في السخاء. وفي المقابل، يتبرع الأميركان الذين دُرِّبوا على أن يكونوا أنانيين بقدر أقل من النقود.
إذن، هل هنالك شيء متعلق بثقافة وسائل التواصل الاجتماعي يدفع بعض الناس إلى التعامل بدناءة مع الآخرين؟
بخلاف مجتمعات الصيد وجمع الثمار في العصور السالفة، والتي تعتمد على التعاون والتشارك من أجل العيش، وغالبًا ما تحكمها قواعد تخص وقت تقديم الطعام لمن هم ضمن نفس الشبكة المجتمعية، تكون مؤسسات التواصل الاجتماعي أضعف؛ فالمستخدمون لها بينهم تباعد جسدي ويجهلون بعضهم البعض نسبيًّا، وهناك مخاطر قليلة تهدد سمعتهم أو تؤدي إلى عقابهم حين يسيئون التصرف؛ فلن يعرف أحد من معارفك إن تصرفت بحقارة.
خضت بصعوبة بعض الكتل الثلجية وأنا أشق طريقي نحو مختبر علم النفس لمولي كروكيت، والذي يدرس العلماء فيه موضوع اتخاذ القرارات الأخلاقية في المجتمعات. وتركز دراستهم على كيفية انتقال المشاعر المجتمعية إلى وسائل التواصل الاجتماعي؛ لا سيما الغضب الأخلاقي. توضح دراسات تصوير الدماغ أن النواة المتكئة (المسؤولة عن نظام المكافأة في الدماغ) تنشط عندما يتصرف الأشخاص تحت تأثير الغضب الأخلاقي؛ ولذا لا يشعرون عادة بالسوء حيال تصرفاتهم. ولهذا، عندما يجدون شخصًا يتصرف على نحو يكسر فيه القواعد المجتمعية – السماح للكلاب بأن تلوث أرضية ملعب ما على سبيل المثال – فإنهم يجابهون مقترف ذلك أمام الملأ، ويشعرون بأنهم أفضل حالا فيما بعد. وإبان مواجهة المخالف للمبادئ المجتمعية، ثمة مخاطر من جهة فقد تتعرض للهجوم، ومن جهة قد تعزز سمعة الفرد.
في حياتنا التي يعمها السلام نسبيًّا، نادرًا ما يواجهنا أحد بأسلوب وقح أو فظ؛ لذا لا نرى عادة أي تعبير عن الغضب الأخلاقي. لكن ما إن تفتح تويتر أو الفيسبوك، سرعان ما ترى صورة مختلفة تمامًا. تشير أبحاث حصرية إلى أن الرسائل التي تحتوي على كلمات أخلاقية وعاطفية تنتشر بنسب أكبر في وسائل التواصل الاجتماعي ويرفع وجود مثل هذه الكلمات في أي تغريدة نسبة إعادة تغريدها بما بقارب٢٠٪.
تقول كروكِت: “يعد المحتوى الذي يثير الغضب أو يعبر عنه أكثر تداولًا” وإن ما صنعناه على الإنترنت هو “نظام بيئي ينتقي المحتوى الأكثر فظاعة؛ في منصات يسهل فيها التعبير عن الغضب أكثر من أي وقت مضى”.
بخلاف الحياة الواقعية، ليس ثمة مخاطر في مجابهة الآخرين أو فضحهم افتراضيًا. لا يأخذ منك الأمر عدا كبسات زر قليلة، ولا تشكل المسافة الجغرافية فارقا؛ ولهذا تزيد فرص التعبير عن الغضب أكثر عبر الإنترنت. ويتفاقم الأمر تلقائيا؛ يقول كروكت: “إن تنمرت على من يخالف مبدأً ما، سيبدو للآخرين أنك أكثر جدارة بالثقة، ولذا يمكنك بالتعبير عن الغضب وتعنيف منتهكي القواعد الاجتماعية أن تكشف عن شخصيتك الأخلاقية. يعتقد الناس أنهم ينشرون الخير بتنفيسهم عن غضبهم النابع من أخلاقهم واستقامتهم”.
“في الحياة الواقعية بإمكانك تعزيز سمعتك أمام من هم حولك في اللحظة الراهنة، بينما في الحياة الافتراضية، يمكنك النشر لشبكتك الاجتماعية كلها، وهو ما يمنحك مكافآت شخصية لمجرد تنفيسك عن غضبك”.
هذا بالإضافة إلى التغذية الراجعة التي يتلقاها الناس على وسائل التواصل الاجتماعي على هيئة إعجابات أو إعادات التغريد وهكذا دواليك. تستطرد كروكت: “نفترض أن تصميم هذه المنصات بإمكانه تحويل التعبير عن الغضب إلى عادة، والعادة هي ما يُفعَل دون الأخذ في الحسبان أي عواقب لذلك؛ مجرد استجابة عمياء لمُحفِّز ما دون تيقظ لما قد يحدث لاحقًا”.
تردف كروكيت: “أظن أن علينا التفكير مليا مجتمعًا ككل في ما إذا كنا نريد أن تصبح أخلاقنا تحت سيطرة الخوارزميات التي تهدف إلى در الأموال على الشركات التقنية الضخمة، أظن بأننا جميعا نود أن نؤمن ونحس بأننا نقصد ما يبدر عنا من مشاعر وأفكار وتصرفات تعكس أخلاقياتنا وليست مجرد ردات فعل غير محسوبة لكل ما يصدف أن يظهر لنا في هواتفنا التي صممت لتجلب أكبر ربح ممكن لمصمميها”.
لكن ثمة جانب مشرق كذلك؛ تكمن أقل أضرار التعبير عن الغضب عبر الإنترنت في تمكن الفئات المهمشة والأقل قوة من الافصاح عن قضايا من الصعب وضعها على الطاولة في العادة. لعب الغضب الأخلاقي في مواقع التواصل الاجتماعي دورًا في تسليط الضوء على التحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء من الرجال ذوي المكانة العالية. وفي فبراير عام ٢٠١٨، أدت إدانة مراهقين من فلوريدا لحادثة طلق ناري في مدرسة ثانوية في المنطقة إلى تغيير الرأي العام، تماما مثلما حدث من تشنيع للشركات الضخمة على وضع خصومات كبرى لأعضاء الاتحاد القومي الأمريكي للأسلحة.
تقول كروكت: “أظن أنه ينبغي علينا إيجاد طرق لنستمر في الاستفادة من العالم الافتراضي؛ أي التفكير بحذر في إعادة تصميم هذه التفاعلات لنتخلص من الجانب القليل الذي يكلفنا الكثير”
درس فريق نيكولاس كريساكيس؛ مدير مختبر الطبيعة البشرية في جامعة ييل الذي يقع بالقرب من المكان الذي أنا فيه الآن، وهو ممن عكفوا على إعادة تصميم تفاعلات المستخدمين في وسائل التواصل الاجتماعي، كيف تؤثر مكانة الفرد في مواقع التواصل في تصرفاتنا، وكيف أن بعض المؤثرين تحديدا بإمكانهم تغيير ثقافة شبكة كاملة على نحو دراماتيكي.
يتقصى الفريق عن طرق لتحديد قائمة بهؤلاء الأفراد لإدراجها في برامج الصحة العامة لإفادة المجتمع. في هندوراس، يُتَّبع هذا النهج لحث الناس على التسجيل للتطعيم أو رعاية الأمهات على سبيل المثال . ويمكن لمثل هؤلاء المؤثرين أن يحولوا العالم الافتراضي من مجتمع تنمري إلى مجتمع داعم.
تتبع الشركات الكبرى بالفعل نظامًا صريحًا لاختيار من يطلق عليهم مشاهير الانستقرام للترويج لماركاتهم. لكن كريساكيس لا ينظر لمدى شهرة فرد ما بل لمكانته ضمن الشبكة ونوع الشبكة. في بعض الشبكات، مثل القرى الصغيرة المعزولة، الناس مترابطون جدًّا لدرجة أن يصبح كل شخص منهم معروفا للآخرين في أي حفلة، أما في المدن، الأمر مختلف تماما، قد يقطن الناس بجوار بعضهم البعض بشكل عام، لكن تقل احتمالية أن تعرف الجميع في حفلة ما. يوضح كريساكيس بأن درجة ترابط شبكة ما تؤثر في السلوكيات والمعلومات التي تنتشر عبرها.
يقول أيضًا: “إن أخذتَ ذرات من الكربون وجمعتها بطريقة ما ستحصل على الجرافيت وهو ناعم وداكن، وإن جمعتها بطريقة مختلفة ستحصل على الألماس وهو صلد وناصع. ليست هذه الخصائص من صلابة ولمعان خصائص ذرات الكربون نفسها، وإنما خصائص تجميعها والنحو الذي ترتبط به مع بعضها البعض، والأمر سيان مع الجماعات البشرية”.
صمم كريستاكيس برنامجًا لدراسة هذا الأمر أنشأ فيه مجتمعات اصطناعية مؤقتة على الإنترنت. “إننا ندخل أشخاصًا في هذه المجتمعات الافتراضية ونجعلهم يتفاعلون مع بعضهم البعض، لنرى كيف يلعبون لعبة المنافع العامة على سبيل المثال، أو لنقيِّم مدى لطفهم مع الآخرين”.
ثم يتلاعب بالشبكة وذلك “بهندسة تفاعلاتهم بطريقة ما؛ بجعلهم لطفاء جدًا مع بعضهم البعض، ويعملون سويًا بجد، ويعيشون بصحة وسعادة وتعاون. أو ربط نفس المجموعة بطريقة مختلفة وجعلهم يتعاملون بدناءة مع بعضهم البعض؛ لا يتعاونون ولا يتشاركون المعلومات وأن تسود الفظاظة بينهم”.
في إحدى التجارب، اختار كريستاكيس غرباء اختيارًا عشوائيًّا ليلعبوا لعبة المنافع العامة مع بعضهم البعض. وقال إن الثلثين منهم كانوا متعاونين في البداية، “إلا أن البعض منهم أخذوا يستغلون البقية؛ ولأنه لم يكن أمامهم خيار ثالث؛ أن يكونوا طيبين ومتعاونين أو أن ينشقوا عن الآخرين، فقد اختاروا الانشقاق في النهاية لأنهم عالقون مع مَن يستغلونهم، حتى انتهى بهم الأمر عند ختام التجربة بالتعامل بحقارة مع بعضهم”.
أدار كريستاكيس دفة الأمر إلى هذا المنحى بفتح المجال لكل واحد منهم؛ كلٌ في جولة، أن يتحكم في مَن يرتبط بهم. “كان عليهم أن يتخذوا قرارًا؛ هل هم طيبون مع الآخرين أم لا؛ وهل هم عالقون معهم أم لا”. كل ما كان يعرفه الواحدُ منهم عن الآخرين هو ما إذا كانوا متعاونين في الجولة السابقة أم لا. “ما استطعنا توضيحه هو أن الناس يقطعون الصلات بمن عُرِف عنهم بأنهم كانوا غير متعاونين، ويبنون صلات مع المتعاونين، وتعيد الشبكة تشكيل روابطها وتصير أشبه بالروابط بين الألماس لا تلك التي تشكل الجرافيت”. وبكلمات أخرى، تصبح الشبكة مجتمعًا متعاونًا وليس العكس.
وفي محاولة لإنشاء مجتمعات افتراضية يسودها التعاون أكثر، بدأ فريق كريستاكيس بإدخال روبوتات في المجتمعات المؤقتة التي أنشأها مسبقًا. ثم أخذني لأجلس أمام لابتوب لألعب لعبة مختلفة. في هذه اللعبة، ينبغي على لاعبين مجهولين أن يعملوا سويًا في فريق لحل لغز يألفه عمال التبليط؛ كان على كل واحد منا أن يختار واحدًا من الألوان الثلاثة؛ بحيث يجب أن يختار اللاعبون الذي يرتبطون ببعض مباشرة ألوانا مختلفة، وإن فككنا الأحجية في الوقت المحدد؛ سنحظى جميعًا بجائزة مالية، وإن فشلنا، لن يحصل أي منا علي شيء. وأنا ألعب مع قرابة ثلاثين لاعبًا، ولا يستطيع أيٌّ منا رؤية شبكة الترابط كاملة بل من نرتبط بهم بشكل مباشر فقط، ومع ذلك، لابد أن نتعاون جميعًا حتى يتسنى لنا الفوز.
أنا موصول باثنين ممن يجاورونني؛ اختار واحد منهم اللون الأخضر والآخر اللون الأزرق؛ ولهذا اخترت اللون الأحمر. ثم استبدل جاري الذي على يساري اللون الذي أخذه بالأحمر، لذا استبدلت الأحمر بالأزرق بسرعة، واستمرت اللعبة وأخذ توتري يزداد وأنا أشتم المرات التي كانت ردات فعلي فيها بطيئة. كثيرًا ما كان علي تبديل اللون الذي اخترته استجابة لتغييرات لا أراها تطرأ في مكان ما من الشبكة والتي تسري عبر الشبكة كلها. انتهى الوقت قبل فكنا الأحجية، وانهالت التعليقات في اللعبة من لاعبين افتراضيين يلقي فيها كل منهم اللوم على غباء الآخرين. أما عني، شعرت بارتياح لمجرد انتهاء اللعبة ولم يعد هناك من يعتمد على مهاراتي الخرقاء في اللعب لكسب المال.
أخبرني كريستاكيس بأن بعض الشبكات كانت معقدة لدرجة يستحيل معها فك الأحجية في الوقت المحدد. لم يدم ارتياحي طويلًا؛ حين علمت أن أحجية شبكتنا كانت قابلة للحل وأعاد أمامي شريط اللعبة كاشفًا لي الشبكة بأكملها أمامي لأول مرة. رأيت الآن أني كنت في الفرع السفلي لمحور الشبكة، وكان بعض اللاعبين متصلين بشخص واحد فقط، بينما الغالبية يتصلون بثلاثة أشخاص أو أكثر. يلعب آلاف الأشخاص من كل دول العالم هذه الألعاب على تطبيق أمازون ميكانيكال ترك (Amazon Mechanical Turk)؛ إذ يتحمسون لها بعد كسبهم مبالغ ضئيلة في كل جولة. لكن بينما أشاهد اللعبة، تكشفت لي الأمور؛ إذ كشف لي كريستاكيس أن ثلاثة من اللاعبين في الحقيقة كانوا عبارة عن روبوتات ثابتة. وضح كريستاكيس:”نطلق عليها “روبوتات الغباء الاصطناعي””.
لا يهتم فريقه باختراع ذكاء اصطناعي خارق يحل محل الذكاء البشري. ولكن خطتهم تكمن في الدخول بين عينة من الناس الأذكياء بواسطة روبوتات صممت بحيث تتصرف بغباء لتساعد الناس على مساعدة أنفسهم.
يقول كريستاكيس: “أردنا رؤية إن كان بإمكاننا استخدام هذه الروبوتات لتحرير الناس وتمكينهم من التعاون والتنسيق أكثر قليلًا حتى يتسنى لقدرتهم الفطرية أن تظهر في تصرفاتهم بقليل من المساعدة”. ولقد وجد أن هذه الروبوتات لا تساعد الناس إن لعبت على نحو مثالي، لكن إن أخطأت قليلًا، فإنها تفسح المجال لإمكانية أن تجد المجموعة الحل.
تختاربعض هذه الروبوتات اختيارات غير متوقعة؛ فحتى وإن كان بإمكانها اختيار اللون البرتقالي لأن كل من يجاورونها اختاروا اللون الأخضر، تختار اللون الأخضر أيضًا، “وهي بذلك تفتح المجال للشخص الذي يلعب بعدها أن يختار لونا مختلفا ويتمكن بذلك – ويا للروعة- من فك الأحجية”، وبدون الروبوت، ربما يعلق كل اللاعبين باختيارهم للون الأخضر دون أن يدركوا بأن المشكلة تكمن هناك. “بزيادة الاختلاف المؤقت، يمكن للمجاورين الاختيار بشكل أفضل”.
ومع الإخلال بالنظام قليلا، تساعد الروبوتات الشبكة على التشكل بكفاءة أكبر. ومن الأمثلة على اتباع هذه الطريقة؛ أن تبث هذه الروبوتات وجهة نظر مختلفة عن أشخاص حزبيين على شريط آخر الأخبار؛ وذلك للمساعدة في إخراج الناس من فقاعات الراحة على مواقع التواصل الاجتماعي وتمكين المجتمع من التعاون أكثر.

يعد الاستتار خلف أسماء مستعارة في التفاعلات عبر الإنترنت منبعًا للكثير من السلوكيات المرفوضة اجتماعيا؛ إذ لن يؤثر كون المرء دنيئًا في سمعته بنفس القدر الذي يتسبب به ذلك في الواقع. وجدت إحدى التجارب أن التغريدات العنصرية المسيئة التي يتعرض لها السود على تويتر يمكن أن تقل بشكل كبير باستخدام حساب يديره روبوت بصورة شخصية لرجل أبيض يرد على مثل هذه التغريدات. من بين أحد الردود النموذجية للروبوت على تغريدة متحيزة هو: “أهلًا، تذكر أنك تكتب هذه التغريدة لشخص سيتألم فعلًا حين يراها”. قد يتوقف مثل هؤلاء المغردين عن كتابة التغريدات المتحيزة نهائيًا خلال أسابيع بعد حثهم على التعاطف بهذه الصورة.
هناك طريقة أخرى لمعالجة عدم وجود أي تهديد على سمعة المرء حينما يبدي سلوكًا سيئًا على الإنترنت وذلك بفرض نوع من أنواع العقوبات الاجتماعية. اتخذت شركة ليغ أوف ليجيندز (League of Legends) مثل هذا الإجراء، وهي إحدى شركات صناعة الألعاب،وذلك بإصدار ميزة “المحكمة”، والتي تقضي بأن من يتصرف تصرفًا سيئًا سيتلقى العقوبة من بقية اللاعبين. أصدرت الشركة بيانًا أن ٢٨٠٠٠٠ لاعبًا أصلحوا أنفسهم خلال عام وهذا يعني أنهم غيروا سلوكهم بعدما عاقبتهم “المحكمة” وأصبح لهم دور إيجابي في المجتمع. يمكن لمطوري البرامج كذلك أن يضعوا حوافز اجتماعية للسلوكيات الحسنة لتشجيع مبادئ التعاون التي تعين في بناء العلاقات.
بدأ الباحثون بالفعل تعلم كيفية توقع حدوث مثل هذا التحول إلى الأسوأ؛ اللحظة التي يمكن فيها الاستفادة من التدخل للوقاية من أمر ما. يقول كريستيان دانيسكو – نيكولسكو-ميزيل، من قسم علوم المعلومات بجامعة كورنيل: “قد تظن بأن من يتسببون بكل هذا الأذى هم بعض المختلين عقليًّا الذين نطلق عليهم “المتصيدين”، لكن في الحقيقة، وجدنا في أبحاثنا أن من الممكن أن تصدر مثل هذه التصرفات المرفوضة اجتماعيًّا من أشخاص عاديين، مثلي ومثلك. ويمكنك أنت أن تصبح متصيدًا كذلك في وقت ما من حياتك، وهذا مدهش”.
لكنه يدق ناقوس الخطر كذلك، عدت بذاكرتي لأنقب في تغريداتي الأخيرة آملًا ألا أكون قد أرخيت الحبل لنفسي وتنمرت على أحد في محاولات ساذجة لأبدو مُضحِكًا أو رائعًا فقط أمام متابعيَّ. في النهاية، من المغري جدًّا أن نتنمر على أحدٍ بعيد عنا ولا نعرفه في حال ظننا أننا بهذه الطريقة سنبهر دائرتنا الاجتماعية.
يدرس إنيسكو – نيكولسكو-ميزيل التعليقات المكتوبة أسفل المقالات، وقد صنف بواعث التصيد إلى قسمين: سياق التبدُّل؛ النحو الذي يتصرف به بقية المستخدمين، والمزاج. يقول: “إن مررت بيوم عصيب، أو كان يوم الأحد على سبيل المثال، فإن احتمالية تصيدك في مثل هذه الحالة تكون أكبر، وأنك ستكون ألطف في صباحات يوم الخميس”.
وبعد جمع البيانات، ومن ضمنها بيانات أشخاص قاموا بتصرفات تصيدية في وقت سابق في حياتهم، كتب إنيسكو – نيكولسكو-ميزيل خوارزمية تتنبأ بالوقت الذي يوشك فيه الفرد على التنمر على الإنترنت بدقة نسبتها ٨٠٪. وهذه فرصة لتأخير نشر استجاباتنا. إن كان بإمكاننا التفكير مرتين قبل كتابة رد ما، فإن هذا يحسِّن سياق التحول للجميع: ستقل احتمالية رؤيتنا لأشخاص يسيئون التصرف، كما ستقل احتمالية أن نسيء نحن التصرف كذلك”.
أما الجانب المشرق، فبغض النظر عن تجاربنا الفظيعة التي مررنا بها في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن أغلب التفاعلات لطيفة وداعمة. وهناك أيضا الغضب الأخلاقي المُبَرر الذي يستخدم بصورة جيدة للتصدي للتغريدات المشحونة بالكره. وفي دراسة بريطانية حديثة تتقصى حول معاداة السامية في تويتر، وجد أن مشاركة التغريدات التي تتصدى لمعاداة السامية أكبر بكثير من تغريدات معاداة السامية نفسها. وأن أغلب التغريدات المسيئة تُتَجاهل أو تتم مشاركتها باستمرار بين حسابات بعينها. ربما أصبحنا نحن أنفسنا نحذو حذو الروبوتات بالفعل.
أشار إنيسكو – نيكولسكو-ميزيل إلى أننا عمدنا على شحذ علاقة الفرد بالفرد الآخر لآلاف السنوات، لكنه يقول إننا باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي عشرين عاما فقط، “وبينما يمكننا في التواصل المباشر استخدام تعابير الوجوه ولغة الجسد والحديث في النقاش، تحل الكتابة محل كل ذلك في النقاشات الإلكترونية، أعتقد أنه لا ينبغي علينا أن نتفاجأ بأننا نواجه صعوبة في العثور على الطرق الصحيحة للنقاش والتعاون عبر الإنترنت”.
وبينما يتطور سلوكنا في المواقع الإلكترونية، يمكن أن تصدر عنا إشارات رقمية حاذقة تنوب عن ملامح الوجه لتساعد في تلطيف النقاشات الإلكترونية. في الوقت الراهن، نصيحتي للتعامل مع التنمر الإلكتروني هي أن نبقى هادئين، فنحن لم نتسبب بذلك. وعوض الرد بالمثل، علينا أن نحظر المتنمرين ونتجاهلهم، أو أن نطلب منهم التوقف عن ذلك إن استطعنا. كذلك علينا أن نتحدث مع الأهل والأصدقاء عما يحدث وأن نأخذ مشورتهم. علينا أيضا أن نصور الشاشة وأن نبلغ عن تعرضنا للتنمر الإلكتروني عبر خدمات موقع التواصل الذي حدث فيه ذلك، وإن كان هناك أي تهديد ملموس فعلينا تبليغ الشرطة.
استمرارية هذه المواقع مرهونة بتوجيه الشركات التي تديرها خوارزمياتها بالاستعانة بالعلم السلوكي ربما وذلك للحض على التآلف عوض الفرقة والشقاق، وتجارب إلكترونية إيجابية وليس العكس. وحتى نحن – مستخدمو هذه المواقع- ربما علينا أن نتعلم التكيف مع بيئة التواصل الحديثة هذه حتى يبقى التفاعل الأهلي والمُنتِج في العالم الافتراضي كما هو في الواقع.
يقول إنيسكو – نيكولسكو-ميزيل: “أنا متفائل؛ هذه مجرد لعبة أخرى وعلينا أن نطور أنفسنا لنجيدها”.
بقلم: جايا فينس | ترجمة: آلاء الراشدية | تدقيق: عهود المخينية | المصدر