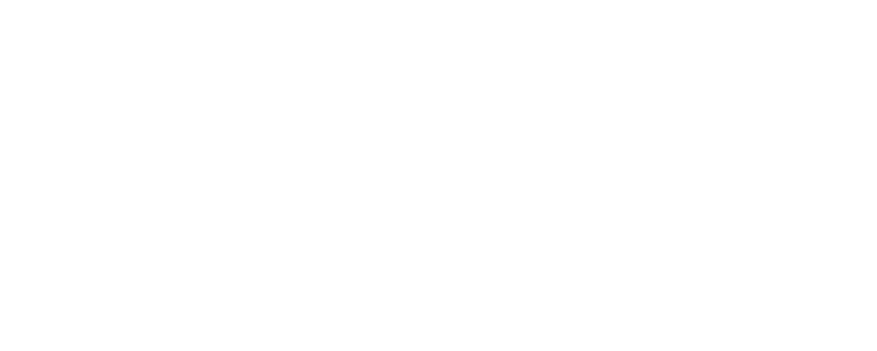هل هناك من يُخلَقُ تعيسًا مثلما يُولَدُ البعض بأغشية جنينية؟
تشريح مقتَضبٌ لاضطراب الاكتئاب المستمر (PDD)

كنتُ طفلة مِزاجية. هذا ما قاله والداي
“إنها طفلة مزاجية للغاية”
“لِمَ أنتِ متقلبة المزاج لهذه الدرجة؟”
لا أتذكر أن أحدًا من قبل نعتني بـ”طفلة سعيدة” أو “طفلة مشرقة المُحيا”، أو شيءٍ من هذا القبيل، مع أنني كنت أمرُّ بأوقات سعيدة أحيانا بلا شك؛ أتذكر بوضوح أني قفزتُ ذات صباح من السرير – حين كنتُ في السادسة أو السابعة من عمري – للاستمتاع بالاستيقاظ والذهاب إلى المدرسة. بيد أني ما زلتُ مرتابة إلى الآن بشأن تلك الذكرى؛ ربما كانت محاولة لتغيير مزاج عائلتي ليس إلا، أكثر من كونها تعبيرًا صادقًا عن الفرح؛ إذ تبدو وأنا أسترجعها الآن مصطنعة للغاية، وهي جل ما أتذكره من اللحظات التي كنتُ فيها مفعمة الحيوية، إلا أن هناكَ غيرها بالتأكيد.
أكثر ما يتغلغل في ذاكرتي عن طفولتي المبكرة هو كوني متقلبة المزاج؛ أو ربما كان لي مزاجٌ واحد لا يعدو أن يكون تسلسلًا لونيًا للوحة أحادية اللون؛ يتدرج من ظلال هادئة ولطيفة بإحدى نهايتيه، إلى جليد قاسٍ ومتصدِّع وقاتم جدًا في الأخرى. وكنتُ أنا بداخل ذلك السياج دوما، وهم خارجَه لا يستطيعون الولوج، وأنا هناك لا أرغب في الخروج تارةً، وغير قادرة عليه تارةً أخرى.
تقول أمي لأبي حين يعود من العمل: “تمر بإحدى حالاتها المزاجية”، ويمكن اختصار الكلمات لتتناسب مع الحال: مررتُ بحالات مزاجية، كنت بمزاج سيء، كنت طفلة متقلبة المزاج. أن تكون “طفلًا متقلبَ المزاج” فهذه صفة لحال دائم، بينما أن تكون “بمزاج سيء” فهذه إشارة إلى نوباتِ غضبٍ عادة – قد تمتدُّ في الحقيقة من ساعات لأيام أحيانا، ولا أعتقد بأن أيًا منها قد ينجم عن مواجهة المتاعب فهي واردة جدا وحدوثها هيِّن؛ عدا أني كنت أستشيط غضبًا وأحس بغبن شديد فور التعرضِ لها، بينما يغتاظُ بقية الأطفال تدريجيا – وهي تجربة مشتركة بين عامةِ الأطفال على الأرجح -ليتطورَ الأمر لاحقًا فقط إلى نوبة غضبٍ وانطواء.
تنتابني طورًا حالة مزاجية عندما يتجادل والداي أو يتشاجران، وتُسْتَهَلُّ بالكَرب أو الخوف، والانطواء، وطورًا آخرَ، تتلبسني دون أي مسوِّغ أستطيع تمييزه قطعيًّا، ستمطر عليَّ، وتتخمني بالكآبة والظلام الدامس والانطواء. ما إن تبدأ تغدو جليَّةً، وإن كان لا بُدَّ من وجود نقطة تنبثق منها أي حلقة في لحظة ما أو أخرى، إلا أن حالتي تلك بدَتْ لي ولهما على الأرجح، كما لو أنها ظلت تتطور لدهور، كما لو أنني جُبِلتُ عليها مثلما يولد البعضُ بأغشية جنينية. يميزها والداي، وأنا أيضًا. لا يسعني تَذَّكُّر المرة الأولى لحدوث ذلك، أو لحظة بعينها، وليس مهمًّا كم كان عمري آنذاك، فحينئذٍ لم أكن مدركةً خطرَ الغرق في إحدى حالاتي المزاجية المريعة.
يقف والداي أعلى رأسي بينما أتكور في زاوية ما، أو أجلس متربعة على الأرض مركزة عينيَّ على السجادة المزخرفة، يقفان ليسألا الأسئلة عينها في كل مرة: “ما خطبك؟”، “ماذا دهاك؟”، “هل حدث شيء ما؟”، “لمَ أنتِ هكذا؟”، “لم لا تجيبين عندما أتحدث إليك؟”، “استجمعي قواكِ وأخبريني ما الأمر”، “ماذا دهاكِ؟”، “لم تتصرفين هكذا؟”، “أجبينيي!”.
تبعدني الحالة المزاجية – كما أطلقنا عليها – عنهما وتطوقني بحواجزَ تشتت الأسئلة كدرعٍ مُصْمَتٍ يكتم صوتهما ويحميني منهما، لكنه في المقابل، يفصلني عنهما وعن أي إمكانية للإجابة عن تلك الأسئلة أو الوصول إليهما سواء بصوتي أو جسدي.
يمكنني إلى حد ما الآن تشريحُ ما مررتُ به بإدراكٍ متأخر، منتهجةً نهجًا سرديًا لتجربة لا تمتُّ للحكايات بصلة على ما أظن. (بالنسبة إلي إذن، ليس الشرح غايتي، فهو أشبه بقطار، لا غاية من سيره إلا ببلوغه وجهته المنشودة).
إني أصلُ لمكان قابعٍ في أعماقي، يُسجَن جسدي في غورِه بزنزانة هي على ما يبدو هيكلي العظمي وجلدي، بالإضافة إلى تبدُّدِ الهواء من حولِ ذاتي المادية. إنه مكان لا أستطيع أن أكون فيه، ولا يمكنني إلا أن أكون فيه.
أعلم بأن هذا المكان الذي ألجِهُ؛ الفضاء الخفي الذي يطوِّقني – حيث لا يمكنني أن أكون، أو أن أتنفس، أو أن أُوجَد، أو ألا أُوجَدَ حتى – لا يمكن أن يُوجَد أيضًا. حيزٌ لما لا حيز له. مكان لا جدوى منه، إذ يمكن للعبث أن يُخلَق منه، إلا أنه يصبح موجودًا ما إنْ أكون فيه. هو غياب في غياب، وسوادٌ يدلهمُّ أكثر. عتمة تشتد، وجِدار يُشيَّد إلى أعلى شيئا فشيئا. يزدادُ الإبهام وتكثر العقبات إلى أن يبلغا كل ذلك مبلغًا لا يمكن معه إنقاذ أي شيء أو رتقه، وأسوأ من ذلك بكثير لدرجة تفوق قدرتي على التخيل. إنه صراعٌ لا حل له إلا أن يستعصي حله أكثر فأكثر، ويستمرُّ إلى ما لا نهاية. إنه أبديٌ؛ أيْ “إلى الأبد” المروعة، ولا إنسانيٌ بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى.
هذا المكان – الذي تزجني فيه تلك الحالة – بينما يتحدث الناس إلي، هو المكان الذي أكون فيه، وهو ما يحدث لي، هو السبب، وهو ما يجعل كل شيء – سواء في الخارج أم الداخل – مستحيلًا، ويجعل الحياة نفسها مستحيلة تمامًا، تمامًا بالفعل. إنني محتجزة في جزيرة المستحيل، ولا يمكن الوصول إلي، بل لا تنفك هذه الاستحالة تغدو أسوأ من ذي قبل. والوضع يتفاقم تفاقمًا مستمرًّا. ليس ثمة حدٌ لما هو أسوأ، أرى عجزي مندفعًا نحوي، يشتد ويشتد لدرجة لم أتخيلها قط، ولن أنساها أبدًا، كلما اندفعَ نحوي أكثر، لمحتُ استفحاله أكثر، لم أجرؤ على الخوفِ، بإمكاني رؤيته متجهًا إلي أو أنا متجهةً نحوه، وهذا تقريبًا ما يشبه أن تكون في أقتم نقطة من التسلسل اللوني، أن تعيش بداخل هذه الفقرة والتي رغم تسارعها وإلحاحها، ليست إلا كلمات ميلودرامية متعثرة تعجز أن تصف حجم فظاعة ما أمر به و واقعيته، وحجم انعدام رغبتي في استمراره.
وذاك أسوأ ما قد يحدث، إلا أنه وعلى حدِّ علمي جزء من تسلسل لوني نعيش جميعا بين تدرجاته، فما بين تضاد الأزرقين: أزرقُ الاكتئاب الحاد وأزرق بهجة المحيط المتلألئ، ثمة كرَّاسُ طيًّ بعدد لا يحصى من الحالات المزاجية التي لا نفكر فيها بمعزل عن حياتنا، بل بأنها تلونها وتظللها، وبأن الأحداث والمؤثرات الخارجية تخلق حالات مزاجية تلون وجودنا بخفة وتزهيه كل يوم. يحصل شيء ما، كأنْ نقرأ عن أزمة سياسية، أو نرى قطة لطيفة على الإنترنت، أن نحلم حلمًا جيدًا كان أو سيئًا، فيصطبغ وجودنا في العالم بالحالة المزاجية وفقًا لذلك. الحالة المزاجية هي لون يطلي ذلك الشيء الذي نسميه “حياتنا”: أي سبرٌ لأغوار ذاتنا السفلى وارتقاء بها.
يراودنا جميعا إحساس متفاوت العمق بشأن “من نحن فعلًا”، والذي يضطرب مُهدَّدًا بالتقلب المزاجي على نحو مؤقت أو دائم، كقاربين يبحر أحدهما على خليج بسكاي الهائج، والآخر في منطقة الركود الاستوائي حيث تسكن الرياح، وأنا جربتُ أن أكون في القاربين وأعرف قوة كل من الاضطراب والسكون على تحريكي؛ ذلك الإحساس بأنك جسيم صغير وسط عاصفة أو هدوء آخذٍ في الاضطراب. من الممكن مع ذلك أن تكون الذات الحقيقية التي ندركها مجرد مرآة ليس إلا، قد لا تعدو أن تكون أساسًا وكيانًا واحدًا للحالات المزاجية التي نود أن نقول بأنها تؤثر “فينا” وتغير مشاعرنا بغتة. ماذا لو أن حالاتنا المزاجية إنما هي حيواتنا؟ أو كانت ذواتنا هي كراسُّ الطي لما نكونه بالفعل؛ أي تدفق مستمر للظلال العاطفية من صنيع المحيطين البيولوجي والوجودي وبلورتهما – الجسد والعقل، والعالم – وبأنه لا وجود عدا لذات واحدة، تتأثر بحالاتنا المزاجية العابرة؟ عوضَ أن يكون ثمة حالة مزاجية واحدة كما يعرِّفها والداي بأنها عائق في طريق ذاتي الحقيقية؟
لن يقول أحد كلامًا مشابهًا في خمسينيات القرن العشرين، بل كان واضحًا بأني طفلة لديها حوادث اكتئابية عارضة من نوع ما.
عندما أخذاني إلى الطبيب، أخبرهما ما كانا يعرفانه مسبقًا؛ بأني متقلبة المزاج، وأعاني من آلام عاطفية متزايدة. ولرفع حالتهما المعنوية، شرح لهما بأني سأتجاوز هذا الأمر ما إنْ أكبر، ووصف لي دواء مركزًا حلوَ المذاق قليلًا يُسَمى “مُنشِّطٌ”.
كبرت، لكنني لم أتجاوز ذلك قطُّ.

تشخيص أي داء رهنٌ بيدِ الوقت والموضة (سمِّه التقدم العلمي إن شئت). يُشخَّص الأطفال اليوم وهم في مُهُدهم باضطراب “نفسي” ما أو آخر، حسبما يطلق عليه؛ إذ لا وجود لتمزقٍ في عضو أو عدوى تسبب حُمى واضحة للعيان.
في نهاية المطاف، العقل غير مرئي، بل غير موجود بالنسبة للبعض، وبالرغم من إمكانية مراقبة نشاط الدماغ في الآونة الأخيرة عبر المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي، إلا أن تصوير الأعصاب في الوقت الراهن ليس إلا محاولة قبضٍ لريح في عديد من الحالات.
يحدث شيء ما في المهاد أو في اللوزة الدماغية عندما يراودك شعورٌ جيدٌ أو سيءٌ، يُمكن أن يُرى ذلك على هيئة إشارات لونية مضيئة، لكن كيف؟ أو لماذا يحدث ذلك؟ وعمَّا يُنبِئُ؟ يصعب معرفة كل هذا.
يقارن الوضع الراهن لتصوير الأعصاب بالفرينولوجيا (علم فراسة الدماغ)؛ إن كنَّا متأكدين مما حدث في الدماغ، وسببه، وآلية عمل الكيمياء الحيوية وراء ذلك، قد لا يسوِّغنا ذلك لتصنيف المرض إلى “نفسي” أو جسدي” على نحو كافٍ.
يُنقَّح الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية – الذي نشرته الجمعية الأميركية للأطباء النفسيين- دوريًّا منذ تحريره عام ١٩٥٢م. وبإجماع ثلة من الخبراء، تُغيَّرُ بعض التعريفات الموجودة وتُشذَّب في كل طبعة؛ وتُعتَمد ليستخدمها علماء النفس السريري والأطباء النفسيون، لتحديد ما يُعَدُّ اضطرابًا للعقل وكيفية فحصه، بناءً على الأعراض الظاهرة على المريض. في مايو ٢٠١٣، صدرت الطبعة الخامسة من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية.
إن أكثر أنواع الاكتئاب حدة من بين التي أعاني منها يُعرَّف بأنه “اضطرَابُ الاكتئاب الجسيم”، بينما أخف أنواعه تأثيرًا والذي يعاود المريض بين الفينة والأخرى، يندرج في الطبعات السابقة من الدليل التشخيصي والإحصائي تحت اضطرابي الاكتئاب المزمن والاكتئاب الجزئي؛ اللذين يندرجان في الطبعة الخامسة الحديثة من الدليل تحت قسم تشخيص اضطراب الاكتئاب المستمر (PDD).
لاضطراب الاكتئاب المستمر (PDD) مجموعة أعراض (مثل الشعور بانعدام الأمل واضطراب النوم وعدم الثقة بالنفس)، ولا بد من استمرار ظهور عرَضَين منها لسنتين أو أكثر ليخولنا ذلك لتشخيص المرء به. لهذا الاضطراب مظاهرُ سوداوية من الحزن والشعور بالإحباط الشديد والتي تظهر مُبكرًا في مرحلتي الطفولة أو المراهقة، وهو ليس مؤقتا ولا يمكن الحد منه مثل اضطراب الاكتئاب الجسيم.
يقدِّر الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية الخامس بأن 0.5% من سكان الولايات المتحدة مصابون باضطراب الاكتئاب المستمر (سوء المزاج)، لكن ثمة مصادرُ أخرى تشير إلى نسبة أكبر بكثير من هذه. لا يوجد سبب بيِّن، ولكن من الممكن أن يعزى ذلك إلى عدة عوامل من بينها: الجينات أو حوادث الفقد إبان الطفولة أو التشتت الأسري والعزلة. ويمكن تمييزه بأنْ يقول المرضى شيئًا شبيهًا بـ:” لطالما كنتُ هكذا دائمًا”. إلى الآن، لم يُطلق على اضطراب الاكتئاب المستمر (سوء المزاج) مسمى “بؤس” في أي طبعة من طبعات الدليل التشخيصي. ومع ذلك، نحن نعيش في عالم البديهيات عمومًا، وغالبًا ما يكون صادقًا كفايةً، لكنَّه لا يمدُّ يدَ العون؛ إذْ طغت فكرة النصف الممتلئ من الكأس ونصفه الفارغ المتعلقة بالتفاؤل والتشاؤم على الوصف المذكور في الطبعة الخامسة من الدليل، والذي يمكن أن يُمَيِّزهُ أولئك البائسون منَّا بسهولة؛ مَنْ يظنون بأنهم جُبلُوا على الشقاء.
تونيو كروجر هي رواية كتبها توماس مان؛ عن الانطوائي والقاتم والمتبلد: تونيو، الذي قُرِّعُ مرارًا لارتباطه بالفتاة “التي وقعت أثناء الرقص”، عوضَ الأخريات المليحات البشوشات الهيفاوات ممن يُحِطن به. هذه الرواية وصفٌ فنيٌّ للظلام دون مغالاة، لكنها كانت بالنسبة إلي حينما قرأتها في مراهقتي، وصفًا لحياتي البائسة والمضطربة آنذاك في عالم بَدَا كما لو أنه متمكن من المضي قدمًا أكثر بكثير مما أفعل.
يمكن بسهولة العثور على مراجعَ تتناول هذا النوع المألوف من الاكتئاب المستمر أو سوء المزاج في الأدب. على سبيل المثال، في رواية السفراء لهينري جيمس، توضِّح الآنسة جوستري للامبرت ستريثر: “أنت عاجز كليًّا… أعني أنكَ عاجزٌ عن الاستمتاع”، وفي الفقرة الأولى من رواية موبي ديك، قدَّم إسماعيل نفسه بقوله: “كلما أجدُ نفسي متجهمَّ الوجهِ، وروحي مثقلة بكآبة نوفمبر ورذاذه، كلما أجدُ نفسي أتردد رغمًا عني على مستودعاتِ التوابيت؛ مُستحْضِرًا كل الجنائز التي مررتُ بها، عندئذٍ فقط، يتحتمُ علي الذهاب إلى البحر بأسرع وقت ممكن”. أيضًا، في رائعةٍ ملفِل، “بارتبلي النَّسَّاخ” هو قطعًا أنموذج لسوء المزاج؛ فهو غامضٌ، وفاقدٌ للحِسِّ لكنه عنيد، يكرر بهدوء وحزم: “أفضِّل ألَّا أفعل”.
ربما تكون استجابتك لشخصية إيور في كتب ميلاني (ويني ذا بو) في طفولتك اختبارًا أفضل لوجود اضطراب الاكتئاب المستمر من الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية.
قال إيور بحزن شديد: “صباحُ الخير أيها الدب بُو”، “إن كانَ صباحَ خير” وأردفَ: “على أنني أشك في ذلك”.
“لماذا؟ ماذا دهاك؟”
“لا شيء أيها الدب بُو، لا شيء، كلنا لا نستطيع، وبعضنا لا يفعل، هذا كل ما في الأمر”.
قال بُو وهو يحكُّ أنفَه: “لا نستطيع ماذا؟”
“الفرح. الغناء والرقص، ها نحنُ ذا ندور حول شجيرة التوت”.
لقد كنت إيور دائمًا. أتوقعُ أن تسلك الأمور مسلكًا سيئًا، أن تتحطم وتفسد، ويدب في قلبي الرعب مما يجلب الاطمئنان للآخرين. ظلت سلبيتي تشدُّ عليَّ الوثاق، وهذا ما كان مفهومًا، وعصيًا على الفهم في الآن نفسه؛ لماذا أقضي كثيرا من الوقت بمفردي بينما يقضي بقية الأطفال أوقاتهم يلعبون سويًّا؟
عندما كنت في الخامسة أو العاشرة من عمري، لم يكن هذا نمطَ حياة اتخذته كما هو حال تابعي الموضات إبان العصر الإليزابيثي؛ ملابسهم مهملة عن قصد، ورؤوسهم بين أيديهم بينما يستمعون لأغنيات داونلود – موريسيّ عصره – الحزينة والشجية، أو كما سيكون حالُ غوثيي القرن العشرين. بل كان الصندوق الذي أعيش بداخله، ومع ذلك لم يكن صندوقًا أردت الهرب منه بصدق. أنظر إلى الخارج بغبطة نوعًا ما، لكنني أعرف أنني في المكان الذي أنتمي إليه حقًا وأريد المكثَ فيه. شعرتُ بأنني أشبه نفسي. لطالما كنت هكذا دائما.
عقبَ عقدين من الزمن فقط، راجع علماء النفس والأطباء النفسيين الأدلة التشخيصية والإحصائية السابقة للاضطرابات النفسية، ليُطلقوا على حالتي “اضطراب سوء المزاج” في الطبعة الرابعة من الدليل، أو المعاناة من “اضطراب الاكتئاب المستمر” في الطبعة الخامسة منه. في نهاية مراهقتي، شُخِّصتُ بالـ “ـاكتئاب السريري”، والذي اقتضى تلقيَ عدة علاجات وتدخلات، إلا أن هذا التشخيص لم يوضِّح لي ما أنا عليه؛ منفصلة عن نفسي، وطفلة سيئة المزاج لا تلتفت إطلاقًا لأي جانبٍ مشرِق، وتسقط بين الحين والآخر في دياجيرِ الكآبة.
أتساءل فيما لو كان تشخيصي باضطراب الاكتئاب المستمر سيشكِّل فارقًا عندما كنت عالقة بداخل نفسي؛ لربما قدم لنا تفسيرًا (أنا ووالديَّ)، ولوجدنا شيئًا نقوله؛ أي تصنيفًا عندما تموج بي إحدى حالاتي النفسية.
كلمة “اضطراب” ليست مريحة أو منطقية تماما مثل المفردات الأخرى التي تشير إلى الإصابة بالتهاب أو حالة مرضية ما، لكنها على الأقل، تخبرك بأن ثمة ما هو معطوب فيك، وتخبر طبيبَك أيضا بأنك لن تتجاوز الأمر.
“مَن يعانون مِن اضطراب سوء المزاج معرضون لخطر الإصابة بدرجات أسوأ من الاكتئاب. في الحقيقة، ما نسبتهم 80-90% يصابون باضطراب الاكتئاب الجسيم”، وبحسب سايك سنترال، أوضح تقرير بأن معدلات سلوك الانتحار لاضطراب الاكتئاب المستمر مشابهة جدًّا لمعدلات انتحار المصابين بالاكتئاب الجسيم.
أخبرني إيان جوديير – أستاذ في طب النفس للأطفال والمراهقين بجامعة كيمبريج وطبيب نفسي للأطفال – بأن تشخيص اضطراب الاكتئاب المستمر كان ذا جدوى لعلاج الأطفال؛ أي قدَّم طريقة دقيقة للتفكير فيما يخص الأطفال التعساء”.
يرى الأستاذ جوديير بأن الأطفال الذين تأثرت حيواتهم الاجتماعية والتعليمية، ومَن ليسوا مجرد ساخطين وتعساء فقط (صنف آخر من الاضطراب)، إنما هم حزانى ويفتقرون إلى الرعاية الاجتماعية والعاطفية ممن يحيطون بهم، لذا لا يصرف لهم مضادات الاكتئاب، بل يلجأ لهذا التشخيص للتحدث مع الأطفال، والأهم من ذلك، للتدخل والحد من المخاطر التي قد يتعرض لها مثل هؤلاء الأطفال من عائلاتهم. وقد وجد بأنهم يفتقرون للمرونة، كما لو أنهم يفتقرون لطبقة جلدية. وعندما سألته عما إذا كانوا مجبولين على ذلك منذ ولادتهم، أو تسببت به بيئاتهم، أجاب بأنَّ ثمة ما يثبت وجود استعداد عائلي لحصول ذلك، كما هو الحال بالنسبة للاكتئاب الجسيم، ويُمكن أن يُلاحَظ على نحو جليٍّ تمامًا على أي والدين حديثين فهم يعدُّون المولود “أحدًا ما”. هذه الكلمة متجهمة على مستوى تشخيصي، لكنني أقتبس جملة توضيحية لي”: تستعد الجينات، فتتظافر معها البيئات “(اقتباسٌ لبيتر وجين مدور بتصرِّف: تستعد الجينات، فتتظافر معها الوراثة فوق الجينية)
يقرُّ تريفور تورنر أيضًا – استشاري نفسي متقاعد من شرق لندن ونائب رئيس الكلية الملكية للأطباء النفسيين سالفًا- بالتشخيص، وبما أنه يزاول الطب النفسي في المستشفى وعادة ما يرى مرضى وصلوا لأقصى مراحل الاكتئاب، وبحكم انخراطه في حياة عملية فيها أنواع كثيرة من الأمراض العقلية البالغة والطارئة التي تتطلب تدخلًا عاجلًا، وتُجهِد مصادر دائرة الصحة الوطنية المحدودة، فهو يرى بأن العالم التشخيصي للدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية والجمعية الأميركية للأطباء النفسيين الداعمة له، بعيدٌ كل البعد عما يخوضه من تجارب في دائرة الصحة الوطنية باستمرار. “تجدي الاضطرابات المتعلقة بالمزاج التي كشف عنها الدليل مثل دوروية المزاج واضطراب سوء المزاج نفعا لأطباء القطاع الخاص في المملكة، فهو يضيف لهم اضطراباتٍ أخرى لتشخيصها وعلاجها وتلقي ثمنًا لقاء ذلك”.
لا ينفي تورنر وجود البؤس المزمن، لكنه يميل إلى تعريف أحدث. ثمة أشخاص لا يشعرون بأنهم بخير على نحو مزمن؛ إنهم متعبون ومكتئبون، ويطيلون التفكير والتذمر، كل ما في الأمر أن أحوالهم لا تجري على النحو الذي يحبون أو كما يجب حسب اعتقادهم، ويشعرون بأنه لا ينبغي لهم الوجود في هذا العالم، ومثل هؤلاء يؤثرون تأثيرًا سلبيًّا على الآخرين، ومن الصعب معاشرتهم، وهم لا يضيفون قيمة إلى حيوات الآخرين، مما يضاعف شعورهم بالعزلة. ومع أن تورنر يجزم بأن لنا جميعًا -إلى حد ما- “صمامٌ عاطفي” مُحكَمٌ منذ الولادة، إلا أنه يظن بأن الحاجة لتنقيح تشخيص الاكتئاب تنبع بشكل كبير من المطالبة والافتراض العصريين نسبيًّا بأنه يتوجب علينا أن نكون سعداء، لدرجة أننا أصبحنا نشعر بأننا مرضى إن لم نستطع الشعور “بالسعادة”، وإن ظن أهلك وأصدقاؤك بأنك لست سعيدًا على نحو كافٍ، أو غير قادر على جعلهم سعداء كفاية، فإن الأمر يستدعي زيارة الطبيب.
وبالرغم من أن تورنر – بعدِّهِ طبيبًا نفسيًّا مزاولًا للمهنة – قد استنفد كل العلاجات النفسية التي بيده لعلاج مَن اشتدَّ بهم الحال من المرضى، إلا أنه يذكرني بمفهوم فرويد حول “التعاسة البشرية الطبيعية”، لكونها لا تندرج تحت الأمراض في تلك الأيام على الأقل. ليس الأمر أن ثمة ما هو غير خاطئ، بل ربما لا يكون التشخيص العلاجي ولا الأطباء ترياقًا لأرواحنا المضطربة.

وجدتُ نفسي أفكر باطِّراد في نظام الأخلاط القديم الذي يشمل: المادة السوداء والمادة الصفراء والبلغم والدم، كما يعبِّر عنه أبقراط، ويتوسعُ فيه غالن. ثمَّ، وكما هو الحال الآن، من المفترض أن يكون ثمة توازن تام للكيمياء الفيزيائية – والذي لن يتحقق إطلاقًا على الأغلب – وهو ما يوجِّهُ الأخلاط الأربعة في حال حدوث نقص فيها أو فائض. تتدفق هذه “العصائر” في أجسادنا جميعًا ولكن بنسب متباينة، وهي المسؤولة عن شخصيات الأفراد وأمزجتهم، وما إنْ تتعطل حتى تجر علينا جُلَّ أمراضنا الجسدية والنفسية.
ثمة مناظرة لا تزال محتدمة حول عمل أهم الناقلات العصبية وأشهرها: السيروتونين والدوبامين والنورادرينالين، المتعلق بأمزجتنا وصحتنا النفسية، لربما نحن نتحدث عن الأخلاط الأربعة أيضًا. ظلت هذه الفكرة الآسرة حول التوازن الكيميائي ترافقنا منذ آلاف السنين، حتى وإن شعرنا بأن العلم “الراهن” يدعم حديثنا الآن، إلا أنها افتراض مثير للسخرية للطب الحديث المبكر. إنها لافتة للنظر ومعقولة، وفكرة قابلية قياس شيء ما وإمكانية ضبطه بإعادة امتصاص المثبطات أو المعززات أمرٌ مُغْرٍ أكثر بكثير من الاعتقاد بأن ثمة مكان ملائم في العالم للمشاعر السلبية والنظرة السوداوية.
ومع كل الثقة التي ناقش بها هيلدغارد بنجن توازن الأخلاط الأربعة إبان القرن الثاني عشر، تقتبس مجلة دايلي ميل في عام 2013 عن الدكتور كوزمو هالستروم بالكلية الملكية للأطباء النفسيين والأستاذ كريج جاكسون بجامعة برمنغهام سيتي، ما مفاده بأنك قد لا تكون سيء مزاج ومتشائمًا وغير اجتماعي فقط، بل ربما يكون لديك اضطراب بالفعل!
يقول الأستاذ جاكسون:
“إن اضطراب الاكتئاب المستمر مرتبط بنقص السيروتونين – مادة كيميائية في الدماغ تتحكم بالمزاج … وقد خلصت دراسات حصرية إلى إمكانية حدوث خلل في توازن الدوبامين – مادة كيميائية أخرى في الدماغ. إننا بحاجة لمستوى معين من المواد الكيميائية التي يفرزها الدماغ مثل الدوبامين والسيروتونين ليعمل بشكل صحيح، ومَن تفرز أدمغتهم أقل من تلك النسبة أو في بعض الحالات أكثر منها، سيحدث اضطراب في هذا التوازن الحساس لديهم – وبالتالي قد يعانون من أعراض اضطراب الاكتئاب المستمر”.
وعلى الرغم من ذلك، بينما تبدو كل معايير تشخيص اضطراب سوء المزاج أو الاكتئاب المستمر منطبقة عليَّ تمامًا، ثمة صوت قوي في الجزء الخلفي من دماغي يسعى لأمر آخر غير التسمية التشخيصية فيما يخص فهمي لـ “لطالما كنتُ هكذا على الدوام”. يرفض كثير من الناس – لاسيما الشباب منهم – العلاج بحجة خوفهم من أن يمنعهم من أن يكونوا أنفسهم، كما هم. ويجيبهم الأطباء والأصدقاء والأهل (والآن دايلي ميل) بأنهم ليسوا بخير؛ لأنه لا ينبغي عليهم رؤية العالم ووجودهم على هذه الشاكلة.
رفضتُ لوقت طويل تناول مضادات الاكتئاب، على الرغم من أنني عالجتُ نفسي بالباربيتورات حين كنت في أوائل عشريناتي، لأحقق ما صَبوتُ إليه بشدة آنذاك: اللاوعي – فترة نقاهة من مشاعري التي لا تُطاق. لم أكن أحتمل الـ”أنا” التي لطالما هممتُ بالحفاظ عليها؛ لم أستطع البقاء بدون مخزون من المنومات القوية حولي، بيد أني كنت مقتنعة بأن علي تخدير ما لا يُطاق على نحوٍ يومي، لا تغييره إلى الأبد، ارتبط الأمر في ذهني بالحفاظ على حدِّ الحقيقة مع نفسي؛ ليوجَدَ دائما، وليخبرني بما يكون عليه الحال بالفعل. ما شعرتُ بإلحاحه أكثر ما يكون – أثناء سلسة الاكتئابات – كما هو الحال أثناء مزاجي المنخفض عمومًا – هو وجوب مجابهة الواقع وجها لوجه، وأن أولئك الذين ناضلوا أنفسَهم بما فيه الكفاية والعالم أيضا، يرون الواقع عبر نظارة مشوهة ومريحة؛ تفصلهم عن الشر والرعب.
منحتُ نفسي فترات راحة بتناول الباربيتورات، ولكنني عشت أغلب أوقاتي وذلك الستار مرفوع، دون حجابٍ يُبقي غربة العالم الفظيعة، واللاجدوى المتأصلة فيَّ، والكون الفظَّ بعيدًا عني، ورأيتُ بدقة فاجعة (أستخدم هذه المفردة بإمعان) النحو الذي تعرِّج عليه الأمور. لم يساورني أي شك حيال ذلك وقتئذٍ، ولا الآن في الواقع، وحتى عندما كان ذلك الستار مسدلًا، يدلُّني شيء ما في تكويني أن أدرك، كما أدركتُ لاحقًا، بأنَّ ثمة واقع لا يُحتَمَل مستتر خلفه، وفراغٌ كئيب ولا إنساني، وبأن هذه الحقيقة هي منبع شبكة القصص الواهنة التي نسردها لأنفسنا عنَّا وعن العالم.
أبذل قصارى جهدي مُحدِّثةً نفسي بأن تقبل الـ”لا جدوى” متمخِّضٌ عن نضج ببساطة. يجب أن يدرك الناس الصادقون الذين لم ينجوا بالدين هذا بعد إمعان التفكير، لكنني في الحقيقة وجدت تقبله غير مُحتَمَلٍ؛ إذْ لم أصل أبدًا لنقطة أستطيع معها التعايش مع فكرة انعدام الجدوى، ولم أشعر في الواقع بأن المجتمع البشري أو ترابطه يرتقانِ ذلك، وهذا عدم نضج كبير مني- هشاشة – وهو ما جعلني مكتئبة باستمرار، ومنحني على ما أظن حافزًا خفيًا للكتابة. الإفصاح عن الحقيقة -التي بدت لي دائما قاتمة ومرة – مهمٌ وأساسي وملموسٌ ومفروضٌ على نحو حتمي في حياتي، لا أُحب أبدًا التباهي بحالي، بيد أنني ظللت أتحدث عنه دومًا، لا أنتوي ذلك عادة، بل هي ضرورة تصاحب وجودي؛ أيْ الجوهر النظري لاكتئابي، أو تقلباتي المزاجية إبان طفولتي. وكان ذلك تعبيرًا ظاهريًا عن كآبتي.
لا أحب قطعًا فكرة أن تكون للكتابة (أو الإبداع؛ المفردة التي أرى بأنها ساذجة ومُحرِجَة) وظيفة علاجية. لا أستطيع إطلاقًا تذكُّر أنني شعرتُ بتحسن بعد كتابة شيء ما، باستثناء الرضا الناجم عن الإنجاز. ومع ذلك، يا له من بخت رائع وعظيم أنْ كان بإمكاني أن أُصبِحَ كاتبة. لقد أنقذ ذلك حياتي حرفيًا؛ فقد منحتني الكتابة طريقة لتزجيةِ وقتي على كل حال، مما جعلني أنخرط بطريقة مُحكَمة مع ما لا أستطيع تفاديه مع نفسي مثل الحزن والغضب اللذين أشعر بهما تجاه نفسي، والطريقة التي يتفاعل بها العالم معي أحيانًا لاسيما أولئك الذين حالفهم الحظ ليتخذوا من الكتابة أو صناعة الفن سَبيلًا للعيش.
يرسم مارتن روسُن الكاريكاتيرات الناقمة على السلطة للگارديان. تحدثت إليه عن تجربة العيش بوجود تأثير يُنتِج عملًا مماثلًا. أشار هو الآخر إلى تشخيص اضطراب الاكتئاب المستمر مثلما فعل تريڤور تورنر: “تفسد مجموعات الاهتمامات الخاصة كل ما بوسعها”. يقول إن أعماله قائمة على السخرية، وهي متعلقة بالتعاسة. إن السعادة هي “كذبة الليبرالية الحديثة الكبرى؛ أن نزعم إمكانية حصولنا على كل ما نريد متى ما أردنا ذلك دومًا، وبأننا لن نغدو سعداء ما دمنا فاشلين اجتماعيًّا، وهذا كله مجرد هراء”. السعادة والرضا هما مجرد سكون يسمح لكل الأخطاء السياسية والاقتصادية بالاستمرار. وظيفة روسُن هي أن يهزأ بالسلطة.
“يصدر الأطفال أصواتًا وهم ينفثون الهواء من فمهم لتلقي ردات فعل ممن حولهم، وهذه أول الأصوات المزعجة التي تصدر عن الرُّضَعْ. يجب أن نضحك على ما لا نطيق.”
“تجري الأمور على نحو فظيع، وأنا أصوِّر فظاعتها” إلا أنه سخَّر إحساسه باليأس وإحساس قرائه، للتهكم على الأغنياء وذوي النفوذ. “وظيفتي هي أن أعَكِّر صفوهم بجعلهم أضحوكة بين الناس”.
إنه يصبُّ جام سخطه على العالم على الأوراق يوميًّا، إلا أنه يفعل ذلك في وسطٍ يرضيه. يشعر روسُن بأن الرسم لأربع ساعات يوميًّا بالألوان المائية هو بحد ذاته نشاطٌ مُعالِجٌ ومُهدئ. ويرى نفسه ودودًا ودَمِثًا، وغير نَكِدٍ بتاتًا. لا يمكنني أن أرى الكتابة على هذا النحو، ولا يمكن أن أوصَفَ قطعًا بأنني ودودة، بيد أنني عقب الحديث معه، شعرتُ بالألفة وهذا ما أحسه غالبًا تجاه الأفراد الذين يحسب الآخرون بأن نظرتهم عن العالم قاتمة أو سلبية.
الضحك هو ما يَصِلُني بالآخرين، وبه أعرف مَن بإمكاني الوصول إليهم. لستُ متأكدة إن كان ثمة دراسة حول علاقة الفكاهة بالكآبة في الطب النفسي الأكاديمي؛ لكنْ بالقراءةِ لصموئيل بيكيت، وتوماس برنهارد، وبإلقاء نظرة على أعمال مارتن روسُن أو ستيڤ بيل، وبالاستماع لنكات المجتمعات المضطهدة أو المظلومة، من الجليِّ أن الفكاهة عامل مهم للنجاة من الكآبة الحادة. قد يكون اكتئابنا مستديمًا ومزاجنا منخفضًا، لربما بدأنا حياتنا بالنهوض من الجهة الخاطئة من السرير، ثم تعذر علينا رؤية الجانب المشرق منها، قد نرفض السعادة بعدِّهَا تدليسًا للواقع، لكن يا للغرابة! كيف نضحك نحن التعساء حالما نتشارك نظرتنا السوداوية عن العالم!
بقلم: جيني ديكسي | ترجمة: آلاء الراشدية | تدقيق: عهود المخينية ومريم الريامية | المصدر