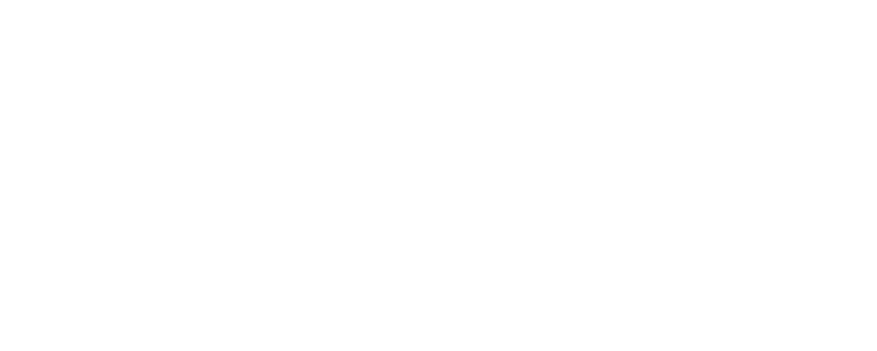التوتر وكيف تؤثر عواطفنا في صحتنا الجسدية
كيف تؤثر ذاكرتك في جهازك المناعيِّ؟ ولماذا تُعدُّ الحركة إحدى أكثر نشاطات الحياة إجهادًا؟ وكيف يجب أن يتصرف والداك حيال قابليتك للإصابة باضطراب ما بعد الصدمة؟

لقد نعمتُ بثلاثين عامًا هنيئًا قبل أن أقاسي أول حالة تسمم غذائي – بدت الاحتمالات جيدة من منظور عام، لكنها سيئة بشكل ذريع عند واجهة الأمر مباشرةً. أصبحتُ غير قادرٍ على نصب ركائز حياتي اليومية على الإطلاق – مشوشًا ذهنيًا تمامًا حتى أنني لا أستطيع القراءة أو الكتابة، واهنًا جسديًا غير قادرٍ على ممارسة التمارين أو التأمل. سرعان ما انتقل العجز المؤقت الذي غزا عقلي وجسدي إلى مستوى جديد من الألم: تجربة إجهاد قاسية. حتى عندما عزّيت نفسي بوصف بانكوڤ الاستثنائي البليغ للتسمم الغذائي لم أستطع التخلص من الشعور الحاد بالضيق الذي أصابني، قد غيَّر المرض الجسدي بطريقة ما واقعي النفسي والعاطفي تمامًا.
ليست هذه التجربة بالأمر النادر طبعًا. ظهر فهم حدسيٌّ لهذا الحوار بين الجسد والمشاعر وساد في لغتنا ذاتها قبل بدء العلماء بتسليط الضوء على كيفية تأثير عقولنا وأجسادنا على بعضها البعض بفترة طويلة: نحن نستخدم عبارة “الشعور بالمرض” على أنه مصطلح بسيط للتعبير عن الأعراض الحسية – الحمى والتعب والغثيان – والضيق النفسي الناتج عن مشاعر كالحزن والوهن.
في الحقيقة، توصَّل الطب ما قبل الحديث إلى العلاقة بين المرض والعاطفة منذ آلاف السنين. استعان جميع أطباء الأيورڤيدا؛ (الطب الهندي القديم) والأطباء اليونانيين والرومانيين القدامى نظرية الأخلاط الأربعة – الدم والعصارة الصفراوية والعصارة السوداء والبلغم – في ممارساتهم العلاجية، إيمانًا منهم بأن الاختلالات في الإفرازات الأربعة المرئية من الجسم تسبب المرض وأن هذه الاختلالات نفسها تسببها المشاعر. ما تزال هذه الاعتقادات باقية في لغتنا الحالية – لفظة الحزن تنحدر من الكلمات اللاتينية لـ “ـأسود” (melan) و “مرارة” (choler). نعد الإنسان الحزين مكتئبًا أو متوترًا، بينما الشخص الهادئ واهنًا ولا يحمل أي مشاعر لأن البلغم يجعل الإنسان خاملًا.

ظهر بعد ذلك الفيلسوف وعالم الرياضيات الفرنسي رينيه ديكارت في القرن السابع عشر وأخذ على عاتقه القضاء على الخرافات التي دعمت الحروب الدينية من خلال غرس بذور العقلانية. لكن المعتقدات التي أرست أساس العلم الحديث – فكرة أن الحقيقة تأتي فقط مما يمكن التأكد منه بوضوح وإثباته بما لا يدع مجالاً للشك – قطعت العلاقة بين الجسد والعاطفة. إن تلك القوى الغامضة والعابرة والتي تعد الأساس البيولوجي التي بدأت أدوات علم الأعصاب الحديث بفهمها للتو، بدت وكأنها موجودة خارج نطاق ما يمكن دراسته بأدوات العقلانية.
ظلت فكرة أن عواطفنا يمكن أن تؤثر في صحتنا الجسدية من المحظورات العلمية قرابة الثلاثة قرون – بدأ ديكارت بمواجهة نوع واحد من المبادئ حيث ابتكر – عن غير قصد – نوعًا آخر والذي نحن في صدد التخلص منه. في الخمسينيات فقط من القرن الماضي، كان الطبيب وعالم الفسيولوجيا النمساوي الكندي هانز سيلي رائدًا لمفهوم التوتر كما نعرفه الآن، حيث جذب انتباه المجتمع العلمي إلى آثار التوتر في الصحة البدنية ونشر هذا المفهوم في جميع أنحاء العالم. (فهم سيلي – علاوةً على تفانيه العلمي – أيضًا عنصر العلامة التجارية لأي حركة ناجحة وعمل بلا هوادة لتضمين الكلمة نفسها في القواميس حول العالم. ربما تكون اليوم كلمة “توتر” هي الكلمة الأكثر تشابهًا في أكبر عدد من اللغات الرئيسية).
لكن ما من باحث عَمَلَ أكثر من الدكتورة إستر ستِرنبرغ على تسليط الضوء على الخيوط غير المرئية التي تنسج العقل والجسد معًا. قد أحدث عملها الرائد على الربط بين الجهاز العصبي المركزي والجهاز المناعي واستكشاف كيف يمكن للجزيئات المناعية المصنوعة في الدم أن تحفز وظائف المخ التي تؤثر بعمق في مشاعرنا ثورةً في فهمنا للكائن المتكامل الذي نسميه النفس البشرية. تدرس ستِرنبرغ في كتاب (التوازن الداخلي: العلم الذي يربط بين الصحة والعواطف) (المكتبة العامة)) العلاقة التبادلية بين عواطفنا وصحتنا الجسدية بوساطة ذلك الذي يبدو مبهمًا رغم أنه اتضح في تجربة عملية على نحو لافت للنظر بأنه يسمى التوتر.

بالنظر إلى تطورات الطب الحديث في البيولوجيا الخلوية والجزيئية والتي جعلت من الممكن قياس كيفية تأثير نظامنا العصبي والهرمونات لدينا في قابليتنا للإصابة بأمراض متنوعة مثل الاكتئاب والتهاب المفاصل والإيدز ومتلازمة التعب المزمن، تقول ستِرنبرغ:
“من خلال تحليل هؤلاء الوسطاء الكيميائيين، يمكننا البدء في فهم الأسس البيولوجية لكيفية تأثير المشاعر في الأمراض…
تلعب نفس أجزاء الدماغ التي تتحكم في الاستجابة للتوتر … دورًا مهمًا في قابلية الإصابة بالأمراض الالتهابية ومقاومتها مثل التهاب المفاصل، ولأن هذه الأجزاء من الدماغ تلعب أيضًا دورًا في الإصابة بالاكتئاب، يمكننا أن نفهم سبب تعرض العديد من المرضى المصابين بأمراض التهابية أيضًا للاكتئاب في أوقات مختلفة من حياتهم. نكتشف أنه في حين أن المشاعر لا تسبب المرض أو تعالجه مباشرةً، فإن الآليات البيولوجية الكامنة وراءها قد تسبب المرض أو تساهم فيه بدلاً من النظر إلى الجانب النفسي على أنه مصدر مثل هذه الأمراض. وبالتالي فإن العديد من مسارات الأعصاب والجزيئات الكامنة وراء كل من الاستجابات النفسية والأمراض الالتهابية هي نفسها وهو ما يجعل قابلية الإصابة بعدد من الأمراض أحرى أن يتماشى مع قابلية الإصابة بمجموعة أخرى. لذلك يجب إعادة صياغة الأسئلة لمعرفة أي من المكونات المتعددة التي تعمل معًا لتشكيل المشاعر تؤثر أيضًا في الكوكبة الأخرى من الأحداث البيولوجية والاستجابات المناعية التي تتحد للمقاومة أو لإحداث المرض. نحتاج أن نبحث عن الجزيئات والمسارات العصبية التي تبث الأفكار التي تسبب الحزن بدلاً من السؤال عما إذا كانت هذه الأفكار يمكن أن تسبب مرضًا للجسم. ومن ثم علينا أن نسأل ما إن كانت تؤثر في الخلايا والجزيئات التي تسبب المرض.
لقد بدأنا أيضًا في تحديد كيفية وصول الذكريات العاطفية إلى أجزاء الدماغ التي تتحكم في الاستجابة للتوتر الهرموني وكيف يمكن لمثل هذه المشاعر أن تؤثر في نهاية المطاف في عمل الجهاز المناعي وبالتالي تؤثر في أمراض مختلفة مثل التهاب المفاصل والسرطان. لقد بدأنا أيضًا بالتوصل إلى آلية تأثير الإشارات من جهاز المناعة في الدماغ والاستجابات العاطفية والجسدية التي يتحكم فيها: الأساس الجزيئي للشعور بالمرض. وبكل هذا بدأت الحدود بين العقل والجسد تتلاشى.”
في الحقيقة ربما تكون العلاقة بين الذاكرة والعاطفة والتوتر الجانب الأكثر إثارة في عمل ستِرنبرغ حيث تدرس كيف نتعامل مع الدوامة المستمرة للعوامل المؤثرة وما ينتج عنها باستمرار الحياة ونحن محاطون بتيار من المحفزات والأحاسيس:
“نشعر بآلاف الأحاسيس خلال يومنا منها ما قد يثير مشاعر إيجابية مثل السعادة ومنها مشاعر سلبية مثل الحزن أو انعدام المشاعر على الإطلاق: رشة عطر، لمسة خفيفة، ظل عابر، نغمة موسيقية. وهناك الآلاف من الاستجابات الفسيولوجية مثل الخفقان أو التعرق التي يمكن أن تصاحب المشاعر الإيجابية مثل الحب أو المشاعر السلبية مثل الخوف أو يمكن أن تحدث دون أي مسحة عاطفية على الإطلاق. ما يصنع هذه المؤثرات الحسية وعواطف النواتج الفسيولوجية هي الشحنات التي تضاف إليها بطريقة ما في مكان ما في أدمغتنا. تتألف العواطف بمعناها الواسع من كل هذه المكونات. يمكن لكل منها أن يؤدي إلى الدماغ وينتج تجربة عاطفية أو يمكن أن يؤدي شيء ما في الدماغ إلى استجابة عاطفية يبدو أنها تأتي من العدم.

اتضح أن الذاكرة هي أحد العوامل الرئيسية التي تربط العلاقة بين الإحساس والتجربة العاطفية. تصبح ذكرياتنا عن التجربة الماضية مشفرة في محفزات تعمل كمحولات على مسار الاستجابة النفسية والعاطفية وتوجه القطار القادم من التجربة الحالية نحو وجهة عاطفية أو أخرى.
تقول ستِرنبرغ:
“ليس المزاج متجانسًا مثل حساء الكريمة. إنه أشبه بالجبن السويسري المليء بالثقوب. المحفزات محددة للغاية حيث تتعثر فيها آثار الذاكرة المفاجئة؛ نفحة عطر؛ نغمات من لحن؛ صورة خيالية غامضة استقرت في ذكرى حزينة مدفونة بعمق ولكن لم تُمحَ تمامًا. تطفو هذه المدخلات الحسية من اللحظة على فترات زمنية في أجزاء الدماغ التي تتحكم بالذاكرة وهي لا تجذب معها الموجهات الحسية فقط وإنما أيضًا مسارات المشاعر التي ارتبطت أولًا بالذاكرة. تصبح هذه الذكريات مرتبطة بالعواطف والتي تُعالَج في أجزاء أخرى من الدماغ؛ الفص اللوزي للخوف، والنواة المسؤولة عن الإحساس بالمتعة – هذه الأجزاء نفسها أسماها علماء التشريح على أشكالها. وترتبط مراكز الدماغ العاطفية هذه بالأجزاء الحسية من الدماغ والفص الجبهي والحصين عن طريق مسارات عصبية – مراكز تنسيق التفكير والذاكرة.
يمكن أن تؤدي نفس المؤثرات الحسية إلى إثارة عاطفة سلبية أو إيجابية وهو ما يعتمد على الذكريات المرتبطة بها”

هكذا يحدث التوتر – مثلما تشكل الذاكرة السبب الأساسي في تفسيرنا للتجارب المختلفة والاستجابة لها، تحدد مجموعة معقدة من العوامل البيولوجية والنفسية كيفية استجابتنا للتوتر. يمكن لبعض أنواع التوتر أن تكون محفزة ومشجعة وتحثنا على العمل والفاعلية الإبداعية بينما يمكن لِأنواع أخرى أن تكون مستنزفة ومسببة للخمول فتجعلنا محبطين ويائسين. تشير ستِرنبرغ إلى أن هذا التقسيم بين الإجهاد الجيد والسيء يتحدد من خلال البيولوجيا التي تستند إليها مشاعرنا – من خلال جرعة ومدة هرمونات التوتر التي يفرزها الجسم استجابةً للمنبهات المجهدة. تشرح ستِرنبرغ الآلية العصبية الحيوية من جرّاء هذه الاستجابة:
“بمجرد وقوع الحدث المجهد، فإنه يؤدي إلى إطلاق سلسلة من هرمونات ما تحت المهاد والغدة النخامية والغدة الكظرية – وهو استجابة الدماغ للتوتر. كما أنه يحفز الغدد الكظرية على إفراز الأدرينالين والأعصاب الودية لإخراج مادة كيميائية شبيهة بالأدرينالين في جميع أنحاء الجسم: الأعصاب التي تربط القلب والأمعاء والجلد. نتيجة لذلك يخفق القلب خفقانًا أسرع وينتصب الشعر الخفيف في بشرتك وتتعرق وقد تشعر بالغثيان أو الرغبة في التبرز. لكن يُجذب انتباهك وتصبح رؤيتك واضحة تمامًا حيثُ يساعدك تدفق الطاقة على الجري – هذه المواد الكيميائية نفسها التي تُطلق من الأعصاب تجعل الدم يتدفق إلى عضلاتك وهو ما يحضِّرك للجري السريع.
يحدث كل هذا في لحظات. إذا كنت ستقيس هرمونات التوتر في دمك أو لعابك فستُزَاد بالفعل في غضون ثلاث دقائق من الحدث. يؤدي لعب لعبة فيديو سريعة الوتيرة في اختبارات علم النفس التجريبية إلى زيادة الكورتيزول اللعابي وانتشار النوربينفرين إلى الدم الوريدي بمجرد بدء المعركة الافتراضية. ولكن إذا جعلت التوتر يتمكن منك من خلال عدم قدرتك على التحكم فيه أو بجعله يبقى لفترة طويلة، وبجعل الهرمونات والمواد الكيميائية تتدفق من الأعصاب والغدد فإن نفس الجزيئات التي حركتك على المدى القصير ستجعلك تشعر بالوهن الآن.”

تظهر تأثيرات التوتر هذه على منحنى الجرس – أي أن بعضها جيد لكن الكثير منه يصبح سيئًا: مع إفراز الجهاز العصبي للمزيد والمزيد من هرمونات التوتر يرتفع الأداء ولكن إلى حد ما؛ بعد نقطة التحول هذه يبدأ الأداء في التراجع مع استمرار تدفق الهرمونات. ما يجعل التوتر “سيئًا” – أي ما يجعلنا أكثر عرضة للمرض – هو التباين بين سرعة الجهاز العصبي وجهاز المناعة. توضِّح ستِرنبرغ:
“يتفاعل الجهاز العصبي واستجابة التوتر الهرموني مع المحفز خلال أجزاء من الثانية أو ثواني أو دقائق بينما يستغرق الجهاز المناعي بعض ساعات أو أيام. يتطلب الأمر أكثر من دقيقتين حتى تتحرك الخلايا المناعية وتستجيب للأجسام الغريبة، لذلك من غير المحتمل أن يكون لمحفز واحد حتى لو كان قويًا قصير العمر في ترتيب اللحظات تأثيرًا كبيرًا في الاستجابات المناعية. ومع ذلك عندما يتحول التوتر إلى حالة مزمنة تبدأ الدفاعات المناعية بالضعف. مع استمرار تأثير المحفزات المجهدة، تستمر هرمونات التوتر والمواد الكيميائية في الضخ. لا تتاح الفرصة أبدًا للخلايا المناعية التي تطفو في هذا الوسط في الدم أو تمر عبر الطحال أو تنمو في حضانات الغدة الزعترية للتخلص من الاندفاع المستمر للكورتيزول. نصبح أقل قدرة على الدفاع والمواجهة عند التعرض لأجسام جديدة لأن الكورتيزول يوقف استجابات الخلايا المناعية ويضعف بنيتها، ويقلل قدرتها على الاستجابة للمحفزات الخارجية، في ظل وجود التوتر المستمر. لذلك إذا تعرضت على سبيل المثال للإنفلونزا أو فيروس البرد الشائع عندما تكون متوترًا توترًا مزمنًا فإن نظام المناعة لديك يكون أقل قدرة على الاستجابة وتصبح أكثر عرضة لهذه العدوى.”

التعرض المستمر للتوتر وخاصة لمجموعة متنوعة من الضغوطات في نفس الوقت – أي مزيج من القائمة الوجودية الواسعة لأحداث الحياة مثل الانتقال والطلاق والوظيفة المرهقة وفقدان أحد الأحباء وحتى رعاية الأطفال المستمرة – يضيف حالة من الإرهاق الشديد تؤدي إلى ما نسميه الاستنزاف.
تقول ستِرنبرغ:
“أصحاب بعض المهن أكثر عرضة للإرهاق من غيرهم – الممرضات والمعلمون على سبيل المثال من بين أولئك الأكثر عرضة للخطر. يواجه هؤلاء المهنيون يوميًا مواقف تقديم الرعاية في حياتهم العملية غالبًا بأجر غير كافٍ ومساعدة غير كافية في وظائفهم ومع وجود عدد كبير جدًا من المرضى أو الطلاب في مسؤوليتهم. بدأت بعض الدراسات في إظهار أن المرضى المنهكين قد لا يعانون فقط من الإرهاق النفسي ولكن أيضًا الاستنزاف الفسيولوجي: استجابة الكورتيزول الضعيفة وعدم القدرة على الاستجابة لأي ضغط حتى مع اندفاع طفيف من الكورتيزول. بعبارة أخرى، يمكن أن يغير التوتر المزمن المستمر الاستجابة للتوتر نفسه. ويمكنه تغيير أنظمة الهرمونات الأخرى في الجسم أيضًا.”
يؤثر أحد أكثر هذه التغييرات عمقًا في الجهاز التناسلي حيث يمكن أن تؤدي فترات التوتر الطويلة إلى إيقاف إفراز الهرمونات التناسلية لدى كل من الرجال والنساء وهو ما يؤدي إلى انخفاض الخصوبة. لكن الآثار قد تكون عصيبة أكثر حينما يتعلق الأمر بالنساء – تؤدي نوبات الاكتئاب المتكررة والممتدة إلى تغيرات دائمة في بنية العظام مما يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام. بعبارة أخرى، ينعكس التوتر حرفيًا في عظامنا.

لكن التوتر ليس دالة سببية مباشرة للظروف التي نمر بها – ما يضخم أو يخفف من تجربتنا مع التوتر هو مرة أخرى الذاكرة.
تقول ستِرنبرغ:
“إن إدراكنا للتوتر وبالتالي استجابتنا له هو شيء دائم التغير ويعتمد اعتمادًا كبيرًا على الظروف والأوضاع التي نجد أنفسنا فيها. يعتمد ذلك على الخبرة والمعرفة السابقة وكذلك على الحدث الفعلي الذي وقع. وهذا يعتمد على الذاكرة أيضًا.”
أكثر مظاهر خطر آلية تنظيم الذاكرة للتوتر هو اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD). تشير ستِرنبرغ إلى البحث الذي أجرته عالمة النفس ريتشل يهودا التي وجدت أن الناجين من الهولوكوست (محرقة يهود أوروبا) وأقاربهم من الدرجة الأولى – أي الأطفال والأشقاء – أظهروا هرمونات مماثلة لاستجابة التوتر وهو ما يُعد دليلًا صارخًا على كيفية تشفير الذاكرة للتجارب السابقة إلى محفزات والتي تثير بدورها التجربة الحالية بعد ذلك.
وتشير ستِرنبرغ إلى أن هذا يمكن أن يكون مزيجًا من الفطرة والتنشئة – فالناجون بصفتهم آباء صغار ما تزال الصدمة حديثة لهم وربما علَّموا أطفالهم لا شعوريًا أسلوبًا مشتركًا في الاستجابة للتوتر. ولكن من الممكن أيضًا أن تكون هذه الاستجابات التلقائية للتوتر الهرموني قد غيرت تغييرًا دائمًا بيولوجيا الوالدين ونُقلت عبر الحمض النووي إلى أطفالهم. مرة أخرى تشفر الذاكرة التوتر في أجسادنا. تتفكر ستِرنبرغ في الآثار الأوسع نطاقًا:
“ليس من الضروري أن يكون التوتر نتيجة للحرب أو الاغتصاب أو الهولوكوست لإحداث بعض عناصر اضطراب ما بعد الصدمة على الأقل. يمكن للضغوط الشائعة التي نمر بها جميعًا أن تحفز الذاكرة العاطفية لظروف مرهقة – وجميع الاستجابات الفسيولوجية المصاحبة لها. يمكن أن يؤدي التوتر طويل الأمد – مثل الطلاق أو مكان عمل عدائي أو نهاية علاقة أو وفاة أحد الأحباء – إلى تحفيز عناصر اضطراب ما بعد الصدمة.”
من بين الضغوطات الرئيسية – التي تشمل أحداث الحياة المتوقع أن تكون مدرجة في القائمة مثل الطلاق وموت أحد الأحباء – هناك أيضًا حالة غير متوقعة إلى حد ما على الأقل لأولئك الذين لم يمروا بها: الانتقال. توضح ستِرنبرغ القواسم المشتركة بين شيء مهلك مثل الموت وشيء عادي مثل الانتقال:
“أحدهما بالتأكيد هو الخسارة – فقدان شخص ما أو شيء مألوف. آخر هو التجديد – أن يجد المرء نفسه في مكان جديد وغير مألوف بسبب الخسارة. يمكن تغيير هذين معًا: الابتعاد عن شيء يعرفه المرء نحو شيء لا يعرفه.
البيئة غير المألوفة هي مسبب عالميٌّ للتوتر لجميع المخلوقات تقريبًا بغض النظر عن مدى تطورها.”
تواصل ستِرنبرغ في الجزء المتبقي من الكتاب المعرفيِّ “التوازن الداخلي” استكشاف دور العلاقات بين الأشخاص في كل من المساهمة في التوتر وحمايتنا منه وكيف يغير جهاز المناعة مزاجنا وما الذي يمكننا القيام به لتسخير هذه الرؤى العصبية الحيوية في التخفيف من مواجهتنا للضغوطات التي تتأثر بها حياة كل إنسان.
بقلم: ماريا بوبوڤا | ترجمة: جُهينة اليعربي | تدقيق: عهود المخيني | المصدر